الوصف
كلمة التحرير
============
الملخص
قد يكون أمراً يسيراً أن يقرر المرء إصدار دورية تعبر عن أفكار معينة وتخدم أطروحات محددة، في سياق الجهود المشهودة التي تبذلها الأمة في مواجهة التحديات المتكاثفة عليها. وقد يكون يسيراً كذلك أن تصدر فعلاً مثل هذه الدورية، يعززها شعور قوي من لدن القائمين عليها بأن الرسالة التي يتطلعون إلى خدمتها، والأطروحات التي يودون تطويرها وإنضاجها، والمنهجية التي يسعون إلى بلورتها وإرسائها، أصبحت لها قاعدة عريضة في أوساط المفكرين والباحثين وعامة القراء المهتمين. ولكن الأمر ليس قطعا على هذا المستوى من السهولة بالنسبة لمجلة “إسلامية المعرفة”. فإعادة صياغة المعرفة الإنسانية، فلسفة ووجهة ومناهج ومضامين، هي القضية الكبرى التي نذرت لها هذه الإصدارة؛ والانطلاق من الوحي الإلهي، قرآنا وسنة، باعتباره الإطار المرجعي و المصدر التوجيهي لعملية الصياغة تلك هو الحافر على هذه المحاولة.
وما يراد إعادة صياغته بل إعادة تأسيسه في المعرفة الإنسانية ليس فرعا من المعرفة دون غيرة ولا صنفا منها دون سواه، بل إن الأمر يشمل كل مجالات الجهد العقلي للإنسان في سبيل أن يتفهم الوجود الكوني المحيط به من حيث مصدره وغايته، وأن يتبصر ذاته ومقامه ضمن هذا الوجود، وأن يعي دوره ورسالته فيه؛ كما يشمل جهده في أن يطور من المفاهيم والرؤى النظرية والمناهج والأساليب العملية ما يمكنه، منفرداً ومجتمعاً، من التعامل مع ظواهر الكون ومرافقته، أداءً لدوره وخدمة لرسالته وتحقيقاً لأغراضه. ومن ثم فالمعرفة الإنسية المقصودة بالمراجعة وإعادة الصياغة والتأسيس يستوي فيها ما عرف بالعلوم الطبيعية وما وُسم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع إدراك اللازم لما يطرحه كلّ من الجناحين من إشكاليات تسلتزمها طبيعته الخاصة.
وهكذا فالتحدي الذي يتطلع القائمون على مجلة “إسلامية المعرفة” إلى التصدي له يتمثل في ضرورة بلورة وتطوير بديل معرفي إسلامي ينهض على أساس من التحقق المنهجي بالرؤية الكونية التوحيدية والقيم الأساسية والمقاصد العليا التي جاء بها الإسلام من ناحية، وعلى أساس من التمثل الواعي لمعطيات الخبرة العلمية والعملية للإنسانية في عمومها وشمولها. وبالتالي، فإن هذا البديل لا يراد له أن يعالج فقط الإشكاليات المعرفية الخاصة بمجتمعات المسلمين وثقافتهم، بقدر ما يراد له أن يتركز على الإشكاليات المعرفية التي تقع في …
بحوث ودراسات
================
الملخص
هو البحث الأول في المجلة، لذا يشرح فيه رئيس التحرير ندرة المجلات التي تتناول فكرة (إسلامية المعرفة) التي أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية تمثل تياراً معرفياً ومنهجاً إسلامياً متميزاً، وأصبحت تناقش بوصفها قضية هامة من قضايا الفكر والمعرفة والمنهج. يبدأ البحث بشرح أهم منطلقات التغيير في العالم الإسلامي. ثم يتطرق إلى الهدف من إصدار هذه المجلة مستشهداً بمقالات الأفغاني حين أصدر (مجلة المنار). ويعرض البحث تطور مفهوم (إسلامية المعرفة) عبر السنين الماضية. ثم يسأل الباحث ماذا فعل المشروع الحضاري الإسلامي في إحياء الأمة خلال القرن الماضي؟ ويختم بحثه بعرض الدعائم الستة للمنهجية المعرفية الإسلامية.
الملخص
تعود عملية استبعاد الوحي الإلهي بوصفه مصدراً من مصادر المعرفة إلى ظروف تاريخية خاصة بحركة التطور الفكري للمجتمع الغربي، والصراع الداخلي بين الفكرين الديني والعلمي، وهو صراع لا مثيل له في تاريخ الفكر الإسلامي، لذا تناول البحث وسائل تحديد المعالم المنهجية والعلمية التي تنظر إلى الوحي على أنه أصل معرفي رئيس، وكذلك توظيف إجراءات الاستدلال النصي والفعلي بوصفه أداة في التنظير الاجتماعي، والمقدمات العلوية للمعرفة الحسية. ثم يتطرق إلى عقلانية الوحي، وكذلك التماثل المنهجي بين المعرفتين العلوية والحسية. ويتناول الباحث قضية الوحي وصلته بالعلوم الاجتماعية. ثم مصادر المعرفة وقواعد الاستدلال النصي، والمصدر التاريخي وقواعد الاستدلال الفعلي، ثم التطابق المنهجي بين الاستدلال النصي والتاريخي.
——————–
الملخص
إن العقيدة الإسلامية هي أساس الدين، والمحرك الأصلي للهوية الإسلامية، والقوة الدافعة لحركة التحضر والعمران. والبحث يعالج كيفية الإصلاح العقدي للأمة حتى تقوم بعمليات التحمل والدفع، والنهوض الحضاري. ثم يتناول مفهوم ترشيد الفهم العقدي وما يتضمنه من مصادر للفهم، ومدلول ومفردات العقيدة. وينتقل إلى التأطير العقدي الشامل والتأطير العقدي للفكر، وللعمل، ثم إلى التفعيل الإرادي للاعتقاد، والترشيد في الجزم الاعتقادي، والإحياء الروحي في الاعتقاد، ثم عملية الرشاد الاعتقادي في التحضر، والتفعيل الإرادي للاعتقاد حتى تعود الأمة إلى الرشاد الاعتقادي الذي يدفعها نحو التعمير والتنمية والتحضر.
خالد بلانكنشب
الملخص
يحتاج المؤرخ إلى التجرد والتحرر من تأثير جذوره ومحيطه عند كتابته للتاريخ، لذا يظهر التحيز عند مؤرخي الغرب حين يصنفون العالم من منطلق المركزية الأوربية. ومن هنا يبدأ الباحث بتحديد وسائل المنهج الغربي في تحديد العصور التاريخية، فيتناول: التاريخ القديم وأوروبا القروسطية، والتاريخ الحديث محللاً المحاولات الإصلاحية للمنهج التاريخي الغربي الضيق، وعارضاً نماذج توضيحية لها. ثم ينتقل إلى علم التاريخ عند المسلمين، ويتناول الرؤية التاريخية الإسلامية العالمية، ويعرض مقترحاً لتقسيم عصور التاريخ تقسيماً منسجماً مع الواقع التاريخي.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
الملخص
في مقال له بعنوان “الإسلام والعلوم الاجتماعية: تساؤلات حول أسلمة المعرفة”، تساءل برهان غليون عن مصداقية الدعوة إلى أسلمة المعرفة قائلاً: إلى أي مدى يعكس الانتشار المتزايد لهذا الشعار ميلاد حركة تجديدية فعلية في مناطق العلوم الاجتماعية الحديثة، ويشكل مصدراً لنمو مناهج علمية أصيلة وطريفة في المجتمعات الإسلامية والعالمثالثية؟ وإلى أي مدى لا يعبر تنامي اللجوء إلى هذا الشعار عن نشوء آلية تعويضيه، يحاول المجتمع بواسطتها التغلب على مشاعر الخوف من انعدام الآفاق ومن القطعية التاريخية والانحدار نحو الهامشية الناجمة عن الإخفاق في استيعاب هذا العلم والتحكم به؟ وإلى أي حد لا يعبر رفض هذا العلم عن اليأس من اكتسابه، كما يغطي الحديث عن أسلمته الفشل في السيطرة على الطاقة الجبارة التي يمثلها، وإظهار هذا الفشل كما لو كان اختياراً واعياً ينبع من التمسك بالذاتية والإخلاص لمتطلبات حماية الهوية الوطنية أكثر من التعبير عن الخيبة”؟
من المنطقي جداً أن يتساءل غليون كل هذه التساؤلات حول إسلامية المعرفة باعتباره قد انطلق من مسلمة تقول بأن ولادة شعار أسلمة أو إسلامية العلوم كان إفرازا طبيعيا لحالة التهميش التي يعيشها المسلمون وانهيار الآمال والأحلام الكبيرة وإخفاق مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمي، ولكن ليس من المنطقي ولا من حق غليون، وهو الحريص على الموضوعية والعلمية، أن يحوّل هذه التساؤلات إلى أحكام نهائية في خاتمة المقال المذكور، خاصة وأنه قد سلّم في ثنايا المقال بأنه “كان من الممكن للدراسة العلمية للأدبيات الصادرة عن المراكز العلمية التي جعلت من هذا الموضوع هاجسها وغرضها الأول أن تشكل مدخلا هاما لفهم المقصود من أسلمة العلوم وتحليل المعاني المختلفة التي تتجسد فيها التجربة البحثية ذاتها ولكن لسوء الحظ، لمم يتسنى لي أن أطلع على أغلبها. أما النماذج التي وقعت بين يدي حول مشكلة التأسيس الإسلامي للمعرفة العلمية فلا تسمح لي باستنتاجات منظمة ومنهجية حول هذا النشاط العلمي الجديد”. وعلى الرغم من هذا النقص لا يمكّن صاحبه من فهم هذا المشروع فضلاً عن إصدار أحكام نهائية علية فإننا لا نريد أن نحمّل المسؤولية الكاملة …
——————–
الملخص
هذا سفر بالغ الجدة والطرافة، عميق في مغزاه جديد في منهجه. بهذه العبارات، وربما بأكثر منها، يمكننا أن نقدم هذه الدراسة القيمة لعبد المجيد الصغير، فنقول: إن قراءة تاريخ علم أصول الفقه بهذه الصورة الشاملة -التي لم تجرد نشأة ذلك لعلم وتطوره من الظروف السياسية التي أدت إلى إنتاجه والتي أبرزت العلاقة الجدلية المتبادلة بين ذلك العلم وتلك الظروف السياسية- إضافة جديدة لتاريخ نشأة هذا العلم وتطوره، غفل عنها ابن خلدون كما بين ذلك عبد المجيد الصغير بكثير من الأدلة وبالتفاصيل التي لا غنى من الرجوع إليها في كتابه.
إن بيان أهمية الجانب السياسي في علم أصول الفقه هو أمر مهم له قيمته العلمية في فهم حركة العلم في السياق العربي الإسلامي بصورة هي أقرب وأدق من تلك الصورة التي تزدحم بها كتب الطبقات والسير لأعلام علم أصول الفقه التي تركز كثيراً على التجريد، وتعرض القضايا وكأنما كتبت في فراغ سياسي وكأنما أولئك الأصوليون كانوا منعزلين عن قضايا السلطة والشرعية والطاعة والحراك الاجتماعي والسياسي الذي كان يمور به الاجتماع البشري في عصرهم، وبسبب الذهول عن تلمس الجانب السياسي في مدونات الأصوليين على أساس أنها لا تمت للسياسة بنسب وأنها علم خالص أريد به تقعيد القواعد، ونصب الموازين التي تحكم عمل الفقيه وتضبطه، فإن أي حديث عن مغزى سياسي أو إرادة فكرية لترتيب القوى ونظم اكتساب الشرعية وفقدانها أو إظهار العلاقة الجدلية بين سلطة العلم وسلطة السياسة أو محاولة إبراز الدوافع السياسية وراء المقولات الأصولية، أو المغزى السياسي للمشروع الأصولي الذي يعني (بالبيان) كما هو الحال عند الشافعي أو الذي يعني (بالبرهان) كما هو عند الإمام الشاطبي ثم توضيح الصلات والآليات السياسية التي حركت المشرعين وجعلت أمر التعبير عن سلطة العلم والمعاني السياسية التي يعبر عنها تتخذ أشكالاً تلائم التحديات التاريخية وتسعى إلى بيان مرونة فقه تنـزيل النصوص على مستجدات الوقائع، والذي هو في مجمله وعي سياسي تشكل في نص علمي، أي أن حركة العلم في السياق الإسلامي لا تنفصل عن السياسة. نقول إن إثبات هذه الدعوى يبدو ميسوراً في فروع العلوم الإسلامية الأخرى، ولكنه بلا شك صعب المنال في مجال علم أصول الفقه بسبب استحكام العادة فيه …
الملخص
ظهر كتاب “مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة” في المكتبات العربية منذ 1980. ولعله حظي بنشر أكثر من مراجعة وتقويم لأفكاره في المجلات العربية. ومع ذلك يبقى محتوى الكتاب مرشحاً لمراجعات جديدة في الأمد القريب على الأقل. فمن جهة، إن مقولة الكتاب الأساسية لها علاقة وثيقة بموضوعات الساعة في ميادين البحث العلمي. فالبحوث في طبيعة العقل ونشاطاته والغوص في آليات الذكاءين الإنساني والاصطناعي وتتصدر اليوم أحدث قائمة البحوث التي يقوم بها العلماء المختصون في المجتمعات المتقدمة. هل للحاسوب Computer أو الإنسان الآلي Robot عقل مفكر مثل الإنسان؟ هل سوف يبقى عقل بني البشر متفوقاً على برمجة الآلات الحديثة ذات الذكاء الاصطناعي في ميادين استعمال الرموز الثقافية مثل اللغة والعلم والفكر والقيم والمعايير الثقافية…؟ هذه التساؤلات ما هي إلا نزر جد قليل من الأسئلة المشاهدة التي تطرحها علوم الدماغ/العقل وبحوث الذكاءين الإنساني والاصطناعي. هناك إجماع اليوم بين الباحثين على أن الذكاء الاصطناعي يتصف بالبدائية والبساطة وذلك مقارنة بالذكاء الإنساني الذي يتميز بمستوى رفيع ومعقد من القدرة الذكائية.
ومن جهة أخرى فالكاتب يعرض رؤية مختلفة عما هو متعارف عليه اليوم في البحوث حول ظاهرتي التفكير والذكاء. فبينما يرجع العلم الحديث هاتين الظاهرتين إلى بنية المخ/العقل، يرى القرآن أن عمليات الذكاء والتفكير والعقلانية هي حصيلة التفاعل وتعاون بين العقل والقلب.
إنّ الخلاصات التي توّصل إليها مؤلف هذا الكتاب حول العلاقة بين القلب والعقل ذات أهمية خاصة بالنسبة للعلماء المسلمين وغير المسلمين المعاصرين على حد سواء. فمن ناحية يرى الجوزو أن لفظة القلب ليست مرادفة تماما لمفردة العقل كما ذهب إلى ذلك الفقهاء والعلماء المسلمون الأوائل. ففي نظره، لو كان الأمر كذلك لكان العكس أيضاً صحيحا، أي أن العقل هو القلب. ومن هذه الرؤية يصبح العقل مصدرا للمشاعر والأحاسيس والعواطف البشرية. إن في مثل هذا الاعتقاد كثيرا من الخلط في نظر الكاتب؛ فالقرآن والسنة يؤكدان أن هناك تشابها بين العقل والقلب على مستوى ما يمكن أن نسميه بجبهة التفكير. إذ أن القلب يشارك العقل في عمليات التفكير. وفضلاً عن ذلك تظل المشاعر والعواطف من سمات القلب المميزة …
——————–
الملخص
يسعى الكتاب إلى تقديم تصور أولي حول معالم المنهج الإسلامي في كل جوانبه وجميع أبعاده المعرفية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وينطلق الكتاب من الإحساس المكثف بوجود أزمة حادة يعاني منها الفكر الإسلامي وتجعله عاجزا عن القيام بدوره الحضاري والريادي المطلوب. ويوضح أن الإحساس بهذه الأزمة ليس وليد الساعة وإنما له جذوره التاريخية، حيث قامت العديد من الحركات الإصلاحية والتجديدية وكذلك المفكرين والمجتهدين الأفذاذ بمحاولات متتالية للخلاص من علل الأزمة وتباعاتها.
ويؤكد الكتاب على ضرورة ووجوب قيام مفكري الأمة المعاصرين بصياغة النموذج المعرفي والحضاري الإسلامي بديلاً للنموذج المعرفي والحضاري الغربي الوافد والمهيمن على القطاع الأكبر المؤثر من واقعنا وفكرنا من جهة، ولعقلية التقليد والسكون والتخلف التي تشل قدرات الأمة وتفقدها القدرة على الإبداع والنهوض من جهة أخرى. حيث أن بلورة نظام الإسلام ومنهجيته بديلاً حضارياً ووضوح معالمه دليلاً عمليا هما السبيل إلى تحقيق وحدة الأمة الفكرية وتجنيبها إخفاق وأزمات جديدة.
كما يوضح الكتاب أن المنهج المطروح لا يمثل المنهج البديل أو الذي يغني عن المناهج الجزئية والمتخصصة في علوم الإسلام وحضارته، وإنما هو منهج الفكر الإسلامي الكافل (إسلامية الحياة)، والذي لا غنى عنه في صياغة مناهج هذه العلوم وبلورتها. إلا أن هذا المنهج يتمتع بصفة التميز، حيث يمنح الإنسان المسلم المكونات التي تميزه عن غيره: عقيدة توحيدية متميزة، وشريعة إلهية خاصة، أثمرتا حضارة متميزة هي حضارة الإسلام.
ويركز الكتاب لأسباب عديدة في خلافة الخلفية الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوصفها حقبة تاريخية وبيئة يستخلص منها المعالم التطبيقية هذا المنهج …

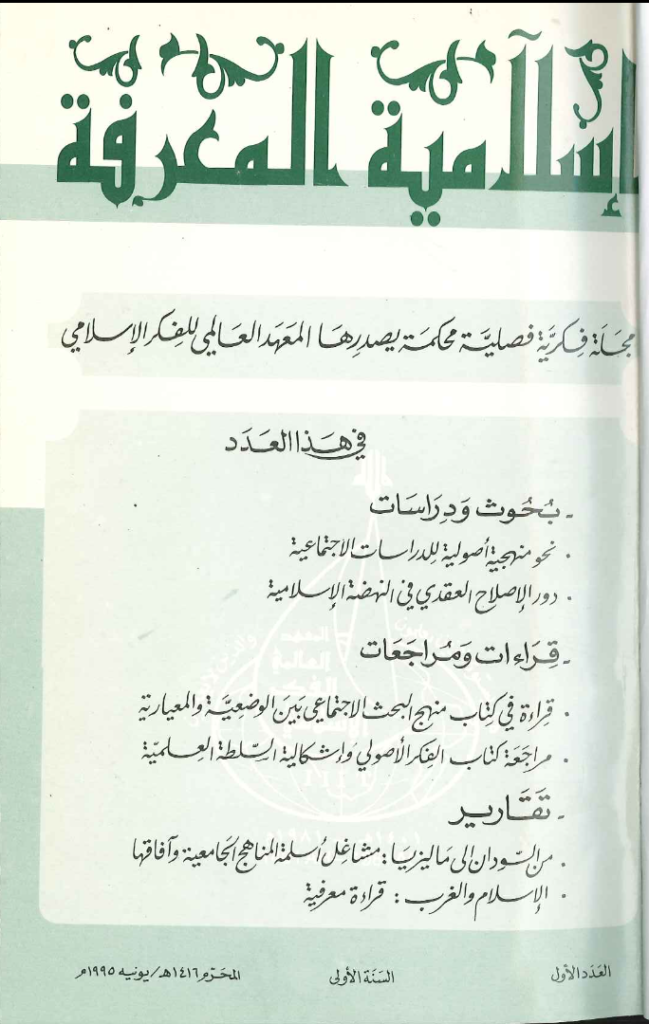
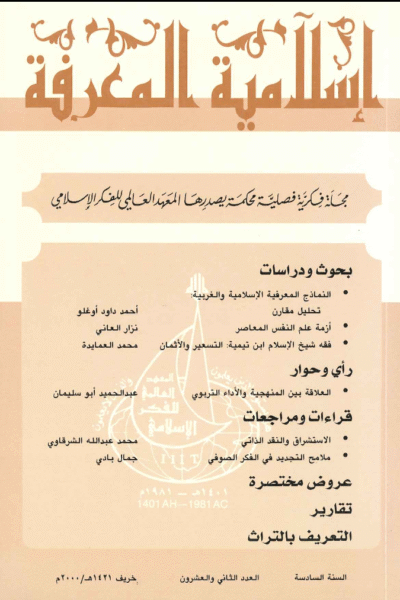
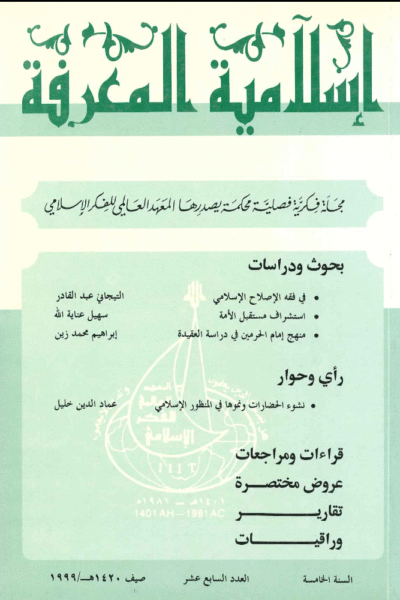
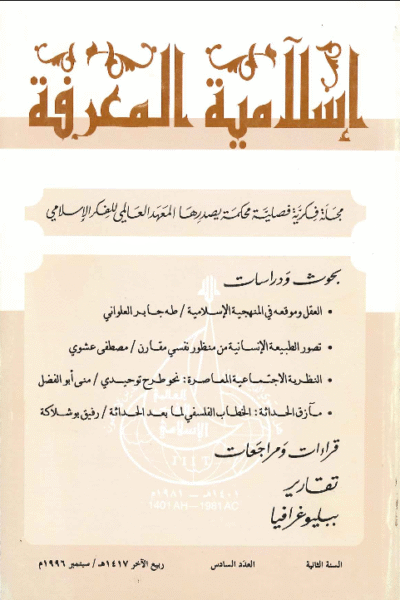
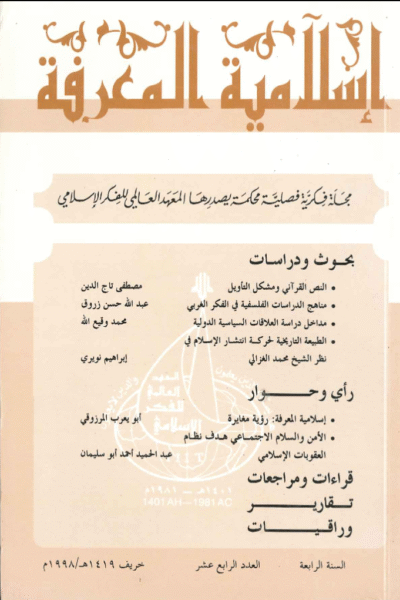
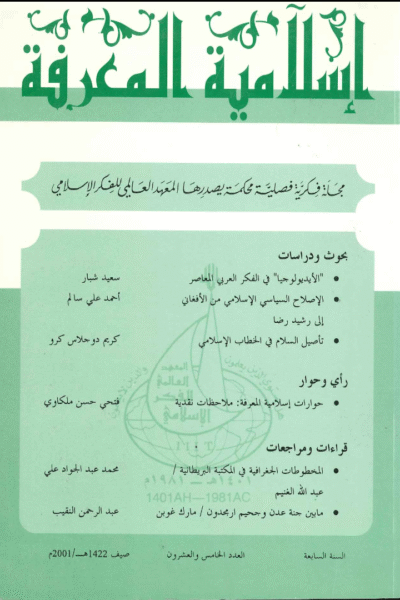
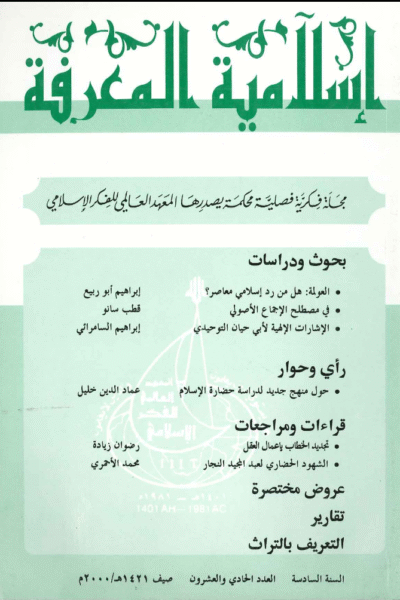
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.