الوصف
الأفكار الأساسية للكتاب:
- القرآن والعلم:
- دعوة القرآن إلى التعلم والتفكر في الكون (مثل آية: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾).
- التأكيد على أن العلم فريضة إسلامية، وربطه بالإيمان (مثل آية: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾).
- المنهج القرآني:
- الجمع بين “القراءتين”: قراءة القرآن (الوحي) وقراءة الكون (السنن الطبيعية).
- نقد النظرة المادية التي تفصل بين المادة والغيب، مع تقديم رؤية متوازنة.
- إسهامات العلماء المسلمين:
- دور علماء مثل البيروني وابن الهيثم في تطوير المنهج التجريبي.
- تأثير القياس الأصولي (من علم أصول الفقه) على المنهج العلمي.
- نقد المنهج الغربي:
- تحليل أزمة الفيزياء الكلاسيكية ونسبية المعرفة العلمية.
- مقارنة بين المنهج الإسلامي (الشمولي) والمنهج الغربي (المادي).
- التطبيقات المعاصرة:
- كيف يمكن تطبيق المنهج القرآني في علوم مثل الفلك والفيزياء.
- أمثلة من نظريات علمية (كروية الأرض، الحركة) تم تأصيلها قرآنياً.
تحليل معمق للكتاب:
1. الإطار النظري والمنهجي للكتاب
يقدم د. منتصر محمود جاهد في هذا الكتاب رؤية متكاملة تجمع بين المنهج العلمي التجريبي والرؤية القرآنية للكون. يعتمد المؤلف على:
- المنهج الاستقرائي: من خلال تحليل الآيات القرآنية التي تدعو إلى التأمل في الكون (مثل: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾).
- المنهج التاريخي: بتتبع تطور المنهج العلمي عند المسلمين وتأثيره على الغرب.
- المنهج النقدي: في تحليل الفلسفات المادية ونقد النظرة الأحادية للعلم.
2. المحاور الرئيسية للكتاب
أ. القرآن والعلم: العلاقة التكاملية
- الدعوة القرآنية إلى العلم:
يؤكد الكتاب أن القرآن لم يكتفِ بدور الوحي الروحي، بل دعا إلى التفكر في الكون كوسيلة للإيمان (مثل آية: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾).- العلم فريضة: يرفض المؤلف فصل العلم عن الدين، مستشهدًا بأقوال علماء المسلمين مثل ابن الهيثم الذين رأوا في البحث العلمي عبادة.
- نسبية المعرفة العلمية:
ينتقد الكتاب الادعاءات المطلقة للعلم الحديث، مؤكدًا أن القرآن أشار إلى حدود العقل البشري (﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾).
ب. المنهج القرآني مقابل المنهج المادي
- إشكالية المادية العلمية:
يحلل الكتاب أزمة الفيزياء الكلاسيكية (مثل تناقضات ميكانيكا الكم) نتيجة إغفال البعد الغيبي، مقارنةً بالرؤية القرآنية التي تجمع بين المادة والغيب. - الزوجية والتناسق الكوني:
يستند إلى آيات مثل ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ ليبين أن القرآن سبق العلم الحديث في الكشف عن الثنائيات الطبيعية (كالبروتون والإلكترون).
ج. إسهامات العلماء المسلمين
- المنهج التجريبي الإسلامي:
يكشف الكتاب كيف طور علماء مثل جابر بن حيان وابن الهيثم المنهج التجريبي بناءً على:- الملاحظة المنظمة (مثل تجارب ابن الهيثم في البصريات).
- القياس الأصولي (من علم أصول الفقه)، الذي يعتمد على تحديد العلة والنتيجة.
- التأثير على الغرب:
يُظهر كيف نقل علماء النهضة الأوروبية (مثل فرانسيس بيكون) أفكارًا من التراث الإسلامي، كفكرة السبر والتقسيم التي تحولت لاحقًا إلى الاستقراء العلمي.
د. تطبيقات معاصرة
- علوم الفلك والفيزياء:
يعرض الكتاب كيف تتفق نظريات علمية حديثة (كـالانفجار العظيم) مع الإشارات القرآنية (﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾). - إسلامية المعرفة:
يطرح مشروعًا لتجديد العلوم بإعادة ربطها بالأسس القرآنية، بدلًا من النموذج المادي السائد.
3. نقاط القوة في الكتاب
- الربط بين النص والعلم:
يقدم تحليلًا دقيقًا لكيفية استنباط المنهج العلمي من القرآن، بعيدًا عن التفسيرات المجتزأة. - العمق التاريخي:
يكشف دور الحضارة الإسلامية في تأسيس المنهج العلمي، وهو ما يُغفل في الكتابات الغربية. - النقد البناء:
لا يرفض العلم الحديث، بل يقترح إطارًا أكثر شمولية يدمج القيم الأخلاقية مع التقدم التقني.
4. نقاط الضعف المحتملة
- إشكالية التوفيق:
قد يُنتقد الكتاب لمحاولته تفسير نظريات علمية حديثة بالقرآن، مما قد يُفهم كـ”إعجاز علمي” يُختزل فيه القرآن إلى كتاب علوم. - التركيز على الجانب النظري:
يفتقر إلى أمثلة تطبيقية حديثة (مثل كيف يُطبق المنهج القرآني في مختبرات اليوم).
5. الخاتمة: رؤية مستقبلية
الكتاب يفتح آفاقًا جديدة لفلسفة العلوم من منظور إسلامي، ويطرح أسئلة جوهرية:
- كيف يمكن للعلم الحديث أن يتجاوز النزعة المادية دون الوقوع في الخرافة؟
- ما دور العلماء المسلمين اليوم في إحياء المنهج التكاملي بين الوحي والعقل؟
يُعد هذا العمل إسهامًا جريئًا في حوار الحضارات، ونداءً لإعادة قراءة التراث العلمي الإسلامي كجسر بين الماضي والمستقبل.
أهم 20 اقتباسات مع التوثيق:
- “القرآن لم يدعُ إلى التقليد، بل إلى النظر والبحث والأخذ بالأسباب” (ص 24).
- “العلم في القرآن نسبي، والإنسان لا يحيط بكل شيء علماً” (ص 28).
- “المنهج القرآني يجمع بين الوحي والكون كقراءتين متكاملتين” (ص 13).
- “الفطرة الإنسانية قابلة للتعلم، والعلم فريضة” (ص 22).
- “القياس الأصولي كان الأساس للمنهج التجريبي عند المسلمين” (ص 84).
- “ابن الهيثم طبّق السبر والتقسيم في تجاربه البصرية” (ص 90).
- “العلماء المسلمون سبقوا بيكون في المنهج التجريبي” (ص 92).
- “القرآن أشار إلى كروية الأرض ودورانها قبل الاكتشافات الحديثة” (ص 172).
- “الجمال في الكون دليل على الإتقان الإلهي” (ص 38).
- “الفيزياء المعاصرة تعترف بالميتافيزيقا كجزء من الحقيقة” (ص 42).
- “الزوجية في الكون (الذكر والأنثى) من الأسس القرآنية” (ص 37).
- “المنهج العلمي المعاصر يعاني من أزمة بسبب إغفال البعد الغيبي” (ص 19).
- “التجربة والعقل شريكان في المنهج القرآني” (ص 75).
- “الاستقراء في القرآن يبدأ من الجزئي إلى الكلي” (ص 66).
- “القرآن دعا إلى الموضوعية ونبذ الهوى في البحث” (ص 59).
- “التراث العلمي الإسلامي هو جسر بين الحضارات” (ص 93).
- “المنهج القرآني يرفض الخرافات ويؤسس لتفكير علمي” (ص 64).
- “العلم في الإسلام وسيلة لتحقيق العبودية لا الاستعلاء” (ص 30).
- “القرآن قدم رؤية منهجية للعلوم الطبيعية قبل قرون” (ص 5).
- “إسلامية المعرفة مشروع لإنقاذ العلوم من المادية” (ص 12).
خاتمة:
الكتاب يُعد مرجعًا أساسيًا لفهم المنهج القرآني في العلوم، ويقدم رؤية متكاملة تجمع بين العقل والوحي، مع إبراز دور الحضارة الإسلامية في تشكيل العلوم الحديثة. يُنصح به للباحثين في فلسفة العلوم والتراث الإسلامي.

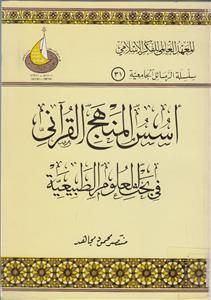






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.