الوصف
الأفكار الأساسية:
- مفهوم المقاصد الشرعية:
- هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم شرعي، وتنقسم إلى:
- الضروريات (الدين، النفس، العقل، النسل، المال).
- الحاجيات (ما يحتاجه الناس لتحقيق المصالح).
- التحسينيات (ما يُحسّن الحياة ويعزز القيم).
- هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم شرعي، وتنقسم إلى:
- أهمية النظرية:
- تربط بين النصوص الشرعية وواقع الناس، مما يجعل الشريعة مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات.
- تُعدّ أساساً للاجتهاد المعاصر، خاصة في القضايا المستجدة.
- منهج الشاطبي:
- اعتمد على الاستقراء الشامل لنصوص الشريعة لفهم مقاصدها.
- ربط بين الجزئيات والكليات، واهتم بفهم النصوص في ضوء مقاصدها.
- المقاصد قبل الشاطبي:
- تناول الكتاب جهود الأصوليين والمالكية في تطوير فكرة المقاصد، مثل الغزالي وابن عبد السلام.
- التطبيقات العملية:
- تُستخدم المقاصد في حل المشكلات المعاصرة، مثل القضايا الاقتصادية والسياسية.
تحليل معمق للكتاب:
1. الإطار النظري والمنهجي للكتاب
يتبنى الريسوني منهجًا تحليليًا تاريخيًا مقارنًا، حيث:
- يستقرئ نصوص الشاطبي في “الموافقات” استقراءً شاملاً.
- يُقارن بين آراء الشاطبي وسابقيه (كالغزالي والجويني) ولاحقيه (كابن عاشور).
- ينقد التصورات التقليدية للمقاصد عبر تفكيكها وإعادة بنائها.
المنهجية تظهر جليًا في:
- تتبع التطور التاريخي لفكرة المقاصد (من الترمذي الحكيم إلى الشاطبي).
- تحليل البنية المفاهيمية للنظرية (الضروريات/الحاجيات/التحسينيات).
- ربط النظرية بالتطبيقات الفقهية (مثل سد الذرائع والاستصلاح).
2. البنية التحتية للنظرية المقاصدية عند الشاطبي
أ. المستويات المعرفية:
- المقاصد الكلية: (حفظ الدين، النوع البشري)
- المقاصد النوعية: (مقاصد العبادات، المعاملات)
- المقاصد الجزئية: (حكمة كل حكم فرعي)
ب. الأدوات المنهجية:
- الاستقراء (لا القياس) أداة رئيسية لفهم المقاصد.
- مراعاة السياق الاجتماعي للتشريع.
- التمييز بين المقاصد الأصلية والتبعية.
3. الإضافات النوعية للشاطبي
يبرز الكتاب ثلاثة إسهامات جوهرية:
- نظرية المراتب:
- الضروريات (الضرورة القصوى)
- الحاجيات (الحاجة الاجتماعية)
- التحسينيات (الكماليات الأخلاقية)
- مبدأ التوازن:
- الجمع بين النص والمصلحة (لا إلغاء النص لصالح المصلحة).
- مثال: تحريم الحيل الربوية رغم مشروعية الصيغ الظاهرية.
- الاستقراء الكلي:
- رفض الاستدلال بالجزئيات المنعزلة.
- ضرورة النظر في النصوص كمنظومة متكاملة.
4. الإشكالات النقدية التي يعالجها الكتاب
أ. إشكالية التعارض الظاهري:
- بين النصوص الظاهرة والمقاصد (مثال: حد السرقة وحفظ المال × ظروف الفقر).
- حل الشاطبي: الترجيح بالمقاصد عند التعارض.
ب. إشكالية التطبيق المعاصر:
- كيف نستنبط مقاصد جديدة لقضايا مستجدة (التأمين، البنوك الإسلامية)؟
- الريسوني يرى أن منهج الشاطبي يؤسس لـ “الاجتهاد المقاصدي المرن”.
ج. إشكالية المذهبية الضيقة:
- الكتاب يُظهر كيف تجاوز الشاطبي الانغلاق المذهبي.
- مثال: تبنيه لسد الذرائع (مالكي) مع الأخذ بالاستصلاح (أوسع من المالكية).
5. تقييم النظرية في ضوء النقد الحديث
الكتاب يعرض إجابات عن انتقادات مثل:
- ذاتية تفسير المقاصد: الريسوني يؤكد على ضوابط الاستقراء.
- إهمال النص: يبين أن الشاطبي يربط المقاصد بالنصوص لا يلغيها.
- التوسع في المصلحة: يوضح الفرق بين المصلحة الشرعية والهوى.
6. الأبعاد التطبيقية للنظرية
يقدم الكتاب تطبيقات عملية:
- في الاقتصاد: تحريم البيوع الغررية (حفظًا للمال).
- في السياسة: تغيير المنكر حسب المصلحة (مراعاة الدرجات).
- في الاجتماع: تشريع الطلاق كحل أخير (حفظًا للنسل).
7. الثغرات التي يكشفها التحليل
رغم تميز الكتاب، تبقى بعض الثغرات:
- عدم معالجة كافية لإشكالية “تزوير المقاصد” سياسيًا.
- قصور في تطبيقات النظرية على القضايا المعاصرة (مثل حقوق الإنسان).
- إغفال النقد الغربي لفكرة المقاصد (كما عند وائل حلاق).
8. الأهمية الاستثنائية للكتاب
تكمن في:
- التأصيل الفلسفي: تحويل المقاصد من مجرد “تعلة فقهية” إلى “نظرية تشريعية كبرى”.
- التجديد المنهجي: الجمع بين الأصول والواقع عبر أدوات الاستقراء.
- التوازن الحضاري: تقديم نموذج إسلامي لفلسفة التشريع قادر على الحوار مع النظريات القانونية الحديثة.
9. الخاتمة: إعادة تشكيل العقل الفقهي
الكتاب ليس مجرد دراسة تاريخية، بل مشروع لإعادة بناء العقل الاجتهادي عبر:
- تحرير الفقه من الجمود الشكلي.
- ربط التشريع بمقاصد الحياة.
- تأسيس “فقه الموازنات” بدل “فقه التراجيح”.
هذا التحليل يُظهر كيف يصوغ الكتاب رؤية تجديدية تخرج بالمقاصد من دائرة “النظرية الأصولية” إلى “فلسفة التشريع الشامل”.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
- “مقاصد الشريعة هي الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.” (ص 18)
- “التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم.” (ص 67)
- “الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح.” (ص 67)
- “الضروريات الخمس هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.” (ص 54)
- “العلة الحقيقية للأحكام هي المصلحة أو المفسدة المقصودة بها.” (ص 23)
- “الاستحسان تسعة أعشار العلم.” (ص 87)
- “سد الذرائع هو أحد أرباع التكليف.” (ص 91)
- “المقاصد العامة للشريعة هي عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش.” (ص 19)
- “الفقه الحي هو الذي يدخل على القلوب بغير استئذان.” (ص 12)
- “الشارع لا ينبغي عما فيه مصلحة راجحة.” (ص 82)
- “العبادات ليست مقصودة لذاتها، بل لمعانيها ومصالحها.” (ص 26)
- “التعليل يساوي التقصيد.” (ص 25)
- “الضروريات لا تنفك عنها شريعة من الشرائع.” (ص 56)
- “المصلحة المرسلة هي حفظ مقصود الشارع.” (ص 53)
- “الترجيح بين المصالح يكون بحسب درجتها.” (ص 58)
- “الظاهر والانضباط يحتاج إليهما عند تقديم الأحكام للناس.” (ص 25)
- “الاجتهاد المقاصدي هو ثمرة النظرية.” (ص 13)
- “الشارع يربط الأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة.” (ص 23)
- “المقاصد الجزئية هي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي.” (ص 20)
- “الاستقراء هو الطريق الأمثل لمعرفة مقاصد الشارع.” (ص 10)
الخاتمة:
يُعدّ هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة الإسلامية، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويقدم رؤية واضحة لدور المقاصد في فهم الشريعة وتطبيقها. وهو ضروري لكل باحث في الفقه وأصوله، كما أنه مفيد للمهتمين بالشؤون الفكرية والاجتماعية المعاصرة.
للقراءة والتحميل

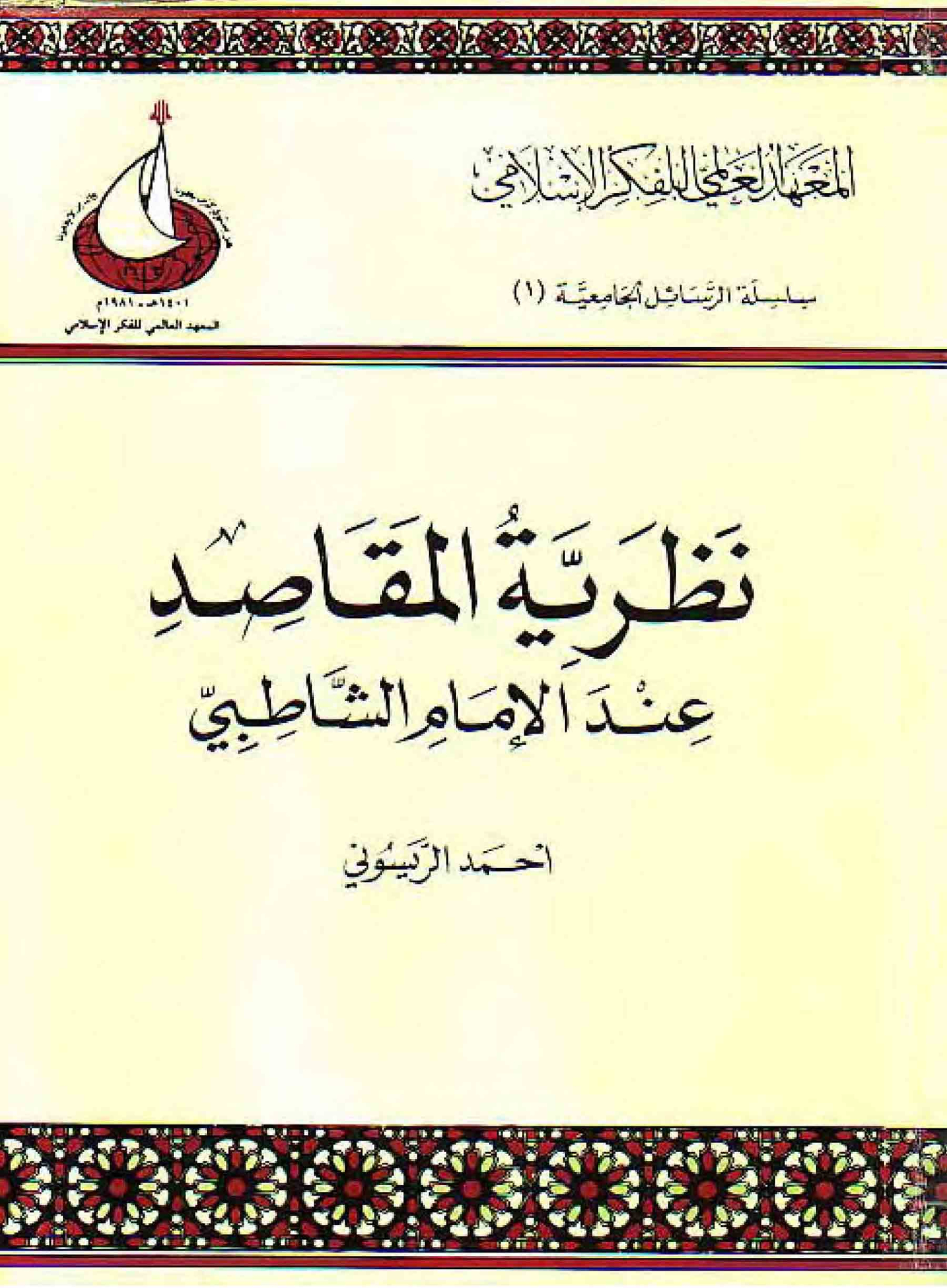
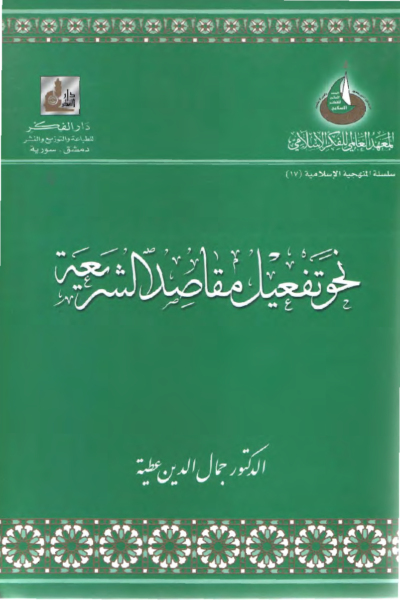

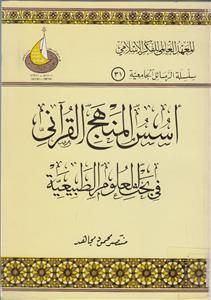
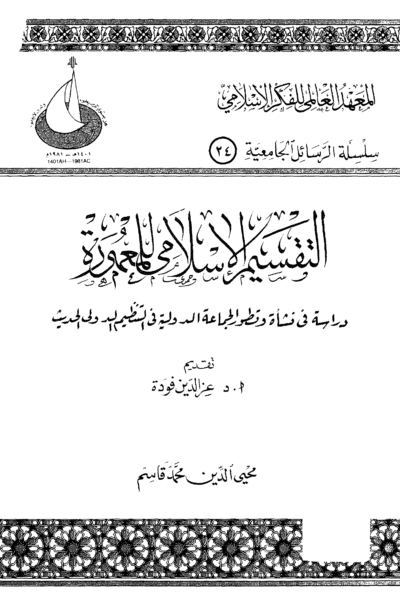
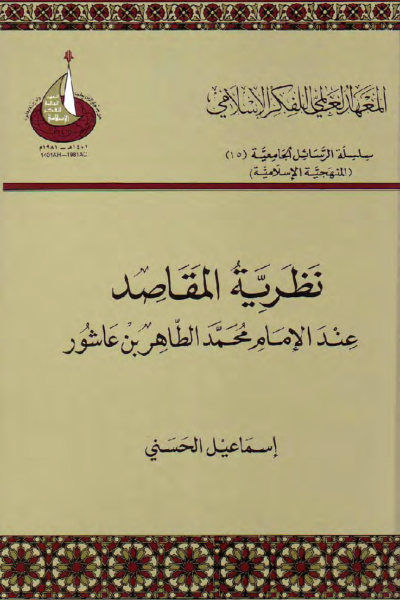

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.