الوصف
كلمة التحرير
===========
حرصنا من البداية أن تكون إسلامية المعرفة منبراً يحمل إلى القارئ الجهود العملية والفكرية الساعية إلى تطوير المشروع الحضاري الإسلامي وبناء مستقبل الأمة على أساس من المعرفة المنهجية والنظرة العلمية الصارمة. ذلك أننا على قناعة راسخة بأن التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يتطلب رؤية ثاقبة ومتماسكة تمكن المسلم المعاصر من تحديد موقعه ووجهته، وتقدير إمكانياته الذاتية وطبيعة العقبات التي تعترض مسيرته. وتجربة المسلمين القريبة تظهر عبث الانطلاق في الفعل من ثوابت تم تبنيها دون نظر واختبار، وعدم جدوى التحرك دون معرفة مواطئ القدم وتحديد معالم الدرب.
بيد أنه من المفيد أن ننبه إلى أن إسلامية المعرفة، بوصفها تجسيداً لطموح علماء الأمة ومفكريها في بناء قاعدة معرفية تنطلق من ثوابت الوحي الإلهي وتهتدي بقيمه، لا تهدف بأي من الأحوال إلى إنتاج خطاب أحادي تتطابق فيه الاجتهادات وتختفي ضمنه الفروق النظرية والتجريبية، وتتماثل عبره النتائج، بل إلى توليد خطاب توحيدي، ترتبط فيه الروح بالجسد، وتتلاحم ضمنه القيمة والفعل، ويتكامل عبره الفرد والمجتمع، ويتواصل من خلاله المثل والواقع. وشتان بين الرؤية الأحادية المختزلة والرؤية التوحيدية المتوازنة.
إن الرؤية الأحادية التي تعادي الحوار وترفض الرأي الآخر كانت -ولم تزل- سمة من سمات الجمود والتخلف والتراجع الفكري، ومدخلاً ولج منه كل متسلط ومستبد. لقد توافقت مراحل النهوض الثقافي والحضاري في تاريخ المسلمين مع الانفتاح الفكري وتعدد وجهات النظر ومناحي الاجتهاد، كما تلازمت عهود الانحطاط والتخلف مع الانغلاق المعرفي ومحاربة كل رأي مخالف دون النظر في محتواه. أما الرؤية التوحيدية فإنها ترى في تعدد الاجتهادات واختلاف الآراء ومناحي النظر خيراً كثيراً، لأن ذلك مدعاة لاتساع الآفاق وإدراك أبعاد غائبة وخفية. ذلك أن الرؤية التوحيدية على الرغم من انطلاقها من ثوابت راسخة وتوجهها نحو المطلق، تدرك أن السمو في معارج الكمال يمر عبر المحاولة والخطأ والاجتهاد والنقد والمراجعة …
بحوث ودراسات
==============
يعد البحث محاولة تطوير واقتراب منهاجي في التعامل مع النظم السياسية العربية في سياق مقارن. فقضية التعريف والتحديد لماهية المنطقة العربية هي جوهر التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية. وتعتمد الباحثة في ذلك التعريف المنهاجي على التعريف بالاقترابات البديلة لتكييف المنطقة، وبالمدخل الحضاري للتفاعل مع الواقع، وبالعمق التاريخي للمنطقة الحضارية العربية. ويتعرض البحث إلى محاولة إصلاح الدولة العثمانية، ومحاولة إحياء القومية العربية وزعماء الإصلاح كالكواكبي، ومصطفى كامل ودعوتهم إلى إقامة خلافة عربية. وكذلك ظهور مصطلح “الشرق الأوسط” على الساحة الدولية تأثراً بانتشار مفهوم دراسات المناطق التي تتمتع بخصائص ثقافية واجتماعية مشتركة.
——————–
تهدف الدراسة إلى إبراز أبعاد العلاقة الجدلية بين علمي الأصول والكلام، واستيعاب مباحث الأصول في مباحث الكلام. وإلى تحليل الظروف الفكرية والسياسية التي دفعت بالمتكلمين إلى التركيز على علم الأصول دون غيره، لإبراز تطور مباحثه وموضوعاته على أيدي المتكلمين، ومدى تأثره بالظروف السياسية، والاجتماعية، وتفاعله مع مشكلات عصره حتى وإن كانت مرجعيته هي الوحي الإلهي. وتؤكد الدراسة على أن بحث المتكلمين في الأصول أحدث نقلة نوعية في بنية هذا العلم، وارتقى به وجعله يفيد من التراث الفلسفي اليوناني، ومن أدوات الرصد والتحليل في العلوم الاجتماعية المعاصرة، وذلك لتوليد فقه جديد يواكب المستجدات.
الملخص
يحتاج عالمنا الإسلامي إلى ترسيخ الفكر الاستراتيجي وتحديد مفهوم الاستراتيجية، وذلك ليبرز حركية المصطلح وسعة مفهومه، فما زال عدد من سواعد العالم الإسلامي، وعقوله، وأمواله تخدم الثقافة الغربية، والمنظومة الفكرية الغربية المغذية له وهي غير واعية بذلك. فيبدأ البحث بشرح مدى حاجة العالم الإسلامي إلى استراتيجية للثقافة، ويناقش التنافس والصراع الحضاري بين الثقافات، وحاجتنا إلى فكر استراتيجي نابع من فكرنا الإسلامي، يتجاوب مع تطور الفكر الاستراتيجي المعاصر، وإلى الدراسات الاستراتيجية ودراسات استشراف المستقبل، وذلك حتى يتم الوعي والعمل الجماعي للأمة الإسلامية.
بسبب ما يعانيه المصطلح من غموض وتفسيرات شتى، يمضي بعضها لكي يتعامل مع مفردات الواقع دون منهج، ويمضي بعضها الآخر لكي يتشبث بالحلم المعلق في السماء دون أي قدر من الممارسة الواقعية للتحقق بمفرداته في نسيج الحياة الإسلامية… وبين هذه وتلك يتأرجح الإنسان المسلم بين الإحساس بالإحباط الذي قد يقود إلى حافات اليأس والاستسلام، وبين الهروب إلى الأماني والأحلام التي لا تكاد تصنع شيئاً ذا قيمة تاريخية أو حضارية؛ بسبب من هذا كله يتحتم علينا جميعاً أن نتريث قليلاً لمراجعة حساباتنا للوصول إلى الأقدر من الثوابت، من الجزر المشتركة، من لغة واضحة محددة للتعبير عن مطالب المشروع.
لا ريب أن ثمة محاولات تنظيرية قيمة طرحت في هذا السياق ومحاولات تطبيقية أخرى شقت طريقها في واقع الحياة الإسلامية… ومع ذلك فإن علينا أن نمارس المزيد من الصقل والكشف والتحديد وترتيب الأولويات، لكي تكون بمثابة برنامج عمل يجعل المشروع حقيقة واضحة المعالم، وأمراً واقعاً قد يبدأ بخطوة واحدة، ولكنها الخطوة التي تقود إلى قطع رحلة الألف ميل بمشيئة الله.
قراءات ومراجعات
===================
تقديم عام
يمثل هذا الكتاب الجزء الأول من خمسة أجزاء، يشتمل عليها مشروع المؤلف لدراسة الإنسان في العقيدة الإسلامية، تأسيساً لما يدعوه بـ”علم الإنسان الإسلامي“، الذي يهدف إلى “بناء تصور إسلامي للإنسان مستخلص من التحديدات التي جاءت بها العقيدة الإسلامية في القرآن والحديث مبينة لحقيقة الإنسان ووظيفته الوجودية وغايته” (ص8). ويرى المؤلف أن هذا المشروع يجد مسوغاته من خلال عناصره التي هي بالأساس ذات بعد عقدي، كما أن المباحث التقليدية لعلم الكلام، إنما كانت استجابة لتحديات واجهت الفكر الإسلامي في الماضي، وبالتالي يكون لزاماً على هذا العلم مسايرة التحديات المعاصرة إذا ما أريد له الحفاظ على وظيفته في الدفاع عن العقيدة الإسلامية.
ولعل التصور الغربي لحقيقة الإنسان الذي تأسست عليه العلوم الإنسانية، يمثل أهم التحديات التي يجب أن ينهض الفكر الإسلامي لمواجهتها، من خلال تأصيل تصور للإنسان يستمد تحديداته من نصوص الوحي، ويكون مرجعاً للحركات الفكرية الساعية إلى أسلمة المعرفة لبلوغ المقصد المنشود. بل من الضروري العودة إلى الجذور العقدية التي تنبني عليها تلك العلوم، وبذلك نحمي هذا المشروع من أن يقع في التناقض مع الحقيقة الدينية، أو أن يقع في تقليد أنماط حياتية مخالفة لمنطلقاتنا العقدية، فتؤدي بنا إلى نتائج مخالفة للغاية الدينية.
وفي هذا الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه يحاول المؤلف في الفصل الأول منه أن يتناول حقيقة الوجود الإنساني ابتداءً، وذلك من حيث مبدؤه كفكرة في العالم الغيبي، وما ينطوي عليه وجوده من حكمة تميزه عن سائر الموجودات. ويبحث في التحقق الوجودي للماهية الإنسانية بالنسبة للفرد ومكانة الإرادة الإنسانية في ذلك. ويعقب في خاتمة كل فصل بالأثر النفسي الذي تخلفه التصورات المختلفة لحقيقة الإنسان، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. ويتركز البحث في الفصل الثاني حول المبدأ الزمني للإنسان الذي به يتحقق الوجود الإنساني في العالم المشهود …
——————–
إن الحصول على معطيات حول الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية وتطورها في القرون الأخيرة يعد من الأمور الصعبة، خاصةً إذا ما علمنا أن أغلب إنجازات العلماء -بعد مرحلة صدر الإسلام الأول- لم تكن سوى تفاسير وشروح للاجتهادات الموروثة عن المدارس الفقهية الأربعة الكبرى. فقد أصبح التشريع الإسلامي عبارة عن قوالب جامدة وجاهزة لا تراعي خصوصيات الأحداث وتغيرات المجتمع في الزمان والمكان.
ولم يبق سوى باب الزكاة -في كتب الفقه- مؤشراً مناسباً للحصول على صورة صحيحة لتطور الأحداث الاجتماعية والاقتصادية على الوجه الأخص.
فتشريع الزكاة أداة أساسية لتنشيط الاقتصاد لا يمكن أن يكون أمراً خارج إطار الزمن (Imtemporel)، كما لا يمكن أن يكون منبتاً ومنفصلاً عن الواقع المعيش نظراً للمهمة المنوطة بالزكاة في عملية توزيع الثروة بل وفي تكوين رأس المال نفسه.
إن تجديد الفقه وتطوير تجارب تطبيقية للشريعة الإسلامية من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية وعمارة الأرض وربط الواقع بالمثال.
وفي هذا الإطار تأتي قراءتنا لكتاب الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور، الذي تتناول فيه بالبحث المحاور الآتية: …
——————–

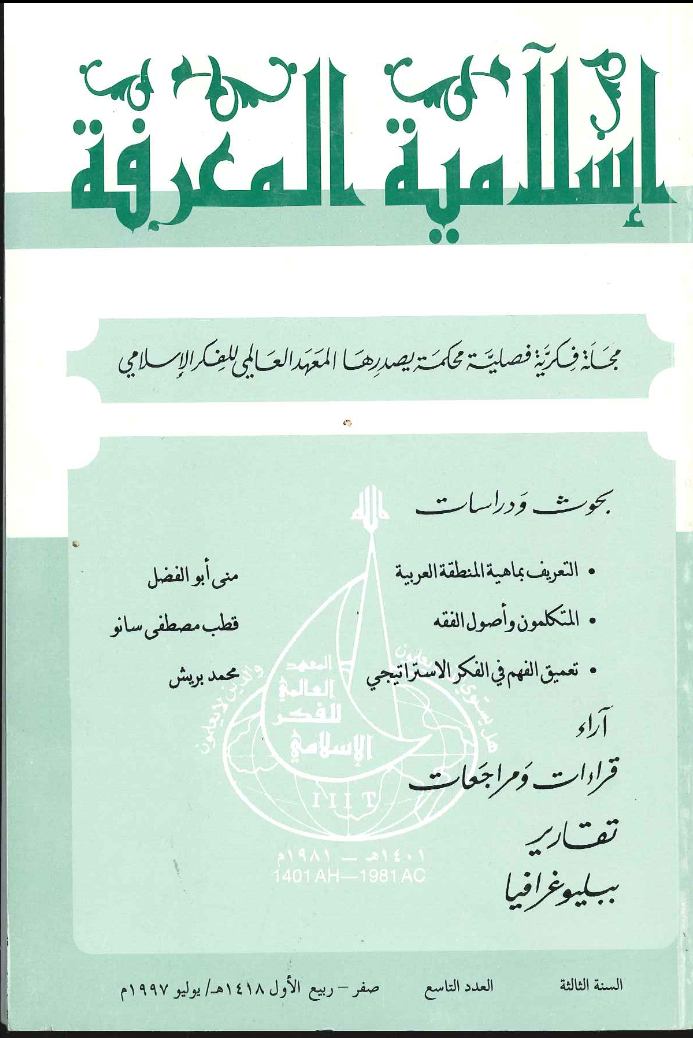
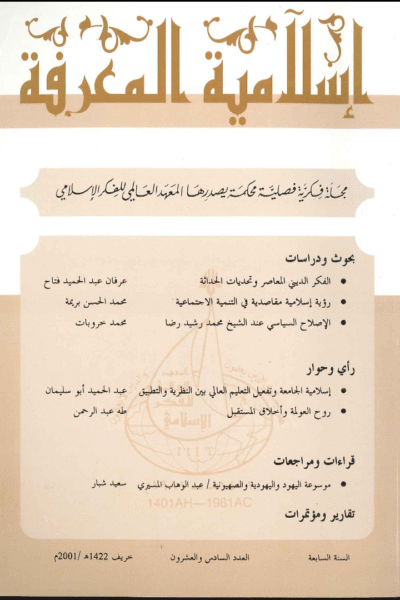
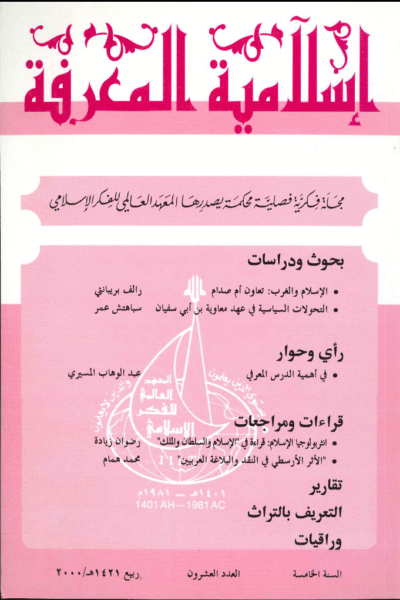
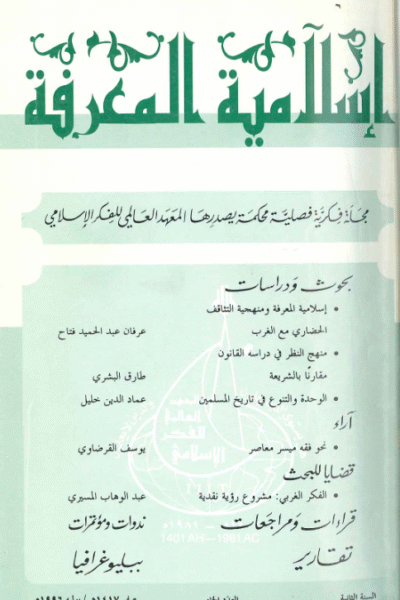
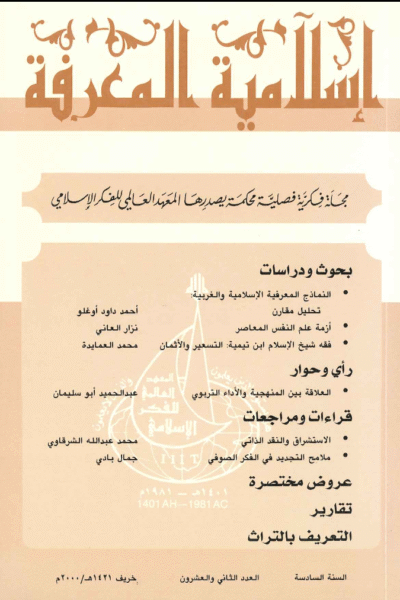
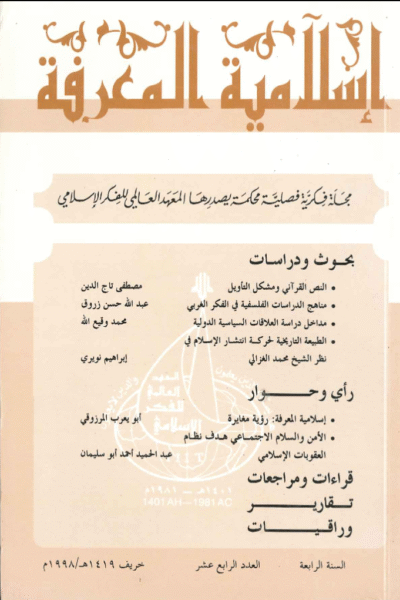
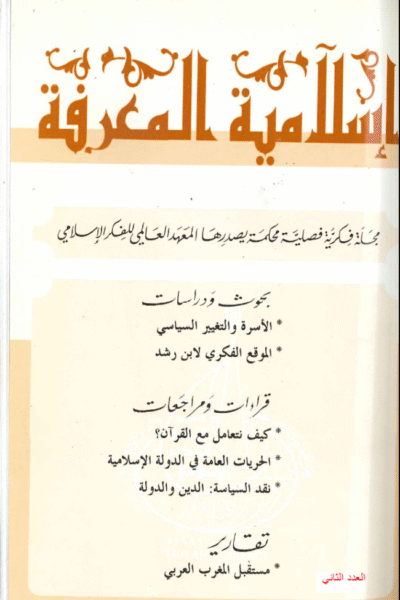
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.