الوصف
كلمة التحرير
===========
إنّ هذا العدد الذي نقدمه لقراء إسلامية المعرفة يمثل الحلقة قبل الأخيرة في دورتها الرابعة التي ستكتمل على أيدي زملائنا في المقر الرئيسي للمعهد بالولايات المتحدة الأمريكية، لتأخذ المجلة من هناك انطلاقة جديدة بإذن الله تعالى. فمنذ إنشائها أواخر عام 1994 تولّى مسؤولية الإشراف المباشر على إصدارها أعضاءُ هيئة تحريرها المقيمون في ماليزيا، بالتشاور والتنسيق مع بقية الأعضاء المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ولعلّ من أهم ما يحق للمرء أن يبرزه ويفخر به من معالم هذه التجربة ذلك التناغم وروح الفريق اللذين طبعا عملنا طيلة السنوات الماضية من مسيرة المجلة، على الرغم من أنّه لم يسبق لأغلبنا عملٌ مع بعضنا البعض أو حتى معرفةٌ ببعضنا البعض أو حتى معرفةٌ ببعضنا البعض، فضلاً عن التباين الواضح فيما بيننا من حيث التكوين العلمي والأصول الاجتماعية والثقافية. ولا يعني التناغم وروح الفريق هذا أنّنا كنا نصدر في تفكيرنا وتقديرنا للأمور عن نمط واحد مغلق من النظر لا نعدوه، فطبيعة التباين الذي بيننا لا تسمح بذلك. وإنّما المهم أنّ ذلك التباين نفسه هو الذي هيأ القاعدة لتنوّع وثراء في الرؤى جعل سياسة النشر التي سارت عليها المجلة تأتي أكثر رشدًا ونضجًا إذ هي تتحرك في أفق رحب من ذلك التنوّع تتكامل فيه الأنظار والتقديرات، ولا يكون فيه مجال لأن يتسلّط أحد برأيه في توجيه تلك السياسة وتحديدها. والحقيقة إنّه يمكن للمرء أنّ يرى في هذه التجربة المحدودة نموذجًا لكيفية إدارة الشورى وجعلها سلوكًا عمليًّا سلوكًا يلتزم الجميع بمقتضياته ونتائجه.
وإنّ من الأمور التي تستحق التنويه بها هنا ذلك الحرص البالغ حدَّ الصرامة والتضييق على النفس في بعض الأحيان، على أن يكون أداء المجلة شكلاً ومضمونًا في حركة متقدمة صاعدة أبد، أو أن لا يكون – على الأقل – مستوىالمادة التي نقدمها في كلِّ عددٍ جديدٍ دون الذي سبقه. ولئن أكدت لنا التجربة – كما ذكرنا في العدد السابق – أنّ تحقيق هذا الهدف ليس أمرًا يسيرًا في كل الأحوال، فإن الالتزام به معيارًا في سياسة النشر في المجلة جعلنا نفكر في الكيفية التي يمكن أن نستخلص به خير ما ينطوي عليه الكتابُ والمفكرون ممّن أتيح لنا التعامل معهم. وهذا يستدعي أخذًا وردًّا ومراجعة مع الكاتب، فقد نقترح عليه الكتابة في موضوع ما، وقد ندعوه إلى التركيز على بعدٍ …
بحوث ودراسات
==============
يحاول البحث بناء النموذج الاجتماعي الإسلامي من القرآن الكريم، ويثير عددًا من القضايا المنهجية التي تواجه المنظر الاجتماعي. يشرح البحث منظومة المفاهيم المفتاحية كمفهوم الإحصان، والعفة، والفاحشة، والرحم، وظاهرة تقطيع الأرحام والفساد في الأرض، ومفهوم الأم، والمدينة، والأمة. ويتناول كيفية تحويل المفاهيم إلى قضايا علائقية ومؤسسية. كما يتناول أحكام القرآن المعيارية الاجتماعية، كنكاح المحارم، وأحكام الفاحشة الاجتماعية، وأحكام الزواج، والطلاق، والولاية، والكفاءة، والميراث، والقصاص، والوقف. مختتماً البحث بالقضايا الاحتمالية، والأحكام القطعية، والتنظيمات الاجتماعية المحكمة.
يراجع البحث مسيرة الفكر الإسلامي المعاصر مع قضية الدولة والتغيير الاجتماعي، ويبرز المفارقة التاريخية التي وقع فيها العقل المسلم منذ ما عرف بعصر النهضة في العالم الإسلامي وهي “الدولة ضد المجتمع”، فيشرح البحث مفهوم التغيير وأثره في قيام الحضارات، والدولة في الفكر الإصلاحي، والضرورة الشرعية والاجتماعية للسلطة، والاستبداد الشرقي بين الحقيقة والمبالغة، ونشأة الدولة في الغرب، وتكون الدولة وتطورها في أدبيات الإسلاميين المعاصرين، ويتناول بعض الأوهام العالقة في أذهان النخب المثقفة كوهم الحياد، والخيار الشخصي، والحتمية الطبيعية، مختتماً بمحاولة تحقيق الاستقرار بين الدولة والمجتمع.
الملخص
يضع البحث إطاراً نظرياً معرفياً يوجه أي بحث في نظرية المعرفة من خلال القرآن الكريم، مؤكداً على أنها لا تنفك عن الرؤية الكونية الكلية للوجود والحياة. ويُفصل البحث أثر الدين في الوعي الجمعي للأمة، وفي الحياة الإنسانية والاجتماعية. ويتناول نظرية “محورية الإنسان الفرد” التي أحالت الحياة إلى عبثية في ظل غياب الوحي الإلهي، ومحاولة تحويل إمامة القرآن إلى برامج عملية قادرة على تفعيل الخطاب القرآني. ويحدد معالم النظرية المعرفية الإسلامية كالإقرار بإمامة القرآن، والتفرقة بين عالمي الغيب والشهادة، والإقرار بمحورية الخالق، وإدراك الوسطية والاعتدال في صياغة نظرية المعرفة.
===================
العنف مراوحة بين المبدأ والخيار في الفكر السياسي الإسلامي
مع نهاية قرن من الحروب الأهلية وبدءًا بأفول الخلافة الراشدة ثم أحداث الحسين بن علي وعبد الله بن الزّبير ومحمّد النّفس الزكيّة – رضي الله عنهم أجمعين- وانتهاءً بسقوط الدولة الأموية ثم قيام الدولة العباسية التي لم تختلف في جوهرها عن النظام الأموي، أفتـى رجال مدرسة المدينة ونعني بها هنا المدرسة الإسلامية التابعة لفكر مدرسة الخلافة الراشدة والرافضة للنّزعات القبلية والشعورية الاستبدادية أفتوا بتحريم الفتنة والخروج على السلطان ولو كان ظالمًا.
ولم يكن هذا الموقف حبًّا في الظلم ولا تقليلاً من شأنه، ولكنّه كان النتيجـة الطبيعيـة لفشل الثورات الإصلاحية على الأنظمة المستبدّة والمبدّدة، حيث أصبح من الواضح أنّ الحروب الأهلية لم تحسم رأيًا ولم تغيّر من طبيعة الأنظمة السياسية والاجتماعية شيئًا ذا بال، ولم يكن لها من ثمرة إلاّ إراقة الدماء.
وحينها وصل الإسلاميون (رجال مدرسة المدينة) إلى النتيجة الطبيعية، وهي وجوب التحوّل من الثورة والرّفض إلى العزلة والمعارضة ضمن إطار الأنظمة القائمة، لذلك نجد رجلاً من قادات مدرسة المدينة الإسلاميين (العلماء والمثقفين) مثل أبي حنيفة النعمان يدخل السجن لأنّه لم يقبل تولّي القضاء لبني العباس.
واستقلّ العلماء (مدرسة المدينة الإسلاميون) بالجوانب الشخصية للفرد المسلم ونجحوا في الانفراد بتوجيهها بما لهم من العلم والإخلاص وطهر أيديهم وتركوا مرغمين شؤون الحكم والسلطة والنظام العام للملوك والسلاطين يتصرّفون فيها كما يعنّ لهم ويتّفق وأهواءهم، مما أورث – فيما بعد- النفسية الإسلامية اعتبار أنظمة الحكم والنظام العام أنظمة اغتصاب غير مشروعة. ويعتبر تشكّل مثل هذه النفسية في ضل هذه الظروف التاريخية – بغض النظر عن أسبابها- من أهم عوامل ضعف البعد الجماعي والعام في تكوين نفسية الفرد والمسلم وموقفه النفسي من النظام والمصالح العامة.
وموقف العزلة والمعارضة هذا من قبل رجال مدرسة المدينة (العلماء) لم يأت في الحقيقة نتيجة نظرة مبدئية قيمية في التخلّي عن استخدام العنف والرّفض المسلّح ضد الصفوات الحاكمة الظالمة، لكنّه كان في جوهره تسليمًا بالأمر الواقع على أساس من الضرورة والمصلحة، أي إنّ عدم استخدام العنف من أجل الإصلاح في فكرهم هو قضية خيار لا قضية مبدأ …
قراءات ومراجعات
===================
ينطلق مؤلف الكتاب من مبدأ المصلحة وأثره في الفقه الإسلامي لم يكن وليد عصر الشاطبي، بل عرف منذ فجر تاريخ التشريع الإسلامي، إلاّ أنّه ظل محدود الاستعمال بوصفه مصدرًا مستقلاً للفقه الإسلامي لاعتبارات عقدية وفلسفية. والجديد الذي أضافه الشاطبي هو إدراج مفهوم المصلحة ضمن سياق نظريته في مقاصد الشريعة وتناوله بالدراسة والتحليل، الأمر الذي حرّره من كثير من القيود والمحاذير التي كانت تشوبه. فمفهوم المصلحة يشكّل القاعدة الأساس لنظرية المقاصد عند الشاطبي، ذلك أنّه لم يقتصر على تطوير مفهوم المصلحة بوصفه أساسًا لمعقولية الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان بقدرتها على التكيّف مع مختلف الظروف والاستجابة للحاجات المتجدّدة، ولكن أظهره فضلاً عن ذلك أساسًا لاستمرارها وثباتها وعالميتها (التمهيد، ص1) …
تمتد أصول العلاقات الدولية عبر التاريخ إلى أزمان قديمة، حيث كانت نشأة المجتمعات المستقرة، فكان من الطبيعي أن ترتبط هذه المجتمعات بعلاقات جوارٍ وتعاونٍ، كما ترتبط بعلاقات التنافس والتنازع والحرب من أجل البقاء، وعليه فإن موضوع العلاقات الدولية قديم قدم الأنظمة الاجتماعية والسياسية التي عرفها الإنسان منذ القدم.
هذا وتعد العلاقات الدولية في وقتنا الحالي دراسة علمية حديثة العهد والنشأة، وهي عبارة عن امتزاج بين عدة علوم مختلفة مثل: التاريخ والقانون والسياسة والاقتصاد والاجتماع.
وغني عن البيان أن للإسلام وجهة نظر خاصة في العلاقات الدولية، بحيث يستطيع الدارس أن يلحظ السمات العامة للعلاقات الدولية الإسلامية من خلال عملية استقراء لمعطيات تاريخ الدولة الإسلامية منذ عهد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى وقت سقوط الخلافة العثمانية، فضلاً عن دراسة ما ورد في القرآن الكريم والسنة من توجيهات وأحكام ومبادئ تختص بتنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الأمم والدول.
وهذه الدراسة التي بين أيدينا تأتي لتمثل إضافة حقيقية وجوهرية في مشروع العلاقات الدولية، فهي دراسة تهتم بنشأة التنظيم الدولي الحديث ووضعه في تاريخه وسياقه والكشف عن جذوره المعرفية ومتضمناته وكوامنه، وكذلك تعد هذه الدراسة بحق كاشفة عن كثير من الأبعاد التي لم تكن متداولة في حقل التنظيم الدولي الحديث والعلاقات الدولية. …

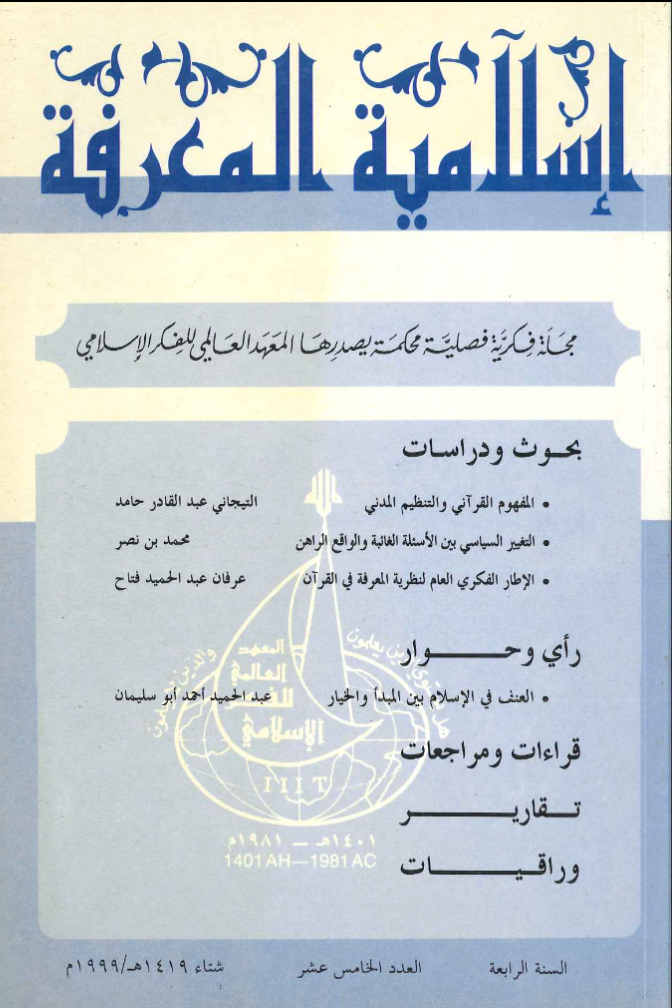
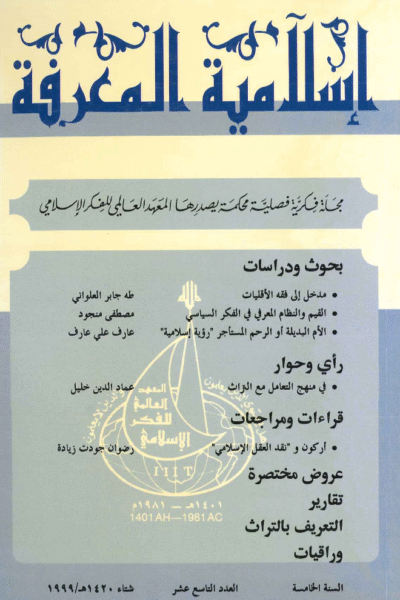
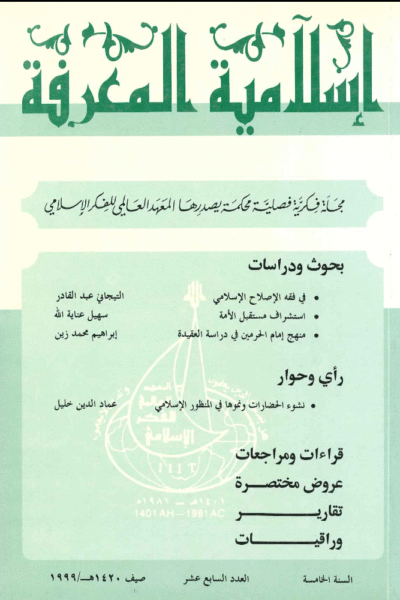
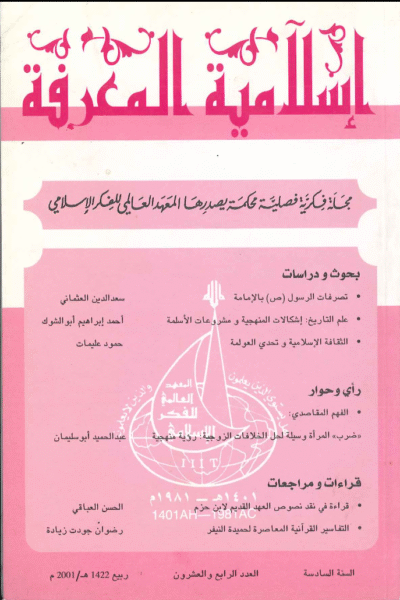
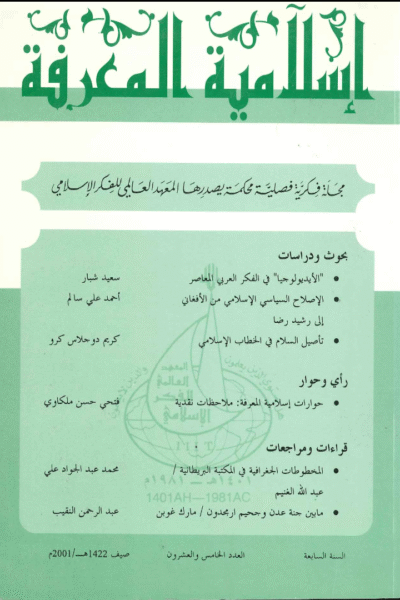
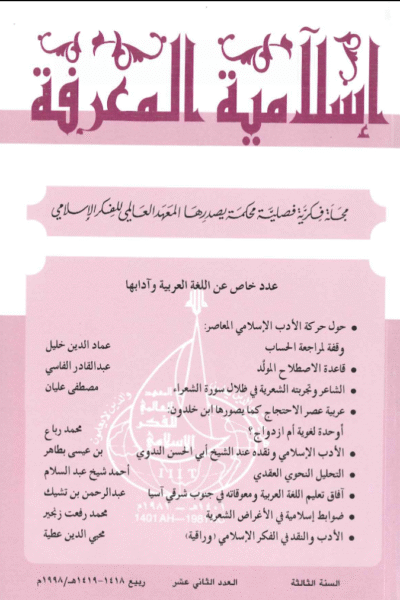
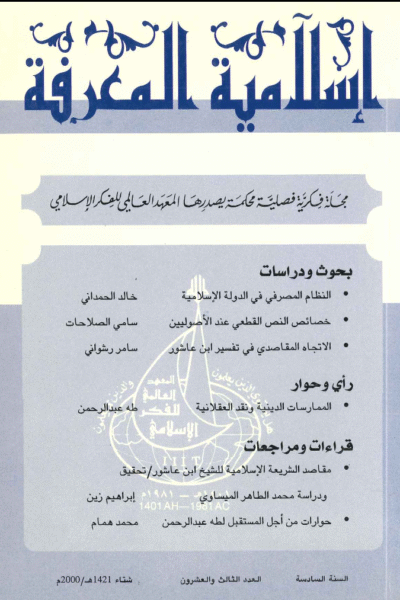
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.