الوصف
كلمة التحرير
===========
حمداً لله على آلاته ونعمائه إذ أنـزل القرآن الكريم المعجزة الخالدة بلسان عربي مبين، على أبين البلغاء وأفصح العرب محمد خاتم الأنبياء والمرسلين…
وبعد:
فهذا ميلاد عدد (خاص) من مجلة إسلامية المعرفة، عدد يحتفي به رجال اللغة العربية وآدابها، لأه يقدم مائدة ثرية غنية، وتحتفي به ملائكة السماء، لأنه من الكلم الطيب: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه﴾ (فاطر:10).
وإسلامية المعرفة، التي تسعى إلى إعادة صياغة المعرفة الإنسانية، وتحقيق الإصلاح المنهجي للفكر الإسلامي، وتطوير البديل المعرفي الإسلامي وبلورته في العلوم الإنسانية والاجتماعية، تجعل الرؤية الإسلامية منطلقاً للعلوم والمعارف والآداب والفنون، وتعزز مكانة اللغة العربية وآدابها بوصفها اللغة التي تنـزل بها الوحي الخاتم.
وقد انصب اهتمام مجلة إسلامية المعرفة في أعدادها السابقة خلال السنوات الثلاث السالفة على البحوث الإنسانية في إطار علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والقانون والشريعة، والثقافة والفكر والحضارة.
فكان لا بد من الالتفات إلى الدراسات الأدبية واللغوية، وفتح أبواب المجلة رحبة للبحوث المتخصصة في هذا المجال الحيوي.
ومن هنا جاءت فكرة هذا العدد الخاص من المجلة لتقديم الدراسات العلمية في الأدب الإسلامي ونقده، نظرياً وتطبيقياً، ولصياغة تاريخ أدبنا العربي صياغة إسلامية، والعناية بتراث علماء اللغة المسلمين، وإبراز أهمية العلوم اللغوية في فهم الخطاب القرآني والحديثي، والنهوض بتعليم العربية إلى المستوى اللائق بها، والإفادة من الحاسوب في خدمة اللغة والأدب …
بحوث ودراسات
==============
يبدأ الباحث بتحليل إشكالية الحداثة والتراث، وثنائية الشكل والمضمون، ثم يتناول غياب المنهج، وغياب التوازن عن الساحة الأدبية الإسلامية، مختتماً بالدعوة إلى التخطيط، ومقترحاً تسع نقاط تدور حول الموقف من الأدب الغربي، والضوابط والمعايير الفقهية، والتوازن في المعطيات الأدبية على مستوى النقد، والتاريخ، والتنظير، والتنوع، وترتيب الأولويات، والتفاعل مع آداب اللغات الأخرى، والحوار مع الأصول التراثية لأدبنا العربي، والحوار فيما بين المعنيين بالأدب الإسلامي، وفتح الصدر أمام الاتجاهات كافة ما دامت ملتزمة الضوابط الشرعية، والاهتمام بالساحتين الأكاديمية والإعلامية للخروج من العزلة الثقافية.
قسم الباحث مقاله إلى خمسة أقسام، تناول في الأول منها الاصطلاح وتصوراته، وخصص القسم الثاني للمولد المصطلحي (GENTERM)، ثم تناول في القسم الثالث مولد الصور(GENFO)، وأتبعه بالقسم الرابع عن التخطيط العام لقاعدة الاصطلاح المولد، إذ عزز مخططه برسم بياني توضيحي، وانتهى بالقسم الخامس عن اللغات المختصة، والمكونات المفهومية والمعرفية، والخصوصيات الثقافية. ثم اختتم بخلاصة موجزة أكّد فيها أن الاصطلاح ينبغي أن يخضع لضوابط ولنسقية، وتكون الضوابط منبثقة من ضوابط اللغة العامة، وأن الاصطلاح المستقبلي لا بد أن يكون مرتبطاً بالتوليد الآلي نظراً للعدد الهائل من المصطلحات التي نحتاج إليها.
الملخص
يدلل البحث على أن التجربة الشعرية ذات طابع خلقي ديني، إن صدرت عن الشخصية الإسلامية بصفاتها من الإيمان، والعمل الصالح، وذكر الله، والانتصار من الظالم، أو بمقوميها العقلي والنفسي وضابطهما العقدي، حتى يكون الحق والصدق مبدأ التجربة ومآلها، ومنطلقها التأسيسي، ومنتهاها الفكري. فالشاعر المسلم معني بأن ينقل للناس أفكاراً ومفاهيم عن الإنسان والكون والحياة، وأن يعمل على تقريبها من أذهانهم بمحاولة اقترانها بواقعها المحسوس لديهم، وذلك بالإبانة والوضوح، وبالصدق في الإحساس والإخلاص في التعبير عنه، ولا يتأتى ذلك إلا بالتقوى واليقين.
يبدأ الباحث ببيان القضية وأبعادها، متخذاً من العربية التي تنزّل في زمنها القرآن الكريم واقعاً للمعاينة والوصف، مستنداً إلى مؤشرات دالة، أصّلها ابن خلدون في “مقدمته”. فيتناول اللغة المُضرية كما وصفها ابن خلدون، وزمنها، وأهلها، ومتحدثيها، وسماتها، واكتسابها، وتعلمها، ليخلص إلى نفي الازدواج، وإلى عدّ وحدة العربية في عصر الاحتجاج نموذجاً يُستأنس، ويستثمر من أجل النهوض بالعربية، لتصبح لغة الناس المرسلة، وأن ما قدمه ابن خلدون في حديثه عن اكتساب اللغة وتعلمها، ليعد أساساً معيناً على الارتقاء بالفصحى، إذ إنّ تنظيره لهذه القضايا يتطابق ونتائج النظريات اللغوية المعاصرة.
يتناول الباحث – بعد التمهيد – مفهوم الأدب الإسلامي عند الندوي، ووظيفته، وصلته بالتسلية، ويقارن بين الأدب الحي والمزخرف، ثم إسهام الأدب في الحضارة، ويحلل أدب الرحلات عند الندوي من خلال كتابيه: “مذكرات سائح في الشرق العربي” و”أسبوعان في المغرب الأقصى”، ثم ينتقل إلى آراء الشيخ في النقد الأدبي، فيتناول التأصيل الإسلامي للنقد، ووظيفته، وصفات الناقد المسلم، وأن النقد وسيلة لا غاية، وأثر القيم فيه، ثم يقدم نظرات نقدية تطبيقية في عالم الشعر من خلال جلال الدين الرومي ومحمد إقبال، وفي عالم النثر، مختتماً بالآفاق العالمية للأدب والنقد الإسلاميين عند الشيخ الندوي.
——————–
يبدأ الباحث بتعريف المعتقدات، والتحليل النحوي، ثم يتناول اللغة والاعتقاد، والدرس اللغوي والعقيدة، والدلالة بين النحو والعقيدة. ثم يذكر بعض أوجه تأثير المعتقدات في التحليل النحوي، مثل بناء نظريات لغوية عقدية، واستغلال اللغويين التحليل النحوي للدفاع عن الأسلوب القرآني، واستنباط دلالات عقدية، والتوجيه العقدي للتركيب. ثم يذكر المواطن التي يتجلى فيها هذا التأثير، كتحديد الخصائص التركيبية، وتحديد العلاقات التركيبية، مختتماً باقتراح استغلال الدرس اللغوي في استنباط دلالات فكرية حضارية من الخطاب الإسلامي، وإعادة تحديد مجالات التفسير اللغوي للنصوص الدينية لخدمة الفكر الإسلامي المعاصر، مع الحرص على الموضوعية وطلب الصواب.
——————–

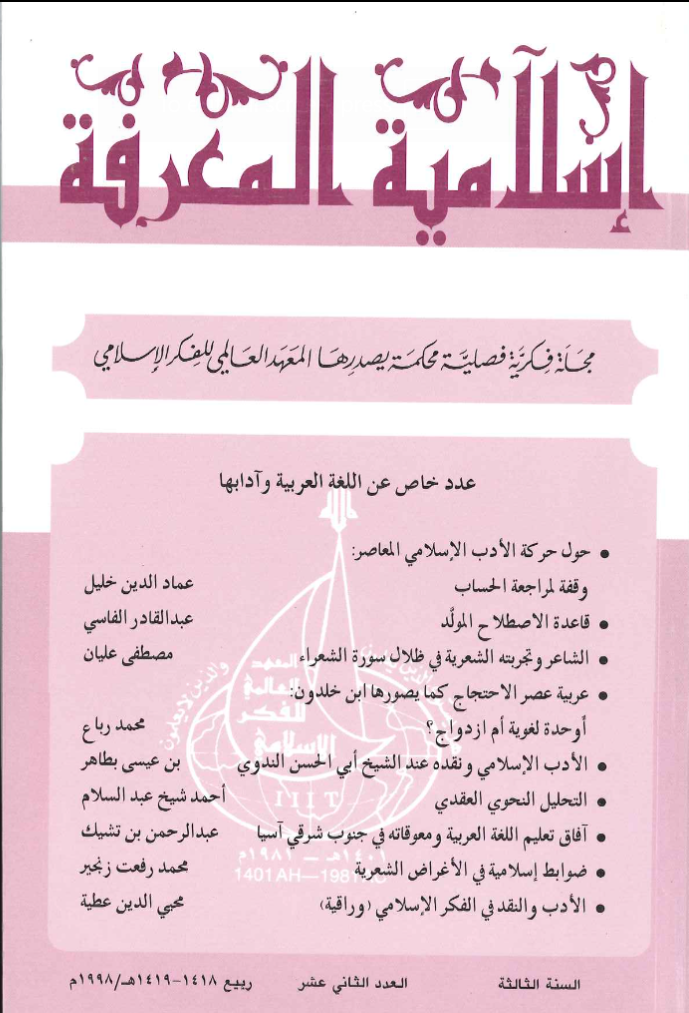
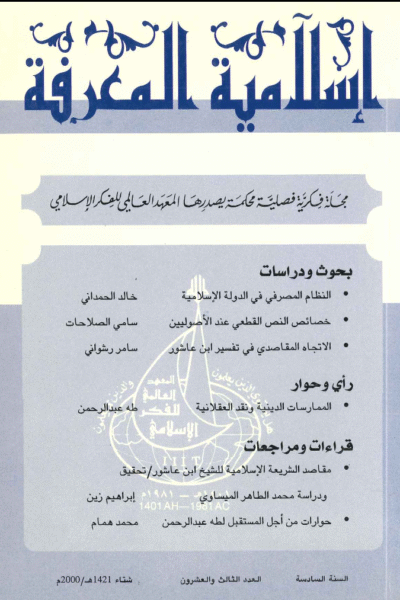
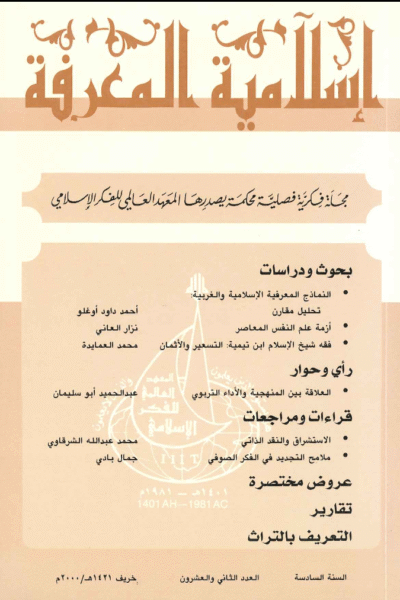
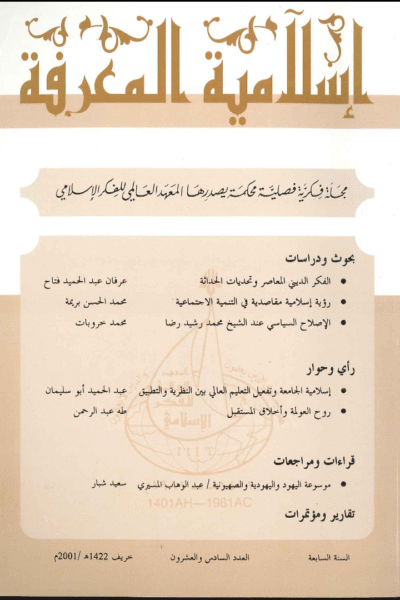
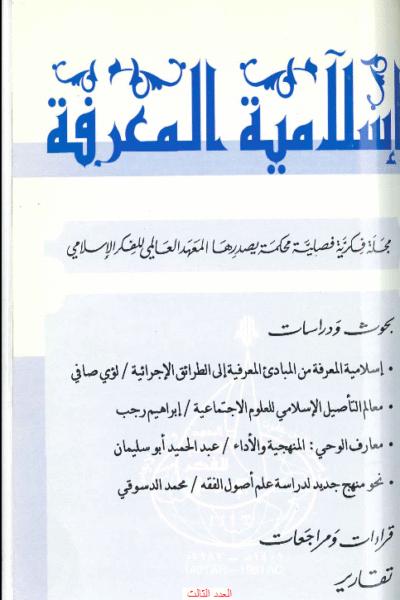
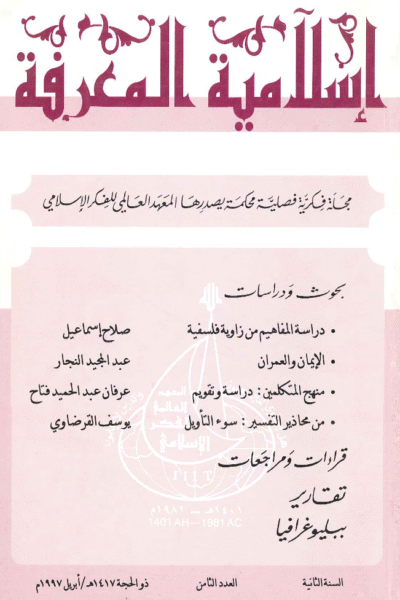
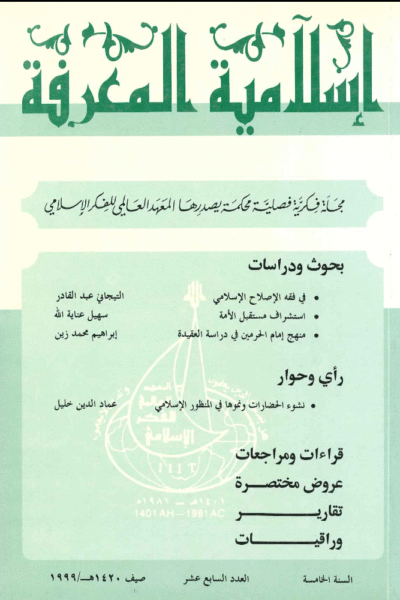
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.