الوصف
كلمة التحرير
===========
تواصل المجلة بهذا العدد مسيرتها، حاملة مسئوليتها تجاه العقل المسلم، تقدم له زاداً ينير بصيرته، ويستثير قدراته، ويفتح أمامه آفاقاً جديدة للنظر والاجتهاد.
لقد استهل طه جابر العلواني قسم البحوث والدراسات بمدخله إلى فقه الأقليات، فانتقل بذلك من مرحلة الدعوة لإبراز فقه جديد يعني بالأقليات المسلمة في هذا الزمان إلى مرحلة وضع النظرات التأسيسية لهذا المجال المعرفي الجديد، فبعد أن أنفق السنوات الطوال يدعو إلى الاهتمام بهذا الفقه النوعي الذي يربط الحكم الشرعي بظروف الجماعة وبالمكان الذي تعيش فيه، إذا به يضع – بهذا المدخل – اللبنة الأولى في البناء، طارحاً العديد من القواعد والقضايا والأسئلة، مخترقاً ما ألفناه في الفقه التقليدي من تصنيفات وتسميات للعلوم الشرعية والاجتماعية على السواء. إن الناظر إلى تاريخ العلوم وتطويرها، يلحظ مشقة أن يُستحدث فيها تصنيف جديد، وعسر عملية انفصال الوليد عن الجسم الأم، لكنه يلحظ أيضاً كم أضاءت المبادرات الأولى – رغم المعاناة – طرقاً أمام الأجيال اللاحقة من العلماء، ومهدت سبلاً لتطوير المعرفة، وقدمت الدليل تلو الآخر على أن هذا الدين الخاتم فيه صلاح كل زمان ومكان.
ثم يقدم لنا مصطفى منجود دراسته عن القيم والنظام المعرفي في الفكر السياسي، مقارناً فيها بين الغزالي وميكيافيللي، منطلقاً من أن العلاقة بين القيم وبين النظام المعرفي علاقة إيجابية عند كل منهما، وأن هناك أوجهاً للإتفاق وأخرى للاختلاف بينهما في تناول أبعاد هذه العلاقة، وأن أعمال الغزالي تمثل إضافة وامتداداً لمساهمات الفكر السياسي الإسلامي بينما تمثل أعمال ميكيافيللي إضافة وامتداداً للفكر السياسي الغربي. وقد برر اختياره لهذين المفكرين بوجه خاص، ثم شرع في استعراض وتحليل مواقفهما الفكرية من مفهوم القيم، ومن النظام المعرفي، ومن المقومات القيمية لهذا النظام، ومن الدور القيمي لبعض مؤسساته، منتهيا إلى أن النظامين المعرفيين الإسلامي والغربي قد يتلاقيان في بعض مقوماتهما ومقاصدهما، لكنهما بعيدان عن التلاقي المطلق، على أن ذلك لا يمنع من إمكان التعايش بينهما باستثمار بوادر الاتفاق وتحجيم الآثار السلبية لبوادر الشقاق …
بحوث ودراسات
==============
يبدأ الباحث بتحديد معاني مصطلحيْ الفقه والأقليات، ويدعو إلى تفكيك السؤال لمعرفة خلفية السائل والسؤال، مشيراً إلى ضرورة الاجتهاد، وتجاوز الفقه الموروث لأسباب منهجية، وأخرى ذات صلة بتحقيق المناط. ثم يقترح المحددات المنهجية والأصول التي يعتمدها في مجال فقه الأقليات، ثم يطرح الأسئلة الكبرى التي يثيرها الموضوع قبل أن يضع قاعدة في علاقة المسلمين بغيرهم. ثم يبين خصيصتين لأمة التوحيد هما الخيرية والإخراج، وخصيصتين لعباد الله المؤمنين هما الانتصار لحقوقهم والإيجابية، ضارباً مثالاً من هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة.
يتناول الباحث مفهومي القيم، والنظام المعرفي. ثم يتحدث عن المقومات القيمية للنظـام المعرفي عند الغزالي، ومكيافيللي، ثم القيمة العليا في المنظومة القيمية عندهما، والدور القيمي لبعض مؤسسات النظام المعرفي لديهما. مختتماً بالتأكيد على أن الأصول الفكرية والواقع الحضاري لأي منهما قد حددا إسهامه في مفاهيم القيم، والنظام المعرفي والفكر السياسي، وأنهما قد لا يتلاقيان بشكل مطلق، إلا أن التعايش بينهما ممكن إذا استثمرنا بوادر الاتفاق، وحجّمنا الآثار السلبية للشقاق. وداعياً المخلصين للنظام المعرفي الإسلامي إعادة اكتشاف ذاته، وبنيته، وتكوينه، ومقاصده، ووسائطه، لإعادة أداء رسالته الحضارية.
الملخص
يبين الباحث – بعد المقدمة – المفاسد المترتبة على تأجير الأرحام في الغرب، ويعرض آراء العلماء في صور الرحم البديلة، ما بين متفق ومختلف على تحريمها. ثم يشرح أهمية نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر، ويعرض خلاف الباحثين حول معرفة مَن الأم الحقيقية ومَن الأم الرضاعية، وحول نسب المولود من ناحية الأب. مختتماً باقتراح تشريع قانون من قبل الدول الإسلامية التي تحرص أن تكون قوانينها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، لأجل تنظيم مسألة الأم البديلة، حتى يتضح الأمر لمن يقدم على هذا الحل، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته. وفضاً للنزاع المحتمل في المستقبل، بين مختلف الأطراف.
===================
قد يكون الإلحاح في التنظير مضللاً في بعض الحلقات المعرفية، وقد ينشئ “تقاليد” تزداد بمرور الوقت شيوعاً، فيجد الباحثون أنفسهم ملزمين بأن يقولوا كلمتهم أو “وجهة نظرهم” في مسألة قد لا تحتاج إلى كبير عناء للتأشير على صيغ التعامل معها.
وهذا ما حدث بالنسبة إلى الموروث المعرفي الذي خلفته الأمة الإسلامية عبر التاريخ والذي أصبح -للسبب المذكور- حقلاً مفتوحاً لتجارب اليمين والوسط واليسار، إذا صح التعبير، ومورست إزاءه صيغ الانتقاء حيناً، والأحكام (الأيديولوجية) المسبقة حيناً آخر، والتنظيرات الشمولية التي قد ترتطم ببعض حلقاته، حيناً ثالثاً، وكانت النتيجة في كل الأحوال سيلاً من البحوث والمؤلفات التي تنطوي -بالتأكيد- على كشوف واستنتاجات في غاية الأهمية، ولكنها تتضمن في الوقت نفسه مواقف ومرئيات قد لا تصمد طويلاً بإحالتها على التيار العام للتراث الإسلامي، وخصائصه الأساسية، ومنظومة الأفكار التي تمحور حولها عبر القرون.
وعلى سبيل المثال فإن تنظير “الجابري” المعررف بخصوص ثلاثية العقيدة والقبيلة والغنيمة التي تفسر تراث الإسلام، قد لا يكون مقنعاً، وهو يذكرنا بمقولة الكاتب المجري آرثركوستلر من أن الفكرة التي تستطيع تفسير كل شيء، فإنها في نهاية الأمر لا تكاد تفسر شيئاً، كما يذكرنا بتعليق الفيلسوف الإيطالي بنيدتو كروتشه على (مثالية) هيغل من أن فكرة هيغل عن الحياة كانت فلسفية بحيث إن النزعتين المحافظة والثورية تجد فيها ما يبررها. وفي هذه النقطة يتفق انغلز الاشتراكي والمؤرخ المحافظ ترايتشه لأن كليهما يرى أن تماثل المعقول والحقيقي يمكن أن يدعي إليه بصورة متساوية في كل الآراء السياسية والأحزاب التي تختلف عن بعضها، لا من ناحية هذه الصيغة المشتركة، بل في تعيين ما هو المعقول والحقيقي، وما هو غير المعقول وغير الحقيقي!!! ومن ثَمَّ اتهام خصمه بأنه مخالف للمعقول، أي أنه ليس له وجود ملموس وحقيقي، ويكون بهذا الادعاء قد وضع نفسه مع الفلسفة في خط واحد!!!
إن الوقائع التاريخية -إذا أردنا الحق- تستعصي على القياس، وتتأبى على المسطرة، ولقد مارس الكثيرون هذا الأسلوب فأخفقوا، لأن منظوماتهم المهندسة باتقان اخترقت في أكثر من مكان، وليست تنظيرات الماركسية عنا ببعيدة. إننا نتذكر هنا …
قراءات ومراجعات
===================
يواصل أركون في كتابه الجديد توضيح ملامح مشروعه في “نقد العقل الإسلامي” الذي كان قد قدمه لأول مرة عام 1984م، والذي يهدف من ورائه إلى إعادة تقييم نقدي شامل لكل الموروث الإسلامي منذ ظهور القرآن حتى اليوم مميزًا فيه بين أربع مراحل رئيسية:
– مرحلة القرآن والتشكيل الأول للفكر الإسلامي.
– مرحلة العصر الكلاسيكي، الذي يدعوه بعصر العقلانية والازدهار العلمي والحضاري.
– مرحلة العمر السكولاستيكي (المدرسي) التكراري الاجتراري، أو ما يدعى بعصر الانحطاط.
– مرحلة النهضة في القرن التاسع عشر حتى الخمسينات من هذا القرن.
ويرو أنه ينبغي أن نضيف مرحلة خامسة يدعوها بـ”الثورة القومية” (عبد الناصر 1952-1970) فـ “الثورة الإسلامية” (1979 حتى اليوم).
غير أنه لا نخرج بعد قراءة الكتاب على مشروع متبلور، واضح الملامح والقسمات، وإنما – كما هي عادة أركون فى كتبه الأخرى – نجد الكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات نشرت سابقًا وبعضها لم ينشر، رأى مؤلفها أن يضمها بين دفتي …
عروض مختصرة
===================

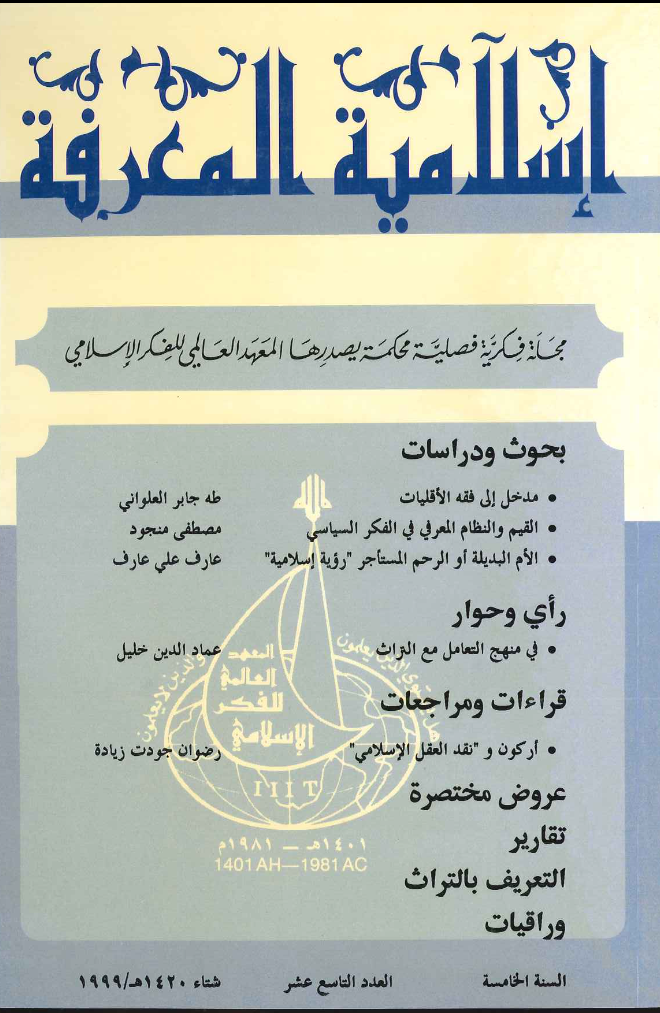
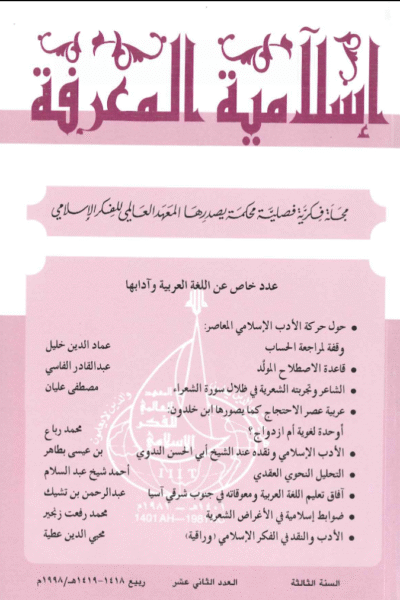
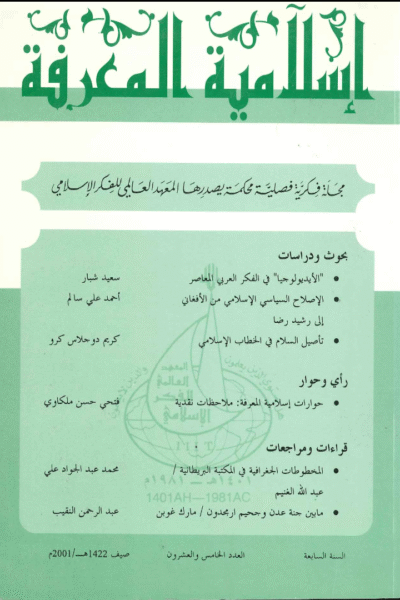
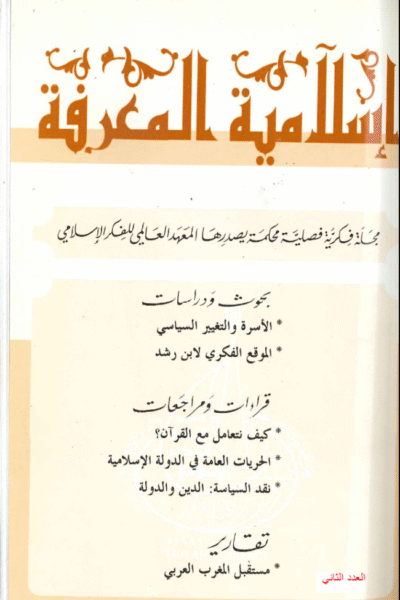
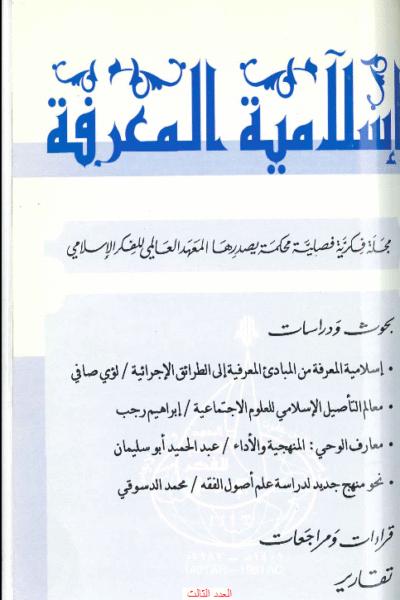
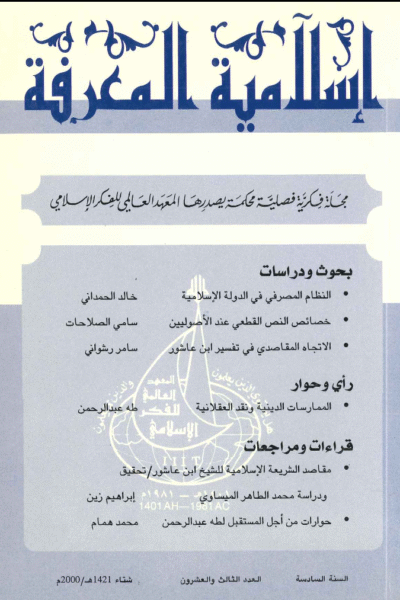
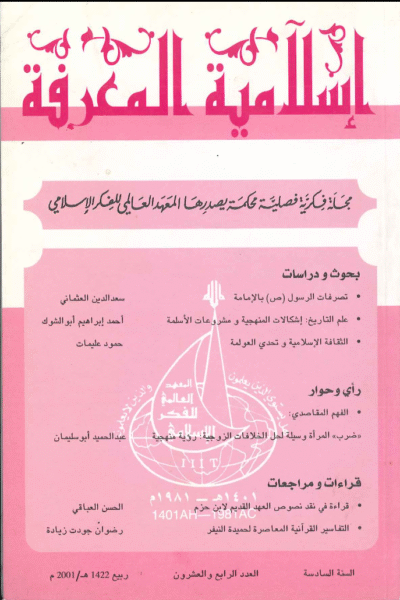
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.