الوصف
كلمة التحرير
===========
تسود لغة النخب العربية والإسلامية –هذه الأيام، وفي ميادين الفكر والثقافة- مفردات وعبارات تحلِّي عناوين البحوث والمقالات والمناهج البحثية. ومن أهم هذه المفردات لفظة “المعرفة” وما يتعلق بها من “قضايا معرفية” و”مناهج معرفية” و”تحليل معرفي” و”رؤية معرفية” وأمثالها. ويبدو أن لفظ المعرفة ومشتقاته ومرادفاته قد اكتسب موقع التقدير في سائر اللغات البشرية، منذ وقت مبكر من التاريخ. وعندما أصبحت الفلسفة صنعة الفئة المختارة المتميزة من العلماء والحكماء بقيت “نظرية المعرفة” في قلب التفكير والممارسة الفلسفية.
وفي اللغة يرد الفعل عرف يعرف عرفاناً ومعرفة، ومنه العَرف والعُرف والمعرفة والتعارف، ويفيد ذلك ما يدركه الإنسان ويثبت معناه في نفسه بصورة تطمئن به وتسكن إليه. وما لا يتم إدراكه ولا يثبت في النفس فإنها تنكره وتتوحش منه،، وتنبو عنه. فالمعرفة حالة نفسية يجدها الإنسان من نفسه حين يحصل الإدراك، وهي بالتالي فعل عقلي ينتج عن تفاعل الذات العارفة بالموضوع المعروف.
ورغم ما ذهب إليه كثير من القدماء والمحدثين من المسلمين وغيرهم، من تمييز بين معنى المعرفة ومعنى العلم، فإن هين المفهومين يتفقـان في المعنـى العـام. فقـد فسَّر أهل اللغـة المعرفة بالعلم والعلم بالمعرفة، كما أكدّ ذلك ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، حين بيّن أن العلم والمعرفة اسمان يقعان على معنى واحد. وإن فرّقوا بينهما فقد أبقوا على المعنى العام المشترك، وجعلوا أحد اللفظين أخصّ من الآخر، كما فعل الحسن العسكري في “الفروق اللغوية” حيث جعل المعرفة أخصّ من العلم؛ فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة؛ أي أن العلم أشمل من المعرفة باعتبار أن العلم صفة الله سبحانه وللإنسان، أما المعرفة فهي صفة للإنسان فحسب، فيقال: الله عالم، ولا يقال: الله عارف. وهكذا فإن المعنى المشترك بين العلم والمعرفة أنهما ميزة مشتركة ميزة مشتركة أساسية للإنسان تتضمن علاقة بين العالم والمعلوم، أو بين الذات العارفة وبين الموضوع …
بحوث ودراسات
==============
يتناول البحث المعنى اللغوي والاصطلاحي للصيرفة، والتطور التاريخي لأنواعها في الدولة الإسلامية، والمهام التي تكفل بها الصيارفة، كما تناول اهتمام مسؤولي الدولة الإسلامية بالصيرفة وأثر ذلك في استقرار النشاط الاقتصادي وازدهاره. وأشار إلى أنها قريبة الشبه بالمصارف الحديثة، إذ كانوا يقومون بتحويل العملات، وصرف الصكوك، والسفاتج، وتقويم النقود، وقبول الودائع، وغيرها من المعاملات كالمراطلة، والمبادلة، والصرف، وكانت هناك مصارف رسمية وأخرى خاصة، إلا أنهم لم يكونوا يتعاملون بالربا، كما كانت هناك رقابة إدارية صارمة للحيلولة دون ارتكاب مخالفات شرعية في التعامل المصرفي.
بعد تعريف النص القطعي لغةً واصطلاحـاً، يشرح البـاحث اثنتي عشرة خصيصة بيانها: 1- ندرة النص القطعي في الأحكام الشرعية 2- النص القطعي هو مراد الشارع 3- تعاليه عن ظرفية الزمان والمكان 4- مرونته تتناسب مع ثباته وتعاليه 5- شموله لجميع مفرداته وجزئياته 6- تضمنه المصلحة 7- منكر النص القطعي كافر البتة 8- عدم قبوله التأويل مطلقاً 9- مرتبته واحدة من حيث المصدر 10- لا يوجد تعارض أو تضاد بين النصوص القطعية 11- النص القطعي يتحقق في الأصول والفروع معاً 12- لا يلزم من تطبيق النص القطعي القطع.
الملخص
بعد تعريف “الاتجاه التفسيري” وبعد التعريف بتفسير “التحرير والتنوير” يتناول الباحث في الجزء الأول من بحثه الاتجاه المقاصدي في تفسير ابن عاشور على المستوى النظري، فيتحدث عن النزعة النقدية والتجديدية، وعن طبيعة الاتجاه المقاصدي ويميز بينه وبين الاتجاه الهدائي. ثم ينتقل في الجزء الثاني إلى المستوى التطبيقي، فيتحدث عن تقصيد النصوص، والأحكام ضاربا أمثلة برخصة التيمم، وبقيام الكعبة، كما يتحدث عن الاستدلال على الدلالات والأحكام الشرعية. ويتناول في الجزء الثالث ملامح منهج ابن عاشور في تفسيره، ويختتم بخلاصة تبين النتائج الرئيسة لبحثه.
رأي وحوار
===================
كثر الخوض في موضوع (العقلانية)، حتى تواردت عليه ضروب من الشبهة والإشكال، وتطرقت إليه صنوف من الخلل والفساد، هذه الضروب والصنوف التي نحتاج إلى استجلاء أوصافها، وبيان أسبابها وتحديد آثارها، حتى نحترز من الوقوع فيها، ونتخير طريقاً سليماً في العقلانية كون موافقاً للممارسة الدينية الإسلامية.
ننطل في هذا العرض التقويمي للعقلانية من واقع الاشتغال بها، فنقول بأن من يتأمل هذا الواقع يتبين فيه الحقائق الثلاث الآتية:
الأولى: الدعوة إلى التزام العقلانية، فإن كل من تولّى النظر في وسائل النهوض بواقع العالم الإسلامي والعربي، لم يتردد في أن ينصبّ العقلانية مثالاً لوسائل النهضة، وإماماً للناس يُهتدى به، كما لم يتردد في أن يدخل في الإشادة بفضائل المناهج العقلية وفوائدها في تحصيل المطلوب من التقدم والتحضر.
الثانية: تعار المبادئ العقدية للداعين إلى العقلانية، فإن التعلق بالعقلانية تساوى فيه من تُوَجِّهُهُ مبادئ الدين الإسلامي، ومن يميل عن هذا الدين مبتغياً العمل بمبادئ أخرى، أو من ينزل بمنزلة بين هذين الطرفين منتقياً بعض المبادئ مـن الديـن الإسلامـي. والبعـض الآخـر مـن مذاهب غير إسلامية أو غير دينية، بحجة مسايرة التطور والاستجابة لمقتضى التغيير.
الثالثة: امتداد الدعوة إلى العقلانية، فإن هذه الدعوة إلى العقلانية التي تلوي بها مختلف الفئات الإسلامية والعربية ألسنتها، تزايدت في الشدة والانتشار على مدى فترة استغرقت قرناً ونصف القرن من الزمن، وامتدت من منتصف القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين.
إن هذه الحقائق الثلاث: “الدعوة إلى التزام العقلانية” و”تعارض المبادئ العقدية للداعين إليها” و”امتداد هذه الدعوة مع مرور الزمن”، كان من شأنها أن تستوقف المفكر الإسلامي، وتحمله على إجراء تمحيص لهذه العقلانية في مختلف مبادئها ومناهجها وقيمها، حتى يتبين مدى وفائها بالأهداف الإصلاحية والتغيرية التي علقت عليها واستعملت لأجلها وحدود هذا الوفاء، لكن ظل هؤلاء المفكرون في غفلة تامة عن ضرورة هذا التمحيص، وأبوا إلا التمادي في التعلّق بالعقلانية، في الاحتجاج بها والاحتكام إليها، لاعتقادهم الراسخ في كمال مبادئها وتجانس مناهجها، وسلامة مآلاتها، حتى إنهم لو فوتحوا في أمر هذا التمحيص، وأشعروا باستعجال الحاجة إليه، لكرهوا الدخول فيه، لما بلغه هذا الاعتقاد من أنفسهم …
قراءات ومراجعات
===================
لاشك أن التعريف بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور ونشر مؤلفاته وبيان موقعه من الحركة العلمية المعاصرة لهو أمر في غاية الأهمية حتى لا تقوم الحركة العلمية بالدوران في حلقة مفرغة تتبدد فيها الجهود ولا يبني الخلف على ما تركه السلف ويعاد “إنتاج العجلة” مرة تلو أخرى دون طائل.وتزداد أهمية هذا الكتاب بسبب المقدمة الرائعة التي خطها الأستاذ محمد الطاهر الميساوي محاولاً التعريف- قدر الإمكان- بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور وبيان موقع كتابه من حركة الإصلاح التي قادها في شأن إصلاح مؤسسة التعليم الإسلامي في تونس. وقد سعى الميساوي إلى إثبات الصلة بين كتاب المقاصد وكتاب أليس الصبح بقريب، وكيف أن هموم الإصلاح التي تشوَّف ابن عاشور لإنجازهـا في بداية حياته العلمية قد انعكست بصورة إيجابية في كتاب مقاصد الشريعة كثمرة من ثمار ذلك الغرس المبكر.
وقد نجح الميساوي في بيان أن ابن عاشور كان يصدر في همومه وآرائه الإصلاحية عن رؤية تاريخية وحضارية شاملة لمصائر الاجتماع الإسلامي، بما في ذلك العلوم والمعارف (ص 40). ورغم ان هذه دعوى عريضة إلا ان الميساوي –بما تجمع بديه ن خبرة وفهم عميق لأبعاد الإصلاح المؤسسي والعلمي الذي سعى ابن عاشور لإنجازه –استطاع أن يثبت معالم تلك الرؤية، وكيف أنها شكلت نسقاً كاملاً من المفاهيم استخدمها ابن عاشور في نقد العلوم الإسلامية، وطرق توجه الدارسين إليها، وشروط إنتاج المعرفة والعلم وأهمية حرية المباحثة والنقد في هذا الصدد وأولويتها، في تقليل الخلاف، رغم أن الرأي السائد أن قفل الباب أمام حرية المباحثة والنقد والانكفاء على التقليد يؤدي إلى تقليل الخلاف، ولا مرية في أنَّ ها رأي لا يسنده عقل ولا دليل من التجربة الإنسانية. وعلى ذلك فإن آراء ابن عاشور في إصلاح مناهج التعليم وبيان كيفيات إصلاح الخلل في آحاد المعارف والعلوم الإسلامية، مثل علم الكلام والتفسير واللغة والمنطق والفقه وأصوله، لهو إضافة جليلة في طريقة فهم المنطق الداخلي لتلك العلوم والسعي لتجديدها، من خلال نظر كلي مثمر يربطها بهموم عصر المتعاطين لها، لا أن تقرأ بعصر من قاموا بإنتاجها لمواجهة مشكلات وهموم لا وجود لها. وعليه فإن في حركة العلم وتفاعله مع الواقع بوناًَ شاسعاً بين من يجتهد في فهم واقعه ويجد له حلولاً في نصوص الشريعة الخالدة وبين من يقبع في مقايسات عقيمة على حلول لمشكلات لاوجود لها. فالذي يكفر بعقل القرن التاسع أو العاشر الهجري هو في حقيقة الأمر –كما قال ابن عاشور- “عالة عليهم (أي على أهل القرن التاسع أو العاشر) في العلم والعبارة والصورة والاختيار أيضاً” (ص 41). ومن كانت تلك حقيقته لا يرجى منه تطوير …
على سبيل التقديم:
الدكتور طه عبد الرحمن فيلسوف متجدد ومفكر مبدع، يعترف بهذه الحقيقة خصومه من الذين يخالفونه وقد يناصبونه العداء ويحرشون ضده في كتابات ومنتديات عدة، ثم إن كتبه بما توفر لها من العمق والدقة في الفكر، والصياغة والتحليل تقف هي الأخرى شاهد الإثبات على أن بداية القرن الواحد والعشرين، ستشهد امتداد ظل هذا الفيلسوف على جغرافية الفكر الفلسفي المغربي وتاريخه، بعدما أفل نجم الكثيرين ممن سلبوا عقول الشباب المغربي والعربي لمدة نصف قرن أو يزيد إلى حد بعيد، ممن كشف النقد المعرفي الرصين تورطهم في إيديولوجيات مضللة تضخم مفعولها في مشاريعهم على حساب الإبستمولوجيا والعلم والحقيقة، فلم تعذرهم سنن البحث العلمي الدقيق وطوحت بهم في واد سحيق، وفي المقابل سطح نجم الدكتور طه عبد الرحمن بعدما كان محاصراً ومقهوراً من قبل تجار الفكرانيات،لكنه كان يعمل في صمت ويكتب بإحكام، ويوجه الضربات تلو الربات للجدار السميك لفكر الزيف في المغرب الحديث، حتى انهار، فخرج على الناس كاتب من نوع جديد، يعلن بكل قوة وعزة انتماءه إلى هذا الدين القويم، وصياغته لمنهجه في المعرفة والنقد من تراثه المجيد، من غير عقدة أو تهيب، مع إبراز قدرة كبيرة على الاستفادة من معرفة الآخر بعد نقدها وتقويمها، في أصولها وفروعها، ثم إن الدكتور طه يتقن لغات عدة إلى جانب إحكامه المثير للأساليب العربية ودقائقها …

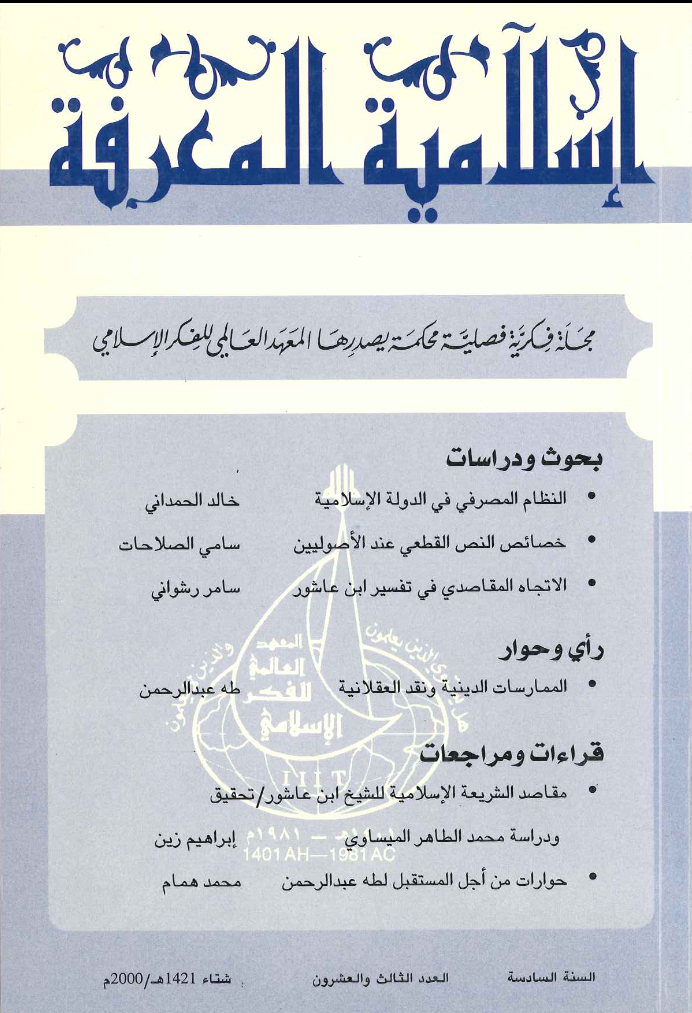
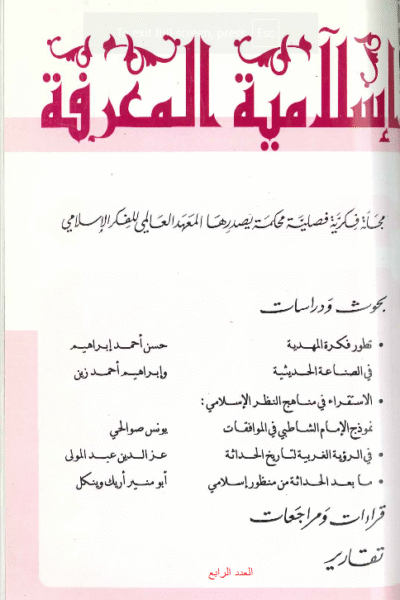
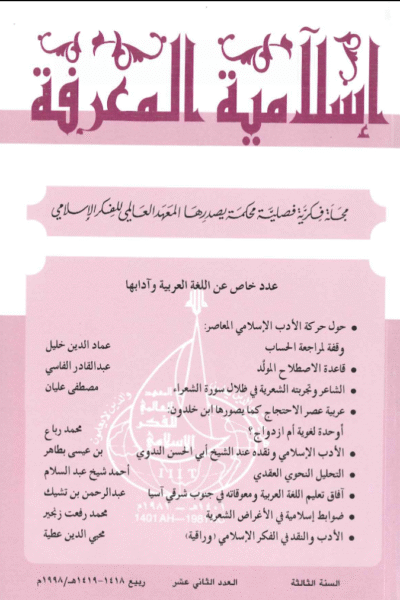
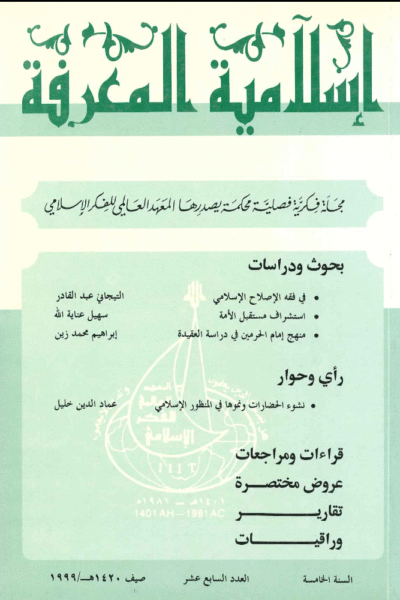
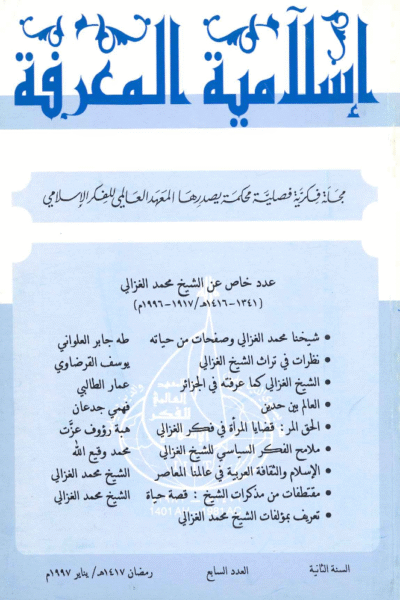
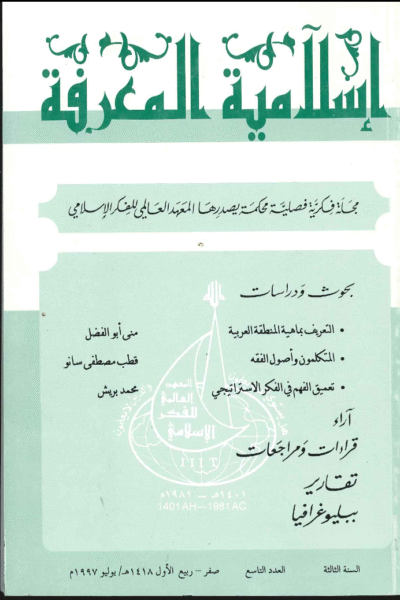
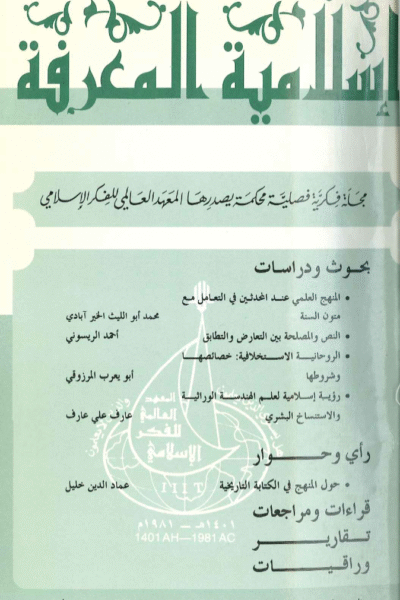
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.