الوصف
كلمة التحرير
===========
تنطلق جهود إسلاميّة المعرفة من تشخيص الأزمة التي عانت الأمّة منها عبر تاريخها ونعاني منها في حاضرها، واعتبار أن هذه الأزمة في حقيقتها هي أزمة فكريّة، وأن سائر الأزمات الأخرى في جوانب حياة الأمّة رغم عمقها وتجذّرها إنما هي نتيجة للأزمة الفكريّة أو مظهر من مظاهرها. فالأزمة الفكريّة هي الأم والعلّة الكبرى. وهذه الأزمة الفكريّة ليست طارئة حديثة العهد، وإنما تعود بعض مظاهرها وبعض عواملها إلى مراحل مبكرة في تاريخ الأمّة تمثلت بعض جوانبها في الخلاف حول قضيّة الإمامة العظمى، وجدل العقل والنّقل والفصام بين القيادة الفكريّة والسياسة، وما نتج عن ذلك كله من مسلسل الإنقسامات والانحرافات.
وكثير من الجهود الفكريّة الّتي رافقت مسيرة الأمّة في تاريخها كانت تستهدف مواجهة هذه القضايا والظروف. وهي جهود تحتاج إلى مراجعة وتقويم وإعادة صياغة بما يخدم قضايا الفكر المعاصر. فقد أصبحت هذه الجهود المتراكمة تراثاً مختلطاً تتفاوت النّظرة إليه فمن يرى أنّه تجربة الأمّة ودينها المقدّس، ومن يرى أنّه تاريخ مضى بأصحابه، فَلِمَ الإلتفات إليه؟ ونحن نلهث وراء أمم معاصرة تحتاج إلى بذل كل الجهود والطاقات وكسب الوقت للحقاق بركبها. لذلك فإن هذه المراجعة تستلزم التمييز بين ما هو دين ووحي يتصف بالعصمة والقداسة وما هو اجتهاد بشري في تتريل قيم الوحي على واقع الحياة وظروفها المتجددة ويتصف باحتمال الخطأ والصّواب.
وفي هذا السياق نستطيع أن نفهم جهود العلماء السنة في جمعها وتدوينها، بدءاً بقرار الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وتطوير الضوابط لحفظها وصيانتها من الوضع والكذب والعبث، وجهود البخاري ومسلم، وجهود علماء التفسير في وضع قوانين الفهم والتأويل والتفسير، وضبط الأدوار المنهجيّة لكل من النص والعقل، وجهود جمع قواعد أصول الفقه وتدوينه، وجهود الإمام الشّافعي والإمام أحمد في التعامل مع مشكلة المنهج، وجهود الأشعري في جمع مقالات الإسلاميين ورصدها وتحليلها وتقديم ملخّص للأركان العقديّة يمكن الاتفاق عليها، وجهود إمام الحرمين الجويني في معالجة قضيّة الإمامة والسياسة،وجهود الغزالي في إحياء علوم الدّين ومجاولته لتقديم نظريّة متكاملة في المعرفة، وجهود ابن رشد في رفع التناقض الموهوم بين الحكمة والشريعة وجهود ابن الحزم في العودة إلى مناهجيّة خير القرون، وجهود ابن تميمة في درء تعارض العقل والنقل، وجهود ابن خلدون في تأسيس معالم العلوم الاجتماعيّة… وغيرها.
ويبدو أن الأمّة لم تبرأ من الإصابات الّتي انتابتها في فكرها وواقعها، ولذلك فقد استمرّت محاولات الإصلاح والتّجديد فبما بعد، وتمثّلت في جهود سلسة من المصلحين وتلاميذهم، ومن ذلك جهود شاه ولي الّله الدلهوي في الهند، وجهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النّجد، والإمام الشوكاني في اليمن. ومن ذلك جهود الآلوسي في العراق، والطباطبائي في إيران والسنوسي في ليبيا، والمهدي في السّودان، ثم جهود الأفغاني ومدرسته، والكواكبي وجمعيّته، وابن باديس، ثم جهود البنا، والمودودي، وسيد قطب، ومالك بن نبي، والنبهانيّ، والغزالي، والندوي، وغيرهم من قادة الحركة الإسلاميّة الحديثة. فمنهم من قضى نحبّه ز منهم من لا يزال ينتظر …
بحوث ودراسات
==============
بدأ الباحث – بعد المقدمة – بتقسيم التصرفات النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية، مدللاً على هذا التمييز بمراجعة الصحابة للرسول r في بعض قراراته، وباقتراحهم رأياً مخالفاً لرأيه فيما شاورهم فيه، وبتأويلهم لبعض تصرفاته على أنها كانت لمصالح مؤقتة، وبمراجعة الخلفاء الراشدين لبعض تصرفاته بعد وفاته. ثم انتقل إلى بيان السمات الأربعة للتصرفات بالإمامة، من تشريعية وتنفيذية واجتهادية وتصرفات في أمور غير دينية. ثم انتقل إلى بيان أهمية التصرفات النبوية بالإمامة ودلالاتها، وبيان منهج التدرج في تنزيل الأحكام، ومراعاة اختلاف أحوال الناس، ومراعاة الأحوال الطارئة. ثم اختتم بمحاولة حل إشكالات في الفقه والحديث تتعلق بالتصرفات النبوية.
يبدأ الباحث بتعريف علم التاريخ بأنه العلم الذي يدرس أحداث الماضي البشري وآثاره دراسة علمية تعتمد على البحث، والتثبت، والتحقق، والملاحظة، والاستدلال، والاستقراء. ثم يبين تطور مناهج البحث التاريخي في التراث الإسلامي، خاصة عند الطبري، وابن مسكويه، والبيروني، وابن خلدون. وينتقل إلى تطور مناهج البحث التاريخي في الغرب الأوروبي، خاصة المدرسة المثالية، والمادية التاريخية، والمدرسة الحضارية، ومدرسة الحوليات الفرنسية، ثم ينتقل إلى دوافع أسلمة علم التاريخ وأطروحاتها، خاصة عند عماد الدين خليل، منتهياً ببيان التفسير الإسلامي للتاريخ بين الأسلمة والتأصيل.
الملخص
يبدأ البحث بمدخل نظري عن الثقافة والثقافة الإسلامية، فيتعرض لبيان المصطلحين. ثم ينتقل إلى مكونات الثقافة المعنوية والمادية. ثم قضايا الثقافة مثل الشخصية والهوية، والاتساق الثقافي. ثم ينتقل إلى بيان طبيعة العولمة ومظاهرها وتحدياتها، كالهيمنة والتجانس المصطنع، وتحدي الذات والهوية، وكشف علل المجتمعات. ثم يختتم بأوجه الاستجابة الواعية على المستويين: الفكري – كالثقة بالنفس، وإبراز عالمية الإسلام وإنسانيته، واستحياء التراث الناهض، وتحديد منهجي للعلاقة مع الغرب، وإدراك التنوع الثقافي – والمستوى العلمي، بوصفه تعميقاً للعمل الاجتماعي وتأصيلاته، والإسهام الإيجابي في مسيرة الحضارة الإنسانية، والعمل المشترك مع قوى الخير في العالم.
رأي وحوار
===================
يواجه النافحون عن الإسلام والمدافعون عن حقوق الإنسان فيه حيرة في قضية حق الزوج ضرب زوجه الناشز النفور المستعصية عليه، واتخاذ هذا الضرب وسيلة من وسلئل حلّ النزاع بينهما، ولا تخفى أسباب تلك الحيرة ودواعيها في عالم اليوم إذا استصحبنا ظروف الأمة اليوم والعالم من حولها، وتردي حقوق الإنسان فيها، والهجمة الثقافية والحضارية الضارية عليها.
رغم أنني جوبهت بالعديد من الشبهات عن الإسلام حين كنت على مقاعد الدراسة، وخاصة في مرحلة الدراسات العليا في البلاد الغربية، وأثناء العمل الإسلامي الشبابي من خلال نشاطات “اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا”، و”الندوة العالمية للشباب الإسلامي”، إلا أنني كنت دائماً، ولأسباب فكرية منهجية، أجد الحل المقتع والفهم المرضي لأي شبهة من الشبهات وذلك لأنني أوقن منذ نعومة أظافري بصدق الرسالة المحمدة، يقيناً
قائماً على فكر وعلى رؤيةٍ تستند إلى أسس عقلية منهجية مبدئية، وبذلك لم يعد لدي مشكلة مما يعني أن الفكر عندي واضح، ولكنه قد يواجه بعض المشكلات التي تحتاج إلى الصبر والمثابرة في البحث والنظر، فالفكر واضح لا يعتريه “شك” زلكن قد تواجهه “إشكالات” وفرق بين “شك” و”إشكال”، فالشك عائق ومثبط أما الإشكال فمحفز ومنشط وداع إلى الفكر والعمل والبحث والتنقيب والاجتهاد، ولذلك كنت – ولا أزال – كلما أثيرت أمامي شبهة عن الإسلام أرى أنها إشكال لا شكّ فانصرف إلى التأمل والبحث معتمداً منهج المعرفة الإسلامية الأصيل في الشمول المنهجي بين تكامل آيات الوحي وآيلت الكون ومبادئ العقل فبدون معرفة موضوع الإشكال وما ينطوي عليه من سنن وحال لا يمكن فهم دلالات الوحي وهدايته. ولذلك فإن منهجي في النظر أن أتوجه أولا إلى موضوع الخلاف وأتبين طبيعته الموضوعية وما يتعلق من السنن والطبائع التي أودعها اللّه فيه، وما تحيط به من الظروف الزمانية والمكانية، حتى يمكنني فهم دلالة آيات الوحي ومقاصده وأهدافه بشأن موضوع الخلاف أو الشبهة، لأن من يبدأالنظر إلى في الأحكام أولاً كثيراً ما يكون مقلداً تحول دون رؤيته الشمولية للواقع والطبائع وعلاقتها بالشريعة كوابح ثقافة التقليد والمتابعة المصحوبة بعوامل الخوف والرهبة من الخوض في مجالات القدسية، والتي كثيراً ما يصحبها ويعمقها أيضاً الجهل بالداسات الاجتماعية المتعلقة بالواقع والطبائع، ولم يخب ظني قط في جدوى هذا المنهج الشمولي لأنتهي بواستطه إلى فهم مُرْض مُقْنع لا ينتكر من مبادىء الشريعة وقيم الأخلاق والكرامة الإنسانية. …
قراءات ومراجعات
===================
لقد كان للنصوص المقدسة أكبر الأثر في توجيه الجماعات البشرية بغض النظر عن مصدر هذه النصوص سواء أكان الهياً أم بشرياً.
والمتأمل في تاريخ الشعب اليهودي في نشاطاته التي جاءت بعد السبي البابلي خاصة؛ يجد أن أغلبها إن – لم تكن كلها – كانت مؤطرة بالنص المقدس، سواء نص العهد القديم أو نص التلمود في مرحاة لاحقة، وبتعبير أكثر دقة يمكن القول أنه كان شديد الحرص على تأصيل سلوكياته تجاه الآخرين؛ تلك السلوكيات التي كان العداء والاحتقار للآخر سمتها الأساسية، وما ذلك إلا ليضفي عليها نوعا من المشروعية. غير أن الحديث عن هذا المستوى من المشروعية يدفعنا لمساءلة النصوص المعتمدة في عملية التأصيل هذه، لنقف على مدى قداستها. تلك القداسة التي تحدد وفقا لقداسة المصدر من جهة، وصحة المضمون من جهة ثانية، الشيء الذي لا يمكن الإجابة عنه إلا اذا أخضعناها – كما كان حال المحدثين مع النصوص الحديثية – الى دراسة نقدية على مستوى السند والمتن.
ومع انه قد اضطلع بهذه المهمة العديد نم العلماء ومن ملل شتى، تبقى دراسة الإمام الجليل أبو محمد علي بن الحزم الظاهري أمتنها على الاطلاق وذلك ف كتابيه “الفصل في الملل و الأهواء والنحل” و”الرد على ابن النغريلة اليهودي”، والكتاب الأول قد جعل من الإمام ابن حزم المؤسس الحقيقي لعلم مقارنة الأديان كما شهد له بذلك أعداءه[2] قبل محبيه، حيث عرض فيه جملة من العقائد عرضا نقديا وناقشها نقاشا متينا –وإن كان مصحوبا بالكثير من السب والشتم- ومن ذلك مناقشته لنصوص العهد القديم التي اتسمت الى جانب عنفها بإحاطة كبيرة بالموضوع سندا ومتنا.
وإن المطّلع عى ما كتب بعد ابن حزم ليقرر وبكل طمأنينة أن الذين جاءوا بعده كانوا عالة عليه، أو أقل تقدير ساوروا على نفس الدرب الذي سار عليه، فاقتفوا خطواته واتبعوا منهجه في التعامل مع النص. ولم يكن هذا مقتصرا على علماء المسلمين، بل تجاوزهم الى …
يحاول احميدة النيفر في هذا الكتاب (الإنسان والقرآن وجهاً لوجه) أن يقدم قراءة منهج التفاسير المعاصرة معتبراً أن العناية بالتفسير لم تفتر طيلة العصر الحديث، وأن وتيرة صدورها يظل أمرا لافتا للنظر؛ إذ أنها تشهد فترة استقرار نسبي ثم لا تلبث أن تعرف فترة تسارع كبير وغزارة غير معهودة، وأن فترات الذروة هذه تبدو متزامنة أو تالية لأزمات مجتمعية ومؤسساتية بالغة الحدة. يؤكد المؤلف أن التفاسير القرآنية المعاصرة لم تعد حكراً على خريجي المؤسسات الدينية الرسمية بل أسهم متخصصون من مختلف المجالات المعرفية وأدلوا بدلوهم في الدراسات القرآنية، كما نجد في (تفسير الجواهر) لطنطاوي جوهري و(في ظلال القرآن) لسيد القطب و(مفهوم النص) لنصر حامد أو زيد، وهذا ما جعل مؤلف هذا الكتاب يلاحظ أن النص القرآني احتفظ بمكانة مرجعية في المنظومة الثقافية العربية، غلى الرغم من طبيعة التحولات التي عرفتها المجتمعات في علاقتها بالمقدس طيلة الفترة الحديثة. وهو لذلك يرى أن دراسة التفاسير أو الدراسات القرآنية المعاصرة تكشف عن مدى تغير مكانة وطبيعة الوعي الذي يراد منه، ذلك أنها تكشف عن علاقة الإنسان بالنص المقدس وتسبر غور الوعي العربي في علاقته مع القيم والمبادىء التي يريد أن يظهر ها العالم.
يبدو الكتاب من قراءة مقدمته طموحاً في تقديم رؤية كلية لعلاقة النص مع الإنسان والعصر، عن طريق دراسة العلاقة الجدلية بينهما كما تجسدت في أطروحات المفسرين المعاصرين أو متخصصي الدراسات القرآنية الحديثة، إلا أن هذا الطموح لا يلبث أن يتلاشى عند الاطلاع على حجم الكتاب وتصديه لموضوع بهذا الحجم مما فرض على الكاتب اختزالاً حاداً في كثير من الأحيان منع الفكة من ظهورها السو وفرض عليها تشويهاً ازداد مع ازدياد حجم التفسير أو الكتاب الذي يتعامل معه.
طرح المؤلف بداية المنهج على اعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية في التعامل مع النص، إذ بدونها يبقى النص غائماً ويبقى تناوله عائماً، لذلك فهو يرى أن المنهج يمثل جملة المفاهيم الأساسية التي توطر النص من حيث طبيعته وحركته ووظيفته، ووفقاً لذلك يتعرض لنماذج أربعة من التفاسير من جهات مختلفة من العالم الإسلامي كتفسير (روح المعاني) للآلوسي، و(فتح البيان) للقنوجي، و(بيان السعادة ومقامات العبادة) للبيرختي، و(هميان الزاد الى دار المعاد) لمحمد بن يوسف اطفيش، معتبرا أن الاكتفاء بعلم التفسير على هذه النماذج الأربعة الحديثة التي صدرت في القرنين التاسع عشر والعشرين تظهر وكأن علم التفسير قد (احترق) وأن سمة المعاصرة تبدو مستحيلة عليه، وهنا يؤكد المؤلف أن سمة المعاصرة لا تستمد من الزمن التاريخي وإنما تخص العدة المعرفية التي يوظفها الباحث أو المفسّر في تعامله مع النص، وهو لذلك يرى أن المعرفية التي يوظفها الباحث أو المفسر في تعامله مع النص، وهو لذلك يرى أن الناحية اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية والفقهية والمذهبية قد استنفدها المفسرون القدامى، بحيث أن الابتكار في هذه النواحي يبقى هزيلاً، في حين أن …

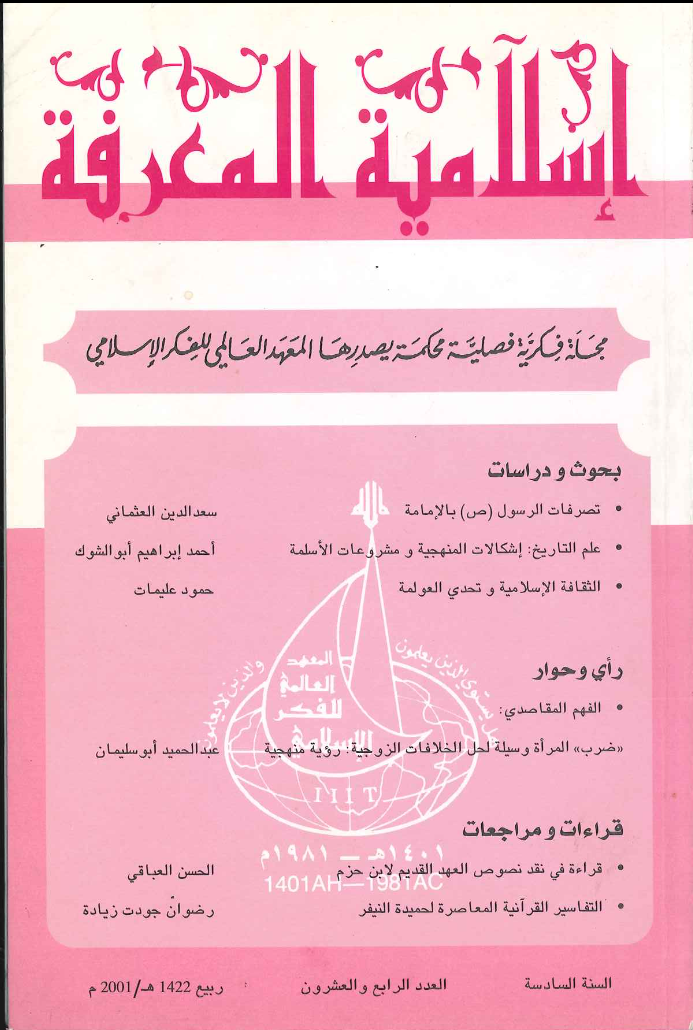
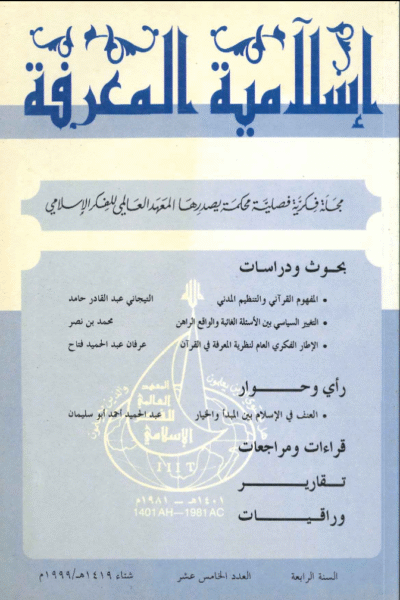
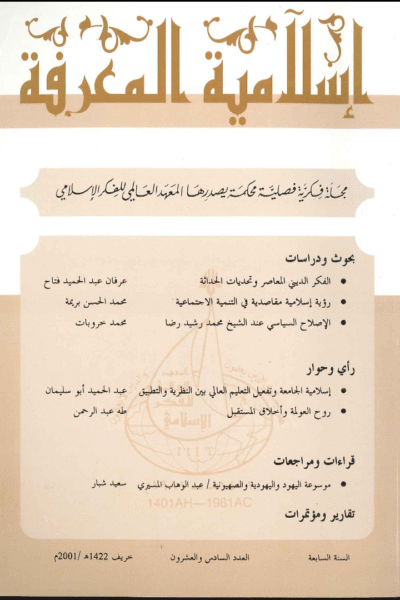
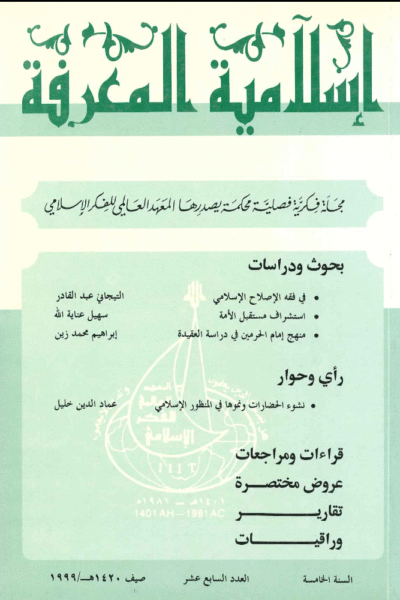
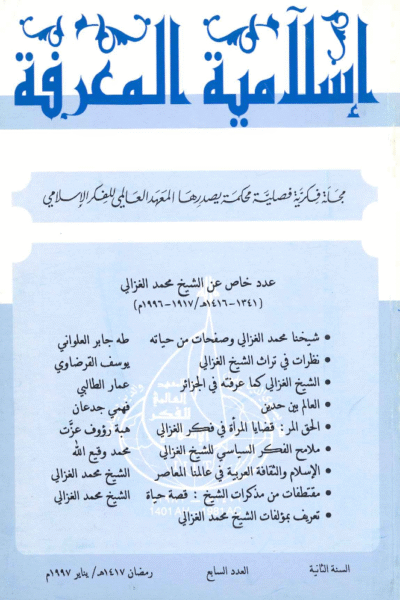
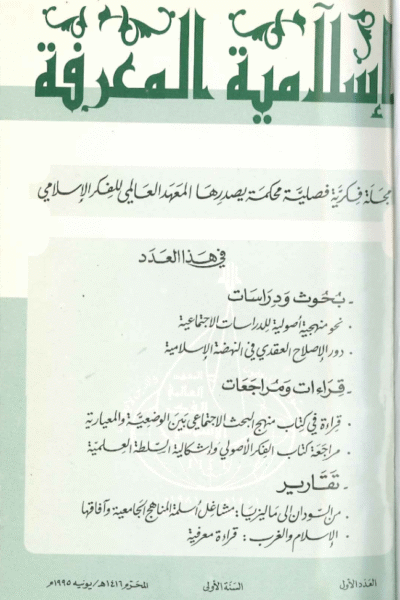
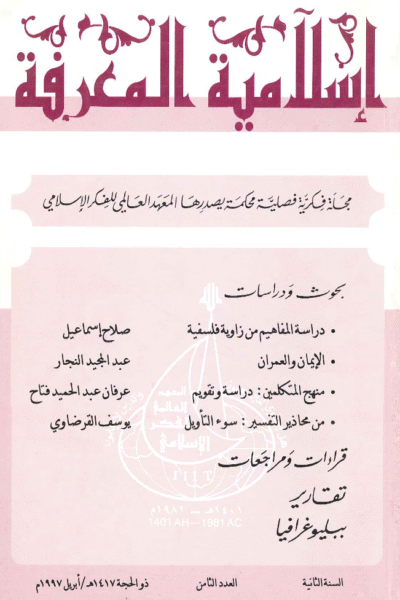
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.