الوصف
كلمة التحرير
===========
تاريخ المعرفة كما يراه ابن خلدون جزء أساسي من تاريخ المجتمع البشري. والتاريخ عنده علم من علوم الفلسفة وهو من “الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال.. إذ هو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول.. وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليلٌ للكائنات ومباديها دقيقٌ، وعلمٌ بكيفيات الوقائع وأسبابها عميقٌ، فهو لذلك أصلٌ في الحكمة عريقٌ وجدير بأن يُعدّ في علومها وخليقٌ..” ثم يبين أنّ التاريخ لمّا كان في حقيقته خبراً عن الاجتماع الإنساني، الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران، فإن واجب المؤرخين أن يستوفوا خبر الشعوب والأمم حتى تنقل تجاربهم، ولكن الحال ليس كذلك وقد يكون لهم عذر، “لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا، فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل.. فأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأين علوم القبط ومن قبلهم؟ وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم اليونان خاصة، لِكَلَفِ المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها، ولم نقف على شيء من علوم غيرهم..”.
إن تاريخ المعرفة لا ينفصل عن المعرفة نفسها، والتحليل النقدي الذي يريده ابن خلدون لحركة المعرفة في أي ميدان من ميادينها هو فلسفة ذلك الميدان المعرفي. كذلك فإن هذا التحليل النقدي لا يكون ذا معنى دون النظر في المسيرة التاريخية للمعرفة …
بحوث ودراسات
==============
استهل الباحث مقاله بمقدمة عن أهمية الموضوع، ثم بيّن عناصر الاستحسان بوصفه مصدراً أصوليا في الأعمال الفقهية المعاصرة، واستعرض علاقة الاستحسان بالاستصلاح، مقدماً بعض الأمثلة المعاصرة، كقضايا البنوك، وإصلاح التعليم، والوقف لأغراض الدعوة، ومظاهر التضامن الاجتماعي، وتوحيد التسعيرة في وسائل النقل، ومجانية التعليم، والخدمات الصحية المجانية، لكي يثبت أن التكامل الاجتماعي أصل مستقل في الشريعة الإسلامية. كما بيّن أن هناك فروعاً فقهية اندرجت تحت هذا الأصل، ولا مساغ لإلحاقها بالاستحسان؛ لأن إلحاقها به في الماضي خلق شبهات حول الشريعة الإسلامية، وعلينا ألا ننتهج ذلك في تأصيل الوقائع المعاصرة.
يبدأ الباحث بشرح مصطلح انفتاح الدلالة على المستوى الصوتي، ضارباً أمثلة من القرآن الكريم، ومقتطفاً نصوصاً من القسطلاني، وابن الأنباري، وغيرهما. ثم ينتقل إلى المستوى الصرفي المتعلق ببناء الكلمة، مستشهداً بآيات قرآنية، وبآراء علماء اللغة مثل الصاحبي، والإسترابادي، والمبرد، وبآراء المفسرين مثل القرطبي، والطبرسي، والزمخشري وغيرهم. ثم ينتقل إلى المستوى التركيبي ثم المستوى المعجمي، ملاحظاً أن الانفتاح الدلالي يمكن مقابلته بانغلاق الدلالة أحياناً، ويختتم بحثه بتقرير أن الانفتاح الدلالي قد يفضي إلى قيام أحكام فقهية تتضمنها آية واحدة.
الملخص
يبدأ الباحث بالتعريف بالسنهوري ومصطلحاته، ويستعرض تاريخ التقنين في البلدان الإسلامية قبل مشروع السنهوري. ويشرح موقف السنهوري من التقنين والقانون المصري القديم، ومن قوانين العالم. ثم يعرض المنطلقات التي دفعت السنهوري لصياغة قانونه الجديد، ومصادره في ذلك، وتقويمه للمشروع. ثم يتحدث عن نقل التقنين إلى البلدان العربية، شارحاً استراتيجية السنهوري في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. ثم يقدم تحليلاً وتقويماً لآراء بعض الكتّاب، مشيراً إلى المشروع بوصفه من القوانين الفذة من المنظور الفني، ولكنه لا يستطيع وصفه بأنه قانون إسلامي رغم وضوح دعوة السنهوري لتطبيق الشريعة الإسلامية التي انعكست في كتاباته وأوراقه الشخصية.
رأي وحوار
===================
برغم مضي مدة على بداية الحديث عن علم للاقتصاد الإسلامي فما زال هناك وجه للكلام في بعض النواحي المنهجية لهذا العلم، بل إن مضيّ مدة معقولة على البحث والدراسة في العلم -أي علم- يعدّ أحد العناصر المهمة للحديث عن الجوانب المنهجية في هذا العلم. والحديث عن المنهجية هو من جهة على درجة عالية من الأهمية، وهو من جهة أخرى لا يغني عن الحديث عن النواحي المعرفية في العلم. فكلاهما لا غنى عنه في علم يراد له البناء والارتقاء. والذي تودّ هذه الورقة طرحه يتعلق ببعض هذه الجوانب المنهجية، وعلى وجه التحديد:
– موضوع علم الاقتصاد الإسلامي: أهو السلوك الاقتصادي للمسلم أم هو السلوك الاقتصادي للإنسان؟ وبعبارة أخرى أهو الظاهرة الاقتصادية مطلقة أم هو الظاهرة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي؟
– وهدف علم الاقتصاد الإسلامي: أهو مجرد الوصف والتفسير والتنبؤ أم هو إضافة إلى ذلك، تقويم السلوك وتعديله؟
– والتنظير في الاقتصاد الإسلامي: أيعتمد على العقل والحس فقط أم يعتمد أيضاً على الوحي أو النقل؟
– وعلم الاقتصاد الإسلامي وتعدد الرؤى واحتمالية التعرض للأخطاء.
وعليه فإن هذه الورقة تتناول القضايا الأربع الآتية: موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، وهدف علم الاقتصاد الإسلامي،التنظير في الاقتصاد الإسلامي، وعلم الاقتصاد الإسلامي وتعدد الرؤى والتعرض للأخطاء …
لعلّه من المناسب قبل الخوض في شعاب هذا الموضوع وتفاصيله أن أبيّن المعاني التي أرمي إليها من استعمال كلمتيْ “المدارسة” و”الممارسة”.
المدارسة هي التعلمُّ دراسة وتدريساً وهي مذاكرة العلوم وتحصيلها من بطون الكتب أو تلقيها من أفواه العلماء في حلق العلم وغير ذلك من أساليب التعلّم وطرائقه.
وأما الممارسة فهي تنـزيل العلم النظري على الواقع وتطبيقه معالجةً لقضايا الواقع ونوازله وحوادثه ووقائعه.
ويدور هذا البحث حول مدارسة العلوم الشرعية ومدى حاجتها إلى الممارسة، فقد انصرف المهتمون بالعلوم الشرعية من العلماء والأساتذة والباحثين في الجامعات وغيرها من دور التعليم ومراكز البحث إلى الاكتفاء بالمدارسة دون الممارسة لذلك لابد من الدعوة إلى تصحيح هذا الوضع الذي أفرز سمات سلبية ثلاث هي:
السمة الأولى: طغيان المدارسة وندرة الممارسة بينما يفترض أن تكون الممارسة مواكبة ومتوازنة مع المدارسة النظرية. وسأقدم فيما بعد اقتراحات تعكس التوازن المطلوب بين الأمرين وترمي إلى إعادة الاعتبار إلى الممارسة.
السمة الثانية: الانغماس في التاريخ والانسلاخ من الواقع. فالدراسات الإسلامية، والعلوم الشرعية كما يجري تدريسها والتأليف فيها والكلام فيها، منغمسة أو منغمس أهلها في التاريخ منسلخون عن الواقع، فمثلا الفقه الإسلامي الذي يدرس اليوم هو في معظمه فقه تاريخي لا يعالج قضايا العصر ومشكلاته.
أنا لا أتحدث عن النصوص ومقتضياتها الواضحة واستنباطاتها الصحيحة، هذه نصوص شرعية لها مكانتها الدائمة، ولها أيضا صلتها بالتاريخ وتفاعلها معه. ولكني أتحدث عما وضعه الفقهاء والأمراء والقضاة عبر التاريخ، من مؤلفات وفتاوى وأحكام وتحليلات، وعما وضعوه من علاجات لمشكلات مجتمعاتهم وعصورهم، فهذا تاريخ… وحين نكثر منه أو نغرق فيه أو ننغمس فيه ونعتمد عليه، فنحن نعيش في التاريخ والعيش في التاريخ لا يعني أننا نحيا الحياة الإسلامية المطلوبة. فحينما نقرأ اليوم مثلا عنوانات أبواب الشركات، نجد الفقهاء أو مدرسي الفقه إلى اليوم يتحدثون عن صيغ البيوع وعن الشركات وأنواعها، كما وجدت قبل عشرة قرون أو أكثر، وكأن هذه الأشكال من البيوع والشركات نزل بها الوحي. كشركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الذمم، وشركة الأعمال، والمزارعة، والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والمهايأة، وغيرها من أنماط المعاملات التجارية والزراعية التي هي حتى بأسمائها إنتاج تاريخي اجتماعي، فالفقهاء في زمانهم نظروا في معاملات الناس تلك بأسمائها وأشكالها …
قراءات ومراجعات
===================
الإمام الغزالي (450ﻫ-505ﻫ)
هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد في طوس من أعمال خراسان وكان أبوه يعمل بغزل الصوف ومن هنا سمي بالغزالي. عاش الإمام الغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري أي القسم الثالث من العصر العباسي، الذي يعد من أكثر الفترات السياسية اضطراباً، إلا أنه تميز أيضاً بنهضة علمية متفوقة ملئت فيه المكتبة الإسلامية بالآف المؤلفات في مختلف المجالات العلمية. يعد الإمام الغزالي موسوعة علمية تتنقل بين ساحات العلوم المختلفة فيدلو بدلوه في كل منها وكأنه المتخصص الفريد في ذاك العلم. ولقد رحل رحمه الله في طلب العلم إلى أماكن كثيرة وبقاع مختلفة، فجلس وأخذ العلم على أيدي مشايخ وعلماء كثيرين، وكان من أبرز مشايخه أمام الحرمين الجويني في الفقه وأصوله، والإمام النساج في التصوف، وأبو سهل الحفصي في الحديث وغيرهم كثير. ولقد جلس للتدريس في مدارس ومساجد عديدة ومن أهمها المدرسة النظامية في بغداد. وللإمام الغزالي في علم أصول الفقه مؤلفات مهمة منها: (المنخول) وهو من أوائل كتبه ويميل فيه إلى الإختصار، و(تهذيب الأصول) ويميل فيه إلى الإطناب، و(شفاء الغليل) وهو كتاب يختص في التعليل، ثم كتاب (المستصفى) وهو أخر كتبه الأصولية وأنضجها فكرياً ويعد محصلة كتبه الأصولية ويأتي السؤال هنا ما الجديد الذي قدمه الغزالي -رحمه الله- في علم أصول الفقه؟ هل كان للغزالي منهج متميز في أصول الفقه؟ وإن كان له منهج خاص كيف تأثر بمن قبله وكيف أثر بمن بعده؟
علم الأصول في سطور:
ترجع أهمية علم الأصول إلى كونه علم تأسيس قواعد المنهج الأولى في الفكر الإسلامي، فهو كما أشار إليه الإمام الغزالي علم ازدوج فيه السمع والعقل، واصطحب فيه الرأي والشرع فأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل. من أولى مؤلفات التأسيس في هذا العلم كتاب الإمام الشافعي (الرسالة)، ولقد أخذت (الرسالة) دور الريادة في الدراسات الأصولية لفترة طويلة تداولها العلماء بالشرح والتحليل ما بين تأييد أو تفنيد. ولقد تم تناول علم الأصول من طريقتين: …
ظهرت في العقود الأخيرة العديد من الدراسات التي تتناول الإسلام دراسة وتحليلاً، وذلك لما غدا يحتله من مكانة تؤهله لأن يتضاعف دوره في المستقبل، ولئن كان مفهوماً أن تأتي بعض هذه الدراسات من قبل المختصين بالدراسات الإسلامية من داخل نسقها، أو من منظومة تتناول الإسلام من الخارج في سياق علمي خاص ذي طابع سياسي أو اجتماعي… ؛ فإن ما يثير الانتباه وجود العديد من الدراسات تتناول الإسلام خارج أي سياق من السياقات العلمية المشار إليها وبدعوى الاستحواذ على مقابيض العلوم كلها تقريباً مما يجعل نقد أي من هذه الكتابات غير متيسر للقارئ لا لاستحالة الجمع بين هذه العلوم فحسب، إنما لعدم إدراك المفاصل التي تتموضع فيها تلك العلوم في هذه الدراسات، ولئن كان من الضروري على أي باحث الإلمام بأمهات العلوم ذات الصلة بمجال معين فإن الإدعاء باستخدامها -ويشترط هذا الإدعاء الاستحواذ عليها- يثير التساؤل حول احترام التخصص في العلوم الذي يزداد تشعباً يوماً بعد يوم بما لا يسمح بدعوى من هذا القبيل.
ويأتي كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ مثيراً للاهتمام لما تناوله فيه من قضايا تكاد تشمل كل قضايا الإسلام في العصر الحاضر، ويطرح الكتاب إضافة للتحليل حلولاً يصفها بأنها جذرية لهذه القضايا، ولما كان هذا النوع من الكتابات يحظى باهتمام الباحثين عن الجديد أو التجديد في الفكر الإسلامي كان من الضروري إبداء الرأي فيها وإثراء الحوار حولها، هذا وبقدر ما لبعض هذه الدراسات من فاعلية في دفع حركة الفكر الإسلامي نحو تجديد علمي وعملي بقدر ما للبعض الآخر ما له من أثر سلبي يرتكس بجهود التجديد المخلصة إلى الوراء وتزيد الشكوك في نواياها، من هذا المنطلق يأتي تحليلنا ونقدنا لهذه الدراسة إسهاماً في رسالة المؤلف التي أعلنها في المقدمة للرقي بالفكر الإسلامي.
سوف تتضمن هذه القراءة تقديم الكتاب وبيان منهج الكاتب وأهم الأفكار التي عرضها، وذلك حسب تسلسل أبواب الكتاب، مركزين على الأفكار المحورية فيه. ثم نقدم تحليلاً نقدياً للكتاب، نعرض فيه نقد المضمون وتحليل المنهج ونقد فرضيات الكتاب الأساسية …

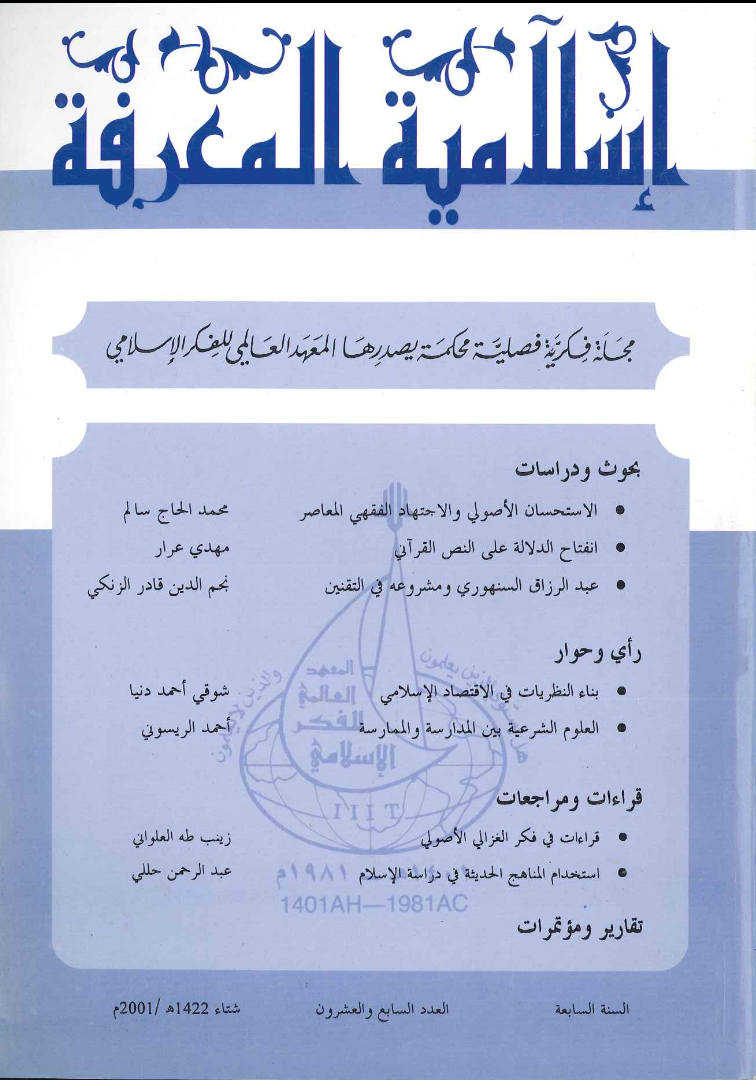
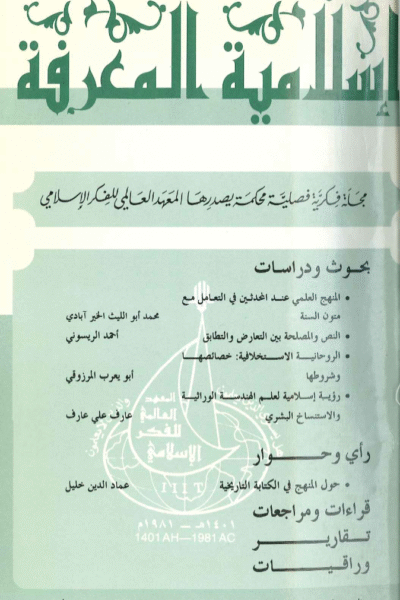
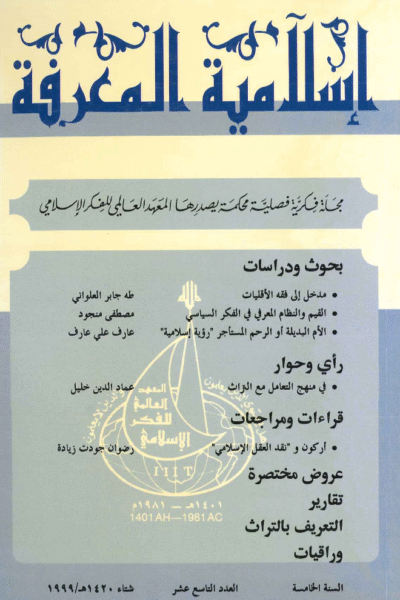
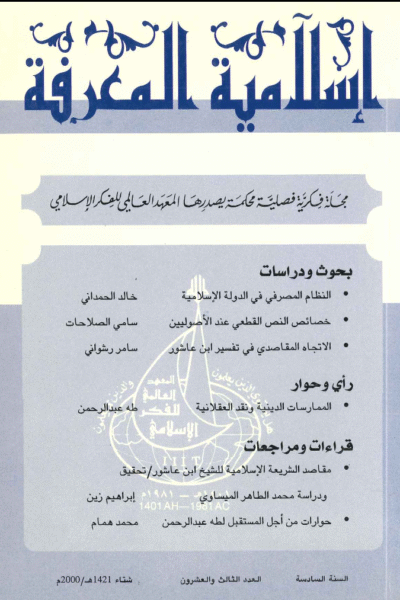
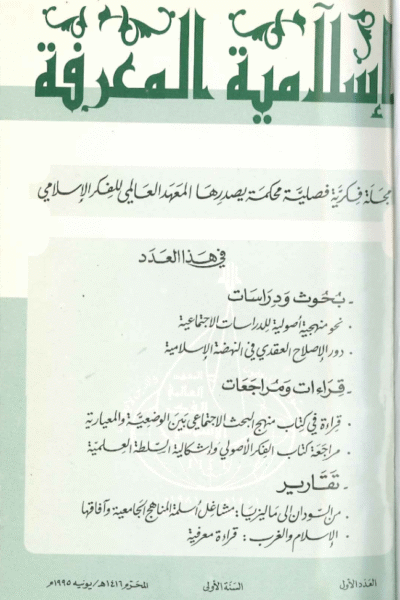
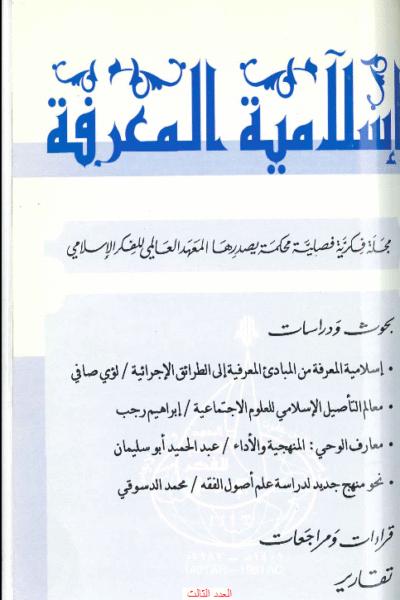
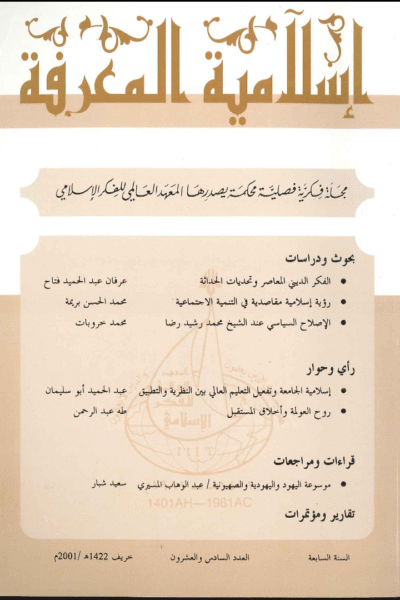
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.