الوصف
كلمة التحرير
===========
يصل هذا العدد من “إسلامية المعرفة” إلى أيدي القراء متأخراً عن موعده، لظروف قاهرة. انشغلت فيها إدراة المجلة وإدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بما انشغلت به معظم المؤسسات والمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لحقها من إرباك وتضييق ومصادرة على أيدي السلطات الأمريكية التي يسمونها سلطات بسط القانون. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها هذه السلطات لمواجهة ما يسمى بالحملة ضد الإرهاب، وذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001م، وهي أحداث مؤلمة دون شك، وقد طالت وقائعها الآلاف من الأبرياء كما طالت ذيولها ونتائجها الملايين منهم، ولا تزال هذه الذيول تهدد ملايين أخرى.
لقد استغرب الكثيرون أن يلحق بالمعهد هذا الذي لحق به وهو المؤسسة الفكرية العلمية المتخصصة والمنفتحة على المدارس الفكرية الأخرى تعاوناً وحواراً وجدالاً بالتي هي أحسن. وقد عبّر الكثيرون ممن عرفوا المعهد عن قرب -من مسلمين وغير مسلمين- عن ألمهم لما أصاب المعهد وأبدوا غضبهم واستهجانهم للتهم التي يلقيها جزافاً بعض الكائدين الذين أعماهم الحقد حتى تمحّضوا للشر والفتنة، دأبهم التحريض على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والعدوان على الشعوب وقهرها وتدمير مقوماتها وسفك دمائها وانتهاك حرماتها، وهم بهذا لا يريدون خيراً لأحد من غيرهم.
لقد أكد المعهد على صفحات هذه المجلة ومنشوراته الأخرى على أهمية الساحة الفكرية من ساحات العمل الإسلامي العديدة، وعلى قراره في التخصص للعمل في هذه الساحة، مع تقدير أهمية الساحات الأخرى، على أمل أن ينمو التخصص وتركيز الجهود، وأن تتكامل بذلك جهود العاملين من أجل النهوض الحضاري لهذه الأمة. وأكد كذلك على قراره بإدارة هذا العمل من هذا الموقع الجغرافي على أهمية المواقع الأخرى وسعيه الحثيث لتحريك العمل فيها والتعاون معها.
إنّ ما حدث في الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) شئ يخالط الخيال وربما لو كانت أحداث ذلك اليوم قصةً كتبها مؤلفٌ من كتاب الروايات لشعر بعض القراء بأن المؤلف بالغ حتى في الخيال! والذين رأوا أحداث ذلك اليوم على شاشات التلفاز أو كانوا شهود عيان في نيويورك وواشنطن سيتذكرون أحداث الفيلم الخيالي الذي عرض قبل سنوات ويتحدث عن أهوال اليوم الذي يأتي بعد حرب نووية (The Day After).
لم يُعرف حتى الآن على وجه التحقيق من الذي خطط لهذه الأحداث أوكيف تم ذلك، وما هي الغاية الحقيقية المقصودة منها، وهل ما تم فعلاً كان مخططاً له بحيث يتم على هذه الصورة. صحيح أن التهمة قد تم توجيهها إلى أطراف محددة وصحيح أن بعض هذه الأطراف قد ادعت علاقتها بالأحداث وصحيح أنه تم اعتقال الآلاف من الناس في العديد من …
بحوث ودراسات
==============
يبدأ الباحث بشرح مفهومي المنهج والمنهجية ومصطلحيهما. ثم يشرح الاهتمام المنهجي بوصفه متطلباً، لاستعادة قوة الأمة. ثم يعرض لمظاهر الخلل المنهجي في واقع الأمة، ممثلاً بالخلل في فهم الواقع والتعامل معه، والخلل في ربط الأسباب بالنتائج، والخلل في النظرة الكلية والشمولية. ثم يركز على أهمية البحث في المنهجية الإسلامية والتفكير المنهجي، مشيراً إلى كتابات إسماعيل الفاروقي، وعبد الحميد أبو سليمان، وطه العلواني، وأحمد الريسوني، ومحمد سعيد البوطي، ولؤي صافي، وفضل الله، وطه عبد الرحمن، وغيرهم، مختتماً بالتحذير من الانبهار الزائف بالمنهجية، أملاً في توجيه جهود العلماء إلى مرحلة جديدة من البيان المنهجي والممارسة المنهجية المسؤولة.
يبدأ الباحث بشرح مفهوم الحاكمية على المستوى اللغوي، وعلى مستوى وروده في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار، ثم يحلل الآليات التي اعتمدتها النماذج الكبرى المتعاملة مع المفهوم، مثل المودودي، وسيد قطب، وطه العلواني. ويقدم الكاتب رؤية تكاملية للحاكمية عن طريق فك الارتباط بين مبدأ الألوهية ومفهوم الحاكمية، مناقشاً الأسس المذهبية، والسياسية، والفكرية للمنهجية. ثم يقدم ثلاثة أنواع من الحاكمية، هي الإلهية، والشرعية، والإنسانية، مختتماً بالتركيز على أن مجال الحاكمية الفكرية يتضمن دراسة العالم المادي، ودراسة الوحي، ومشيراً إلى تحليل هذه الثنائية، وإلى آراء الجويني، والغزالي، والرازي.
الملخص
يبدأ الباحث بمناقشة مفهوم الجمع بين القراءتين، ويتساءل هل علوم العربية تحتاج إلى عملية أسلمة؟ ويستعرض تسويغات تجديد الفكر اللغوي العربي، محاولاً تأصيل القضية فكرياً ومنهجياً، ثم يشرح التجديد المنهجي الذي يعدّه جوهر القضية الفكرية المعاصرة، ثم التجديد المعرفي، متسائلاً عما إذا كانت المعرفة اللغوية عند العرب قد قدمت شيئاً. ويحدد أهم قضايا علم اللغة ذي التوجه الإسلامي، مثل العلاقة بين العربية والعلوم الشرعية، وقضايا الترجمة والتعريب، مختتماً بحثه بشرح مدى حاجتنا إلى منهجية معاصرة للمستقبل، تفيد من معطيات علم اللغة المعاصر، وتسترشد بمقاصد الإسلام وقيمه العليا، كالتوحيد، والتزكية، والعمران.
رأي وحوار
===================
يولد الإنسان مزوداً بالعقل والإدراك الذي ميزه الله به عن سائر المخلوقات، وهو ذلك التميز الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى “وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا” (البقرة:31) فليس المقصود -فيما أرى هنا- تعليم آدم منطوق أسماء الأشياء، فذلك مما لا يدل عليه تكوين الإنسان وقدرته كما فطره الله، ولأن معنى ذلك معرفة أسماء الأشياء التي لم يرها أبونا آدم في حالته الحضارية البدائية إلى أن تقوم الساعة، وبكل اللغات، ووقوع ذلك على تلك الهيئة هو أمر ليس له أثر في تاريخ الإنسان ولا يوجد عليه دليل محسوس فيما يعرف من طبائع البشر وقدراتهم.
فإذا علمنا أيضاً أن منطوق الاسم لا معنى ولا قيمة له إذا لم يكن هناك وعي بمعناه وبدلالته، وهو العلم بطبيعة المسمى، وبكنهه، وبوظيفته، بشكل من الأشكال، فإن المعنى الممكن هنا لابد من أن ينصرف إلى قدرة الإنسان على الإدراك، وقدرته على تجريد المشتركات التي تضم المفردات، وردها إلى أصول وأجناس -وهو من الواضح في أصل خلق آدم حين سُوِّي ونفخت فيه الروح- فالكراسي أو المباني أو الحيوانات -على سبيل المثال- تتعدد أشكالاً وألواناً ومظاهر وتراكيب، ويختلف كل نوع واحد منها عن الآخر، إلا أنها في مجموعها ترجع إلى تشابهات وأبعاد تضم مفرداتها بعضها إلى بعض، وتجعلها في أجناس وأنواع، فهناك كرسي المكتب، وكرسي الاستقبال، وكرسي السيارة، وهناك الكرسي الكبير، والكرسي الصغير، وهناك الكرسي الخشبي، والكرسي المعدني، والكرسي البلاستيكي، وهناك أشكال وألوان وأحجام من الكراسي، لكن الذي يجمعها تحت هذا المسمى جميعاً أنها أداة للجلوس والراحة. وقدرة الإنسان على الإدراك والتمييز والتجريد هي أصل قدرة العلم والمعرفة عند الإنسان، وقدرته على توليد الأفكار والمبتكرات، وتوليد رموز أسمائها في اللغات الإنسانية المختلفة، وفي رأيي؛ فإن قدرة الإنسان على الإدراك، وقدرته اللغوية التي مكنته من إيجاد الرموز وإطلاقها على المسميات، وهي الأسماء، وقدرته على استخدامها، إنما هو أصل قدرة الإنسان الحضارية والعمرانية، ومن دون قدرة الإنسان على صياغة الرموز واستخدامها لم يكن باستطاعته الكتابة، ولا تطوير العلوم والمعارف، ولا الاستخلاف في الأرض، وإن ذلك هو المقصود بـ (تعليم الأسماء) الذي أشار إليه القرآن الكريم، وميز الله به الإنسان …
يكاد يحصل اليوم إجماع -أو شيء كالإجماع- بين الذين كتبوا في تاريخ التشريع الإسلامي على أن الفقه الإسلامي منذ نشأته تقاسمته مدرستان: مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث. يمكن الرجوع في تبين هذه المقولة واستجلاء مجموع كل المفردات الفكرية المشكِّلة لمضمونها مما سنناقشه في هذه المقالة إلى مؤلفات تاريخ التشريع الإسلامي على اختلافها، إذ كلها تكاد تكرر نفس الفكرة بتفاصيلها وجزئياتها، وتبدئ فيها وتعيد.
وعندي، أن هذه المقولة تحتاج إلى كثير تدقيق ومراجعة، إذ يسبق إلى الذهن منها –ضرورة- أنه يمكن فهم الدين واستنباط الأحكام الشرعية منه اعتماداً على الحديث وحده، أو على الرأي وحده.
والذي يهمني في هذه العجالة من أمري أن أجيب هنا عن سؤالين اثنين:
أ. هل فعلاً هناك: أهل رأي وأهل حديث؟
ب. ما السبب الحقيقي في الخلاف الواقع بين مختلف الاتجاهات والمذاهب الفقهية؟
فأقول، وبالله أعتصم:
إن ما ينبغي الوقوف عنده -ابتداءً- هو أن الذين يذهبون إلى تقسيم الفقه الإسلامي إلى هاتين المدرستين، لا يتفقون على تحديد موحد لرجال كل واحدة منهما: فلئن كانوا يعتبرون أبا حنيفة زعيم أهل الرأي، فإنهم يختلفون في أهل الحديث من هم؟ فبعضهم يذهب إلى أن مالكاً بالمدينة هو زعيم أهل الحديث، وبعضهم يرى أنه أحمد بالعراق، ويختلفون في الشافعي، فمنهم من يعده من هؤلاء، ومنهم من بعده من أولئك، وكثير منهم يرى أنه جمع بين منهج المدرستين، كما هو مالك عند آخرين، يجمع بين الرأي والحديث، أو محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الذي ينظر إليه الكثير على أنه من أصحاب الحديث داخل أهل الرأي، أو سحنون زعيم أهل الرأي داخل مدرسة الحديث، فهذا إشكال أول …
قراءات ومراجعات
===================
يعاني كثير من مثقفي الحداثة ومفكريها من تشويش واضح وخلط كبير في تعاطيهم مع عدد من المفاهيم التي تملأ حياتنا الثقافية. فمن تلك المفاهيم مفهوم الحرية الفكرية. ولأهمية هذا المفهوم لابد أولاً أن نبين كيف تتكون المفاهيم ثم نحدد الطريقة التي تجعل الفرد يتبنى مفهوماً معيناً دون آخر.
يقسم علماء النفس المفاهيم إلى نوعين: مفاهيم مجردة ومفاهيم محسوسة. المفاهيم المجردة عبارة عن أسماء تشير إلى فكرة نظرية مجردة تتمثل في صورة بنية معرفية في الدماغ. أما المفاهيم المحسوسة فهي تشير إلى اسم لشيء ذي أبعاد معينة من حيث الحجم أو الوزن أو غير ذلك من الأبعاد. ويحدد علماء النفس ثلاثة معايير ليكون المفهوم مفهوماً: أنه ينتمي إلى تصنيف معين، وأنه يمكن تصوره، وأخيراً أنه مركب ومعقد. ويعتمد المفهوم المجرد في وضوحه وتفسيره على السياق الذي يقع ضمنه، وكلمة السياق هنا لا حدود لها. فقد يكون على المستوى اللغوي، أي الموقع الذي يتخذه المفهوم بين مفردات وكلمات وروابط وغير ذلك. وقد يكون السياق تلك الأوضاع التاريخية والسياسية والمزاج الثقافي التي ولد المفهوم في ثناياها. وأما كونه ينتمي إلى تصنيف معين، فهذا يشير إلى إمكانية تفسيره وتمييزه من بين المفهومات الأخرى. أما التعقيد فهو يشير إلى قضية مهمة وهي أن المفهوم ليس مجرد اسم على فكرة، بل إن هذا الاسم تشكل عبر مراحل عديدة، وتطور ليتخذ معنى معيناً. هذا المعنى لا يعبر عن فكرة واحدة، بل يمثل في كثير من الأحيان مظاهر وملامح كثيرة. كما أن دلالات المفهوم ترتبط بسياقات كثيرة لا يمكن التغاضي عنها.
فمفهوم الحرية الفكرية مثلاً يعني أن الإنسان الفرد حر في تبني الموقف الفكري الذي يراه مناسباً. وقد يتبنى شخص هذا المفهوم من خلال ظرف نفسي أو حياتي معين. فليس بالضرورة أن التبني ناتج عن قناعات الفرد بصلاحية ذلك المفهوم، بل إنّ بعض الناس يتبنون مفاهيم معينة نتيجة ظرف طارئ يمرون به. وقد يتبنى آخرون مفهوماً معيناً بناء على المنهج الفكري الذي آمنوا به وجعلوه الإطار الذي يحكم تفسيرهم للأشياء والأحداث والمقولات. ولذلك لا بد من سبر الحالة النفسية والظرف التاريخي اللذين يمر بهما الشخص للتعرف على مدى قناعته بذلك المفهوم. فقد يتبنى شخص الحرية الفكرية كونه يعيش في بلد…
إن التراث العربي الإسلامي-بما في ذلك التراث المتعلق بعلم النفس- تتنازعه اليوم ثلاثة مواقف: أولها موقف تمجيدي يرى ضرورة اعتماد التراث بما هو عليه دون نظر في مفرداته ومفاصله الأساسية باعتباره يمثل تقاليد إسلامية موروثة. وثانيهما موقف تحقيري يرفض التراث جملة وتفصيلاً باعتباره صدى لأعصر بائدة، تعكس ثقافته عصوراً لها خصوصياتها. وينـزع أصحاب هذا الموقف عن المسلمين فضل السبق والإضافة في كثير من مجالات العلم. وثالث المواقف موقف يرى أفراده ضرورة احترام التراث مع تناوله بمنهج أساسه النقد والتحليل والنظرة التاريخية إلى مضمونه حتى يمكن تمييز الغث فيه من السمين. وكما هو واضح، فإن هذا الموقف يتجاوز الموقفين السابقين لأنه يأخذ بعين الاعتبار صلات التأثر والتأثير بين الثقافة العلمية العربية الإسلامية والثقافات الأخرى. وفي الواقع فإن هذا هو موقف مدرسة أسلمة المعرفة. وإذا كان لي أن أصنف كتاب الدكتور عمر خليفة في موقف من هذه المواقف الثلاثة، فلا شك سيكون موقعه في الموقف الثالث. تهدف هذه الورقة إلى عرض الكتاب أولاً والإشارة إلى مقاربات أسلمة علم النفس المختلفة بما فيها المقاربة المتبناة في هذا الكتاب.
المجال العام للكتاب هو التراث النفسي العربي الإسلامي. ومن الممكن تقسيم هذا المجال العام إلى مجالات فرعية متعددة هي المجال العلمي ويتعلق بقضايا علم النفس وموضوعاته المختلفة والمجال اللغوي ويتعلق بالتراث المكتوب باللغة العربية دون غيرها والمجال الزمني ويتعلق بالتراث الذي تم نشره في الفترة ما بين القرن التاسع الميلادي والقرن الخامس عشر الميلادي، وأخيراً مجال التراث المكتوب دون الاهتمام بالتراث المصنوع كالآلات والمكائن والمباني من مساجد وقصور وغيرها.
ويمكن تقسيم أهداف الكتاب إلى مجموعتين هما: أولاً، توسيع نطاق عمل الدكتور الزبير البشير طه في كتابه “علم النفس في التراث العربي الإسلامي” (1995) إضافة إلى إحياء مقياس ابن الهيثم للغلط البصري، ورسم ملامح علم النفس التجريبي في التراث العربي الإسلامي. وثانياً تحديد حجم التأثيرات التي أحدثها علم النفس التجريبي في التراث العربي الإسلامي في تطور الحضارة العلمية والتقنية الغربية. وثمة هدف ضمني آخر يمكن استنتاجه من خلال العنوان العام للكتاب والعناوين …

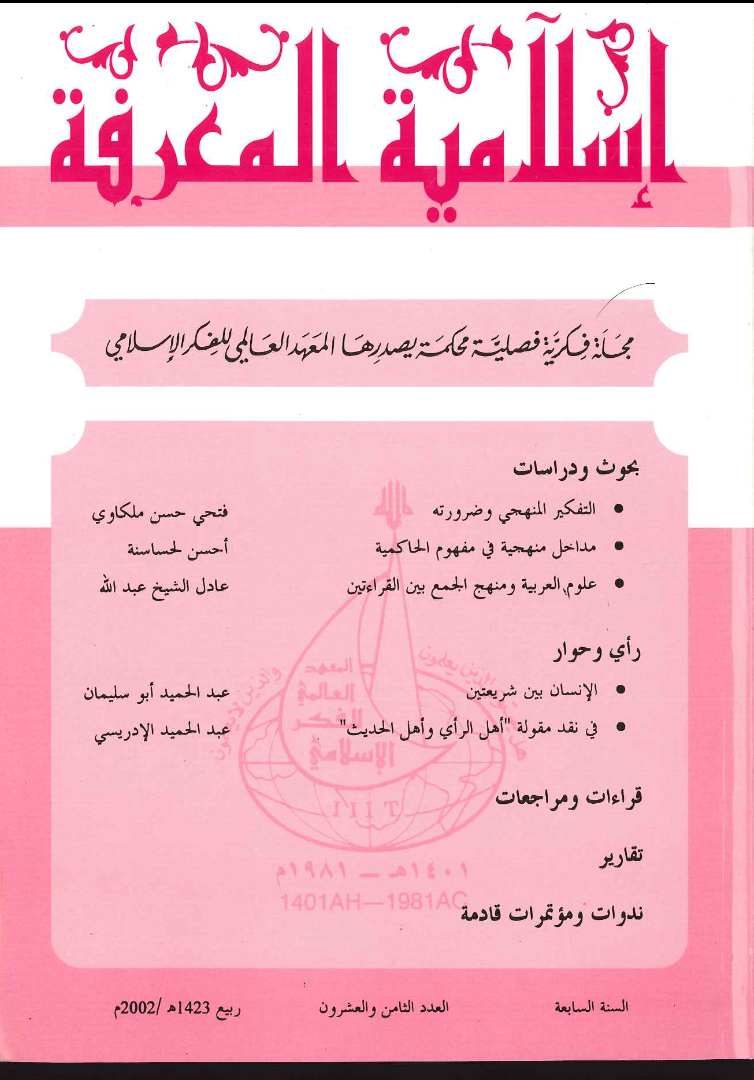
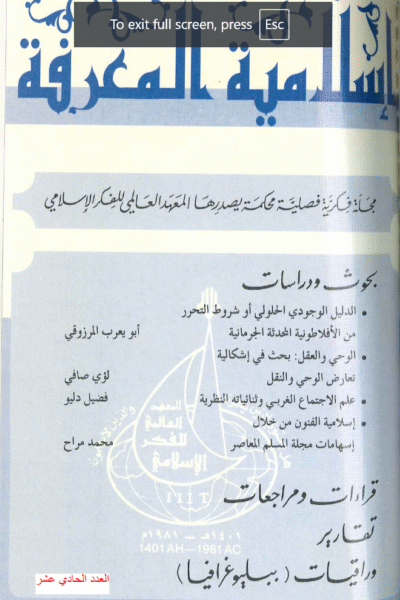
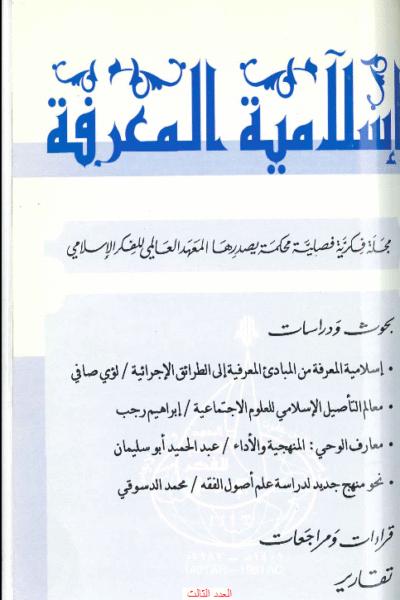
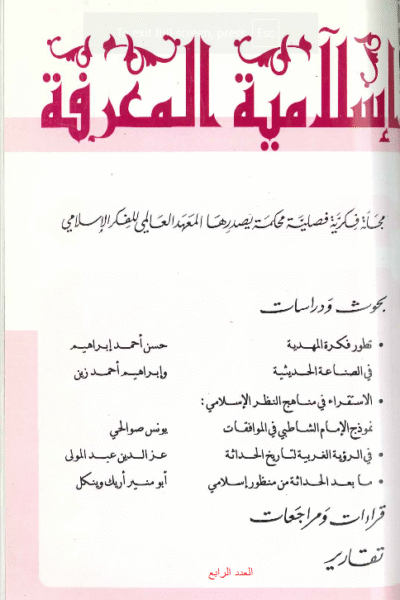
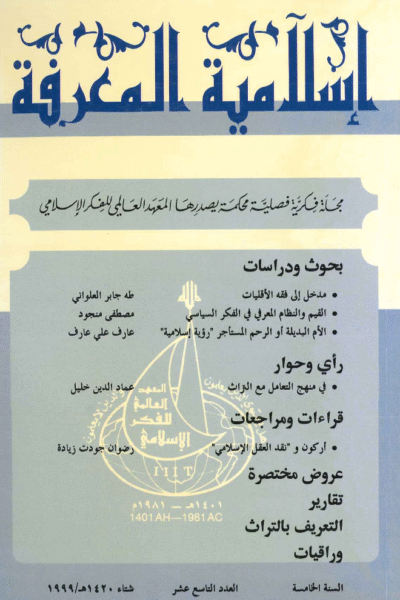
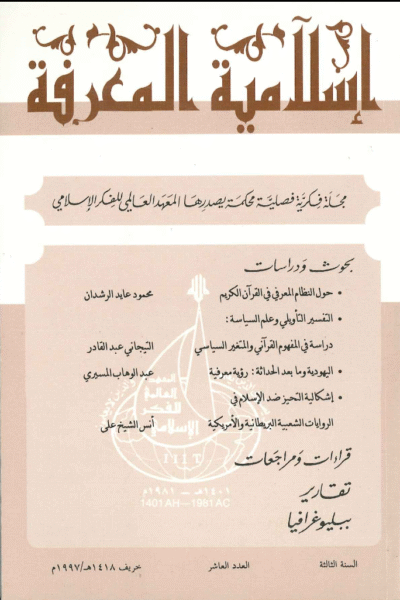
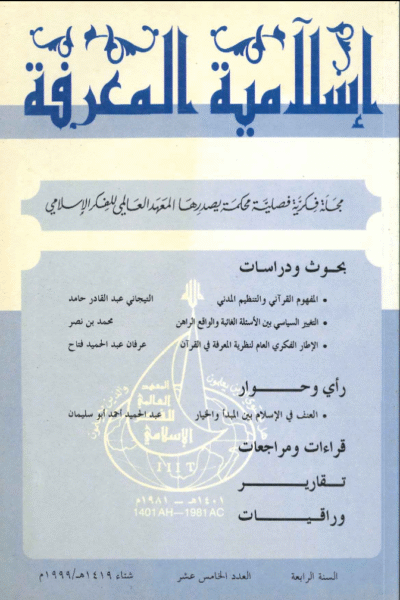
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.