الوصف
كلمة التحرير
===========
تدخل “مجلة إسلامية المعرفة” بهذا العدد المزدوج عامها التاسع، وهي لا تزال تؤكد على مجمل الأفكار التجديدية التي طرحها المعهد العالمي للفكر الإسلامي على الأمة منذ أكثر من ربع قرن، لمواجهة التحديات التي كانت ولا تزال مطروحة على الأمة الإسلامية. وقد طرح المعهد يومها مجموعة من التوجهات الفكرية الإصلاحية تأتي في مقدمتها تلك الأفكار الخاصة بإصلاح واقع التعليم المدرسي والجامعي، لإنهاء حالة الفصام النكد بين التعليم الديني والتعليم العام، باعتبار هذه الحالة تكريساً للفصل “العلماني” بين الدين والحياة؛ هذا الفصل الذي يحرص الكثيرون على تعميقه حتى من الداخل الإسلامي، رغم أنّه قد حرم نوعي التعليم من إحداث الفاعلية في بناء الشخصية الإسلامية أو تنمية المجتمعات الإسلامية. ونخشى أن تؤدي الهجمة الخارجية الضارية التي تُمارس ضغوطها حالياً على الدول العربية والإسلامية -للحد من أثار التعليم الإسلامي- إلى تمترس مضاد يعيق عملية الإصلاح التي دعا إليها ولا يزال يدعو كثير من المخلصين في الدائرة الإسلامية.
لقد كانت الفرصة مفتوحة دوماً لهذا الإصلاح، بهدف جعل الثقافة الإسلامية إطاراً للتعليم في جميع مراحله وموضوعاته، وستبقى مفتوحة دوماً؛ حتى لا يبقى التعليم الإسلامي حبيس برنامج محدود تدخل إليه فئة محدودة من أبناء المجتمع، تتحكم الظروف السلبية في كثير من أقطارنا في تحديد من يدخل هذا التعليم وما تقوم به هذه الفئة بعد تخرجها منه! كذلك ستبقى الفرصة مواتية دوماً لهذا الإصلاح، حتى لا يبقى التعليم الإسلامي حبيس مادة معينة في التعليم المدرسي، أو قسم معين في التعليم الجامعي؛ فالتعليم الديني الذي يتطلبه هذا الإصلاح يحدد الرؤية الكونية التي تصوغ الفهم والسلوك للفرد والمجتمع، ويحدد ارتباط المعرفة الإنسانية بهداية الوحي الإلهي والقيم العليا التي جاء بها الإسلام، وذلك من حيث الحرص على اكتساب هذه المعرفة في ميادينها المختلفة، وتوظيفها في بناء مجتمع قوي وغني وآمن، يشعر أبناؤه فيه بالثقة والكرامة والكفاية …
بحوث ودراسات
==============
يقف البحث عند مجموعة من المفاهيم الأساسية مثل: النبوة، والرسالة، والاصطفاء، والوحي… وغيرها وقفة تحليل لمعرفة الحدود والفواصل فيها، لئلا يلبس على المسلمين دينهم كما ألبس على الأمم السابقة بعد وفاة نبيهم أو فقده، فقد اتخذ الناس قبره وثناً وقدّسوه.
والهدف من ذلك الوصول إلى تصور دقيق لدور هذه المصطلحات وغيرها في بناء الشخصية الإسلامية عقلاً ووجداناً. وحتى لا تقع في خلط واضطراب يجعل من أبناء الأمّة الواحدة شيعا يكفر بعضها بعضاً دون سبب منطقي.
يتناول البحث مسألة التداخل الاصطلاحي في علم أصول الفقه. وقد تمثّل هذا التداخل في أمرين هما: كثرة الترادف، وكثرة الاشتراك اللفظي. وكان لهذا التداخل أثر كبير في بروز الخلاف اللفظي في كثير من المباحث الأصولية، إذ يدور الجدل ويشتد النزاع؛ لأنّ واحداً من الفريقين المتنازعين أطلق لفظاً وأراد به شيئاً، ففهم الفريق الآخر منه معنى آخر.
جاء البحث ليضع حدّا للتداخل الاصطلاحي الذي جعل من أصول الفقه يأخذ طابع الجدل والاعتراض.
الملخص
الحوار مع الآخر لن يتحقق بمؤتمرات تعقد أو ندوات تقام بين المسلم والمسيحي أو غيره من أتباع الديانات الأخرى، تتبادل فيها وجهات النظر، وتلقى البحوث، وتحدد التوصيات، ثم ما تلبث أن تترك على الرفوف دون أن يكون لها مردود عملي يذكر. الحوار هو فعل وسلوك ومنظومة من القيم الخلقية في التعامل مع الآخر، ابتداءً بمفردات الحياة اليومية وانتهاء بمنحه الحق الكامل في الحرية، والمواطنة، والحياة، والاستمرار. من هذا المنظور، ليس ثمة كالأمة الإسلامية قدرة على التحقق بمطالب “الحوار” بمفهومه العملي، على مستوى التأسيسات الفقهية، أو الممارسات التاريخية.
وليس من مهمة هذا البحث متابعة المعطيات الفقهية الخصبة والمتميزة بصدد التعامل مع الآخر، وإنما التأشير على بعض الممارسات التاريخية بوصفها شواهد فحسب، من بين سيل من الشهادات لا يكاد يحصيها عدّ، تؤكد فيما لا يدع أي مجال للشك في أن المسيحيين واليهود من أهل الكتاب وغيرهما من الفرق الدينية الأخرى، عاشوا حياتهم، ومارسوا حقوقهم الدينية والمدنية على مداها في ديار الإسلام، فيما لم تشهده ولن تشهده أية تجربة تاريخية في العالم.
وقبل أن ندلف لمتابعة الوقائع الخاصة بالموضوع، لا بد من التذكير مرة أخرى بأن ألف مؤتمر للحوار لن يحمل مصداقيته، أو يقود إلى فعل متحقق كما يحملها ويقود إليها “التاريخ” باعتباره الحكم الفصل في قدرة “المبادئ” على التماس مع الواقع، وتحويل “الكلمة” إلى فعل منظور …
جاء البحث دراسة في مقاربة جدلية لنصوص فكرية عامّة، وأدبية خاصة في مشروع أدونيس، ومحاولة قراءة إشكالاته التنظيرية، والإبداعية بصفة خاصة؛ قراءة لمستوى حضاري إنساني وبرحابة صدر. ويرى الكاتب أن هذا الأمر ليس مستحيلاً؛ لأنّ الإنسان في قراءته يمكنه أن يتحيّز لما يرى أنه الحق، وهذا هو الالتزام.
تناول الباحث الموضوع ضمن الأطر الآتية:
هل القراءة ذات مرجعية؟ وماهية هذه المرجعية؟ بين القراءة والأيدلوجيا. القراءة ذات المرجعية ونصيب الموضوعية منها. اللغة: علاقة الدال والمدلول والإشكالات المثارة. القراءة البديل.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
تأخر الأحناف في تأليف طبقات علماء مذهبهم إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي وسبقهم غيرهم، ولم يكن كتاب “الجَوَاهِر المُضِيَّة في طَبَقَات الحَنَفِيَّة” (أو: “طبقات الحنفية” -كما يطلق عليه في بعض الأحيان) أول مؤلف في تراجم أتباع المذهب الحنفي فقد سبقه في هذا الشأن مؤلفان لم يكتب لهما الذيوع، لكنه بلا ريب أول كتاب في تراجم الأحناف كُتِبَ له الزيوع والشهرة، ألفه عبد القادر القرشي دون أن ينسج على منوالٍ سابق وكان ثمرة جهدٍ استغرق طيلة عمره.
كانت نَفْسُ محيي الدين عبد القادر ابن أبي الوَفَاء القُرَشِيّ الحَنَفِيّ المصري -منذ بداية طلبه العلم- تتشوف إلى جَمْعِ كتابٍ في طبقات رجال مذهبه، فإن أرباب المذاهب المتبوعة كُلٌّ منهم أَفْرَدَ أصحاب إمام مذهبه، ولم يَرَ أحداً جمع طبقات الحنفية، وهم أُمَمٌ لا يُحصون، فيمنعه العجز عن الإحاطة ببعض هذا الجَمّ الغفير -كما يقول- وتتبع الكتب المصنفة في ذلك.
ولقد لقيت هذه الرغبة حَثَّاً من أساتذته، وعوناً له بالمصادر والمراجع، ورعاية لعمله بالنصح والتسديد فمضى في الطريق إلى منتهاه.
ولا ندرِي متى كانت بداية التأليف إلا أنا نعلم أن الرغبة كانت قديمة قِدَم طلبه للعلم -كما رأينا- حَشَدَ لها هِمَّةَ ومصادر عدة، حتى إذا كانت سنة 759ﻫ وكان قد بلغ الثالثة والستين من عمره كان قد بلغ منتصف الطريق فقد كان قد بلغ حرف العين سنة -وهو نحو منتصف الكتاب-، وبقي النصف الآخر الذي أنجزه في السنوات الست عشرة الباقية من عمره …
——————–
اهتمت الحضارة الإسلامية اهتماماً عظيماً بتدوين التاريخ -بِشِقَّيْه: تاريخ الحوادث وتاريخ الرجال- قَلَّ أن تدانيها في ذلك حضارة من الحضارات أو أمة من الأمم، ولقد افْتَنُّوا في ذلك افتناناً يدعو إلى الدهشة والإعجاب، فألفوا في التاريخ السياسي الأسفارَ الطوال، وبسطوا القول في الحديث عن الملوك والخُلَفاء، والأفراد، والحروب، ومظاهر الحضارة، ودرسوا مجتمعاتهم من النواحي المختلفة، كما صنفوا في تاريخ البلدان، وترجموا من وَرَدها من الصحابة والتابعين، وتراجم من نشأ فيها وتوطنها ونُسِبَ إليها أو إلى نواحيها، ومَن دخلها من غير أهلها غازياً أو تاجراً أو طالباً للعلم.
ومما يدعو إلى الإعجاب والإكبار أن علماء المسلمين ألفوا في طبقاتٍ شتى من الناس على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم واتجاهاتهم وصِفَاتِهِم، ولقد كان رُواة الحديث مِن هؤلاء الذين عُني بهم فريقٌ من المصنفين عناية خاصة، بل ظهرت عناية المسلمين بتراجم هؤلاء الرجال منذ العصر الأول للإسلام، فتحدثوا عن فضائل بعض الصحابة مما مُلئت به كُتب الحديث، وكان هذا داعيًا للمؤرخين بعد ذلك لأن يحتذوا هذا الحذو ويقفوا على فضائل التابعين ومن بعدهم.
ولقد كان من نتائج اتساع الحركة العلمية وكثرة رواية الحديث أن رأى العلماء أنفسهم بين أصناف متعددة من الرواة، فبحثوا عن كل راوٍ وحللوه، وتعددت الآراء المختلفة في التجريح والتعديل، فجُمِعَت الأخبار في نقد الرواة وبيان حالهم من حيث قبول عدالتهم وضبطهم، ودونت سيرته ومولده ووفاته ورحلته وشيوخه وتلاميذه ومسموعاته ومروياته ومؤلفاته -إن كانت له مؤلفات- ومدى دقته في الرواية ومدى اعتماده في الرواية على الحفظ أم الكتاب، ومقياس تورعه وتدقيقه في رواية ما يحفظ، إلى غير ذلك، فعلوا ذلك لارتباطه بالمسائل المتعلقة بكتاب الله وسنة نبيه وأصول التشريع وفروعه، وقد قال أحدهم: “إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.” …
——————–

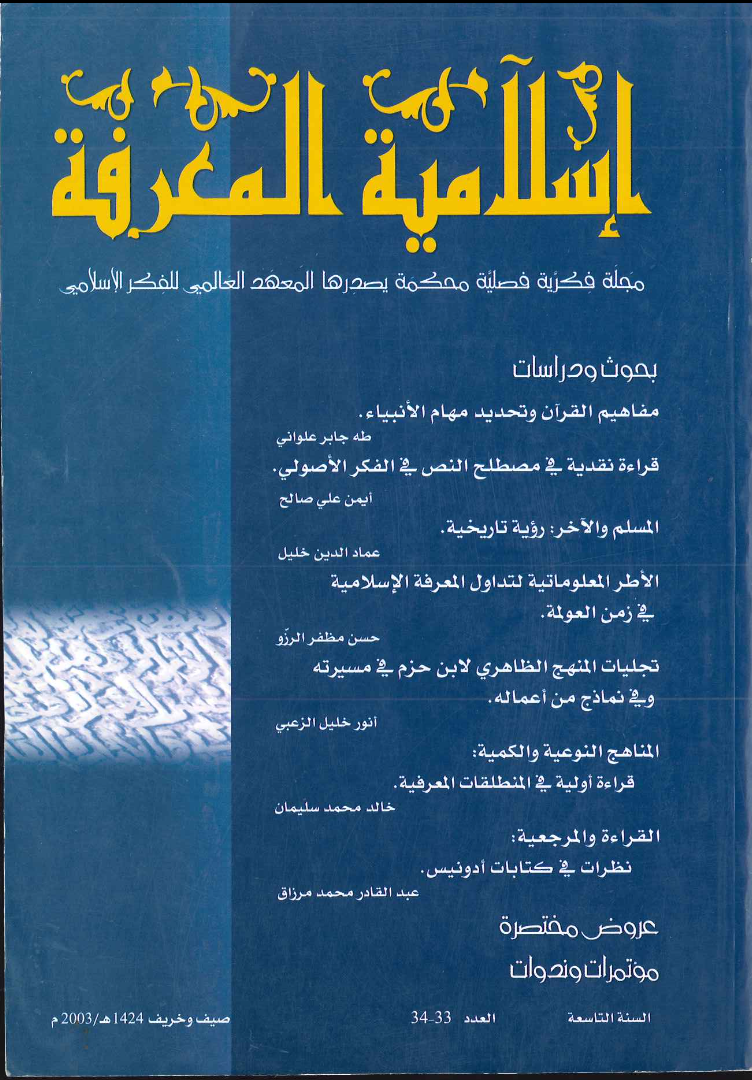
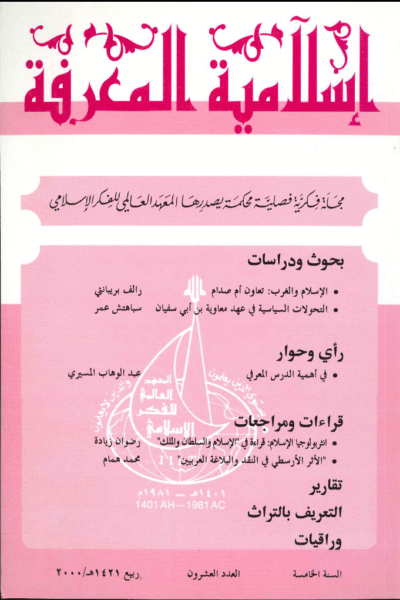
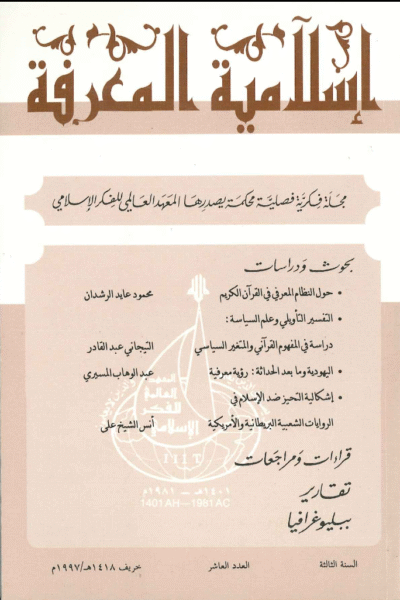
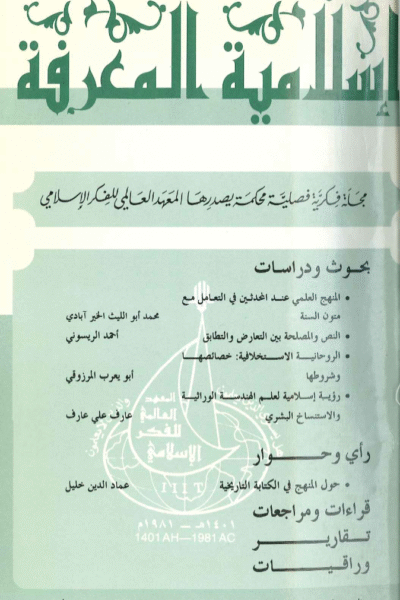
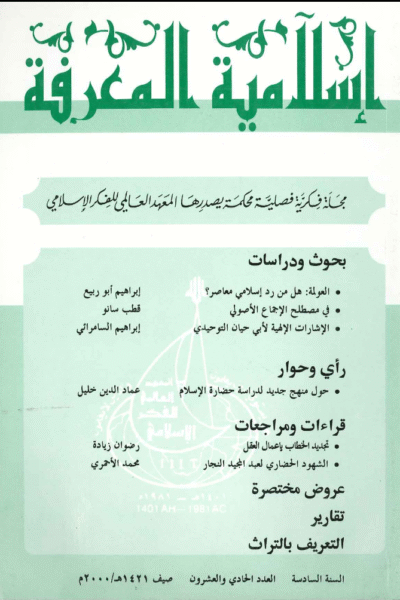
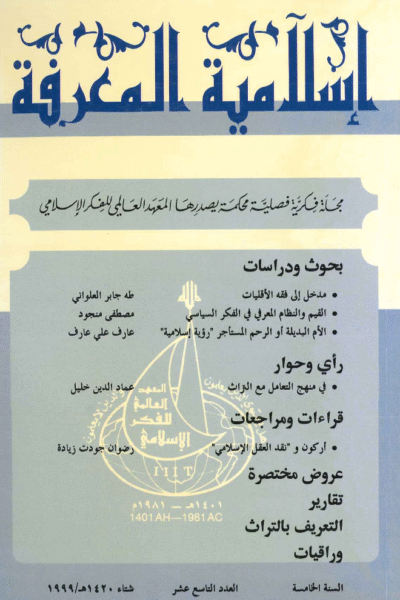
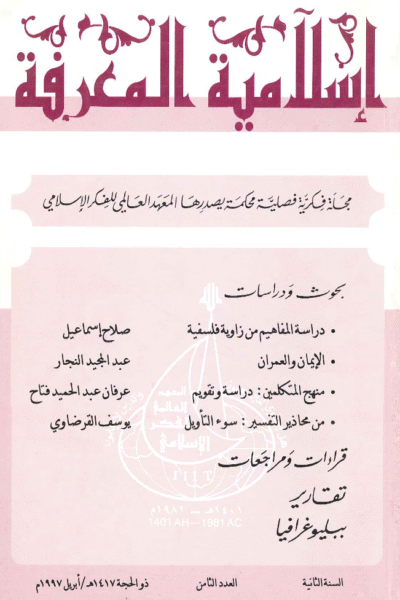
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.