الوصف
كلمة التحرير
===========
تمرّ أمتنا في هذه الأيام بظروف تتّسم بالاضطراب الباعث على الحيرة والقلق، فمن متفائل يقول بأنّ هذا الليل لابد أن يعقبه فجر؛ ومن متسائل أليس لهذا الليل الطويل من آخر! ومن قائل إنّ الواقع القائم لا فكاك منه، وتيارات العولمة الهادرة لا قبل لأحد في مواجهتها، فلنتكيف معها ولنوجه أشرعتنا في الاتجاه الذي تقودنا إليه. ويبدو أن الأمّة قد افتقدت البوصلة الهادية إلى المنهج السليم الذي يمكنها من استعادة فاعليتها وقدرتها وإرادتها وتتمكن من ثمّ من تقرير مصيرها بنفسها. وهذه الخصائص الثلاث الفاعلية والقدرة والإرادة شروط أساسية لتجاوز محن كهذه، بكل ما لها من انعكاسات وتشعبات؛ فإذا لم تستعد الأمة فاعليتها وقدرتها وإرادتها ومن ثم تقرير مصيرها بنفسها، فإنها بمقتضى قوانين هذا الكون وقواعد الاجتماع تكون قد بلغت سنّ الشيخوخة وحقت عليها كلمة الاستبدال. وهذه الأمة ارتبطت في تكوينها وفي بنائها وفي سيرورتها التاريخية بمصادر هداية خالدة ثابتة، قادرة عندما يُحسن الرجوع إليها أن تقدم سائر المؤشرات المطلوبة لاستعادة الفاعلية، وإعادة بناء القدرة، وتحقيق الإرادة التي تمكن من استيفاء بقية الشروط والصفات التي يتوقف عليها النهوض الحضاري والعودة إلى حالة الشهود. وهذه المصادر هي كتاب الله وبيانه من سنة نبيّه الثابتة الصحيحة. ولكنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ أي أن فاعلية القرآن لا تتحقق من مجرد وجوده بين ظهرانينا، ولكنها تأتي من الإنسان القارئ المتدبر، فالبشر هم الذين يقرؤون ويتدبرون ويعكفون ويتفكرون ويرتلون، ليصلوا إلى كيفية الإمساك بمقود واقعهم وتوجهه نحو التغيّر والصلاح.
وتشنّ اليوم على القرآن المجيد معركة لا هوادة فيها؛ معركة تعيد إلى الأذهان معارك مشركي قريش وجيرانهم من أهل الكتاب المبدل المحرف ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (فصلت: 26)، ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (الفرقان: 5)، ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (النحل: 103) ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.﴾ (الشعراء: 210-211) ولذلك نُطالب اليوم بالإمعان في هجره وتجاوزه إن أمكن، وإلاّ فلا بد من إدخال تعديلات وتغييرات وحذف بعض الآيات وإعادة تأويل …
بحوث ودراسات
==============
الهدف من البحث الحديث عن اللسان العربي وعمقه الإسلامي، والعمل على معرفة السبيل القويم إلى توحيد أهل هذا اللسان، أو التأليف بينهم من جديد، وتوظيف اللغة العربية في تحقيق هذه الوحدة في سائر المجالات.
يناقش البحث هذه القضية في إطارين: القرآن واللسان، والمراد بالأمّي والأميين، ليصل في النهاية إلى أنّ التسوية بين القرآن المعجز للسان، واستعمال أهل اللسان أمر تأباه حاكمية القرآن الكريم، ولكن يمكن الاستئناس بما ورد عن العرب للوصول إلى مزيد من الفهم.
يرى الكاتب أنّ هذه الدراسة، هي تتمة لدراسات سابقة اهتمت بالتفسيرات العلمية للقرآن، وأن هدفها تسليط الأضواء على هذا التوجه من الدراسات خلال ربع قرنٍ مضى بشكل عام.
وقد ناقشت الدراسة هذه القضية في المحاور الآتية:
القرآن كتاب هداية أم كتاب علم؟ الربط بين تخلف المسلمين وإهمال الآيات الكونية في القرآن. جهود الكشف عن التطابق بين علوم الطبيعة والآيات الكونية في القرآن. مخاطر التأكيد على تطابق علوم العصر الحالي مع القرآن.
الملخص
قراءات ومراجعات
===================
أول مرة تعرفت فيها على كتاب “نظرية التقريب والتغليب” كان أثناء إعدادي لرسالة علمية حول موضوع “الاحتياط في الشريعة والفقه”، فاستفدت منه في عدد معتبر من المباحث، حيث وجدت فيه معالجة مميزة لقضايا هامة وترجيحات موفَّقة في مسائل خلافية، وذلك استناداً إلى نظرية التغليب. لكنني لم أع جيداً الأهمية الحقيقية للنظرية وعمق آثارها وسعة مجالاتها، إلا في مرحلة لاحقة، وذلك حين بدأت في إعداد أطروحتي لنيل دكتوراه الدولة، وكانت القضية الأولى عندي في هذه الدراسة قضية معرفية وابستمية تتعلق بإمكان معرفة بعض المستقبـل وأساس هذه المعرفة وشروطها وموقـف الإسلام منها. وقد فهمت منذ البداية أن المعرفة المستقبلية معرفة ظنية ونسبية التحقق، فتساءلت عن قيمتها وعن الرأي الشرعي فيها، فوجدت بعض ضالتي في كتاب الأستاذ الريسوني الذي أعتبره مؤلَّفاً معرفياً ابستيمولوجياً -كما سيأتي- حتى لو كانت قاعدته من علوم الحديث والفقه والأصول، في الأكثر.
يقول المؤلف عن فكرة الكتاب إنه: “يتولى هذا البحث الكشف عن إحدى النظريات الكبرى التي تتشكل منها المنظومة المنهجية الأصولية في الإسلام، وهي نظرية ينضوي تحتها وينبع منها عدد كبير من المبادئ والقواعد التي وجّهت التفكير الإسلامي، وتحكمت في الإنتاج العلمي الإسلامي. وهي نظرية تعطي جهازاً منهجياً واسعاً ومنسجماً لمعالجة عدد لا يحصى …
——————–
يعتبر كتاب “المداولة في أعمال عماد الدين خليل” أول عمل مباشر في الأدب الإسلامي المعاصر ينشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وذلك بعد نشر الكثير من الكتب بباقي فروع المعرفة الأخرى.
والكتاب الذي بين أيدينا هو في الأصل أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي تقدم بها صاحبها إلى جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال السنة الجامعية 1996/1997م وقد كان عنوانها الأصل ” المداول في أدب عماد الدين خليل: قراءة وتركيب للتأويل والتمثيل”. ورغم أن المؤلف قد تتبع المداولة في أعمال عماد الدين خليل الفكرية والتاريخية والدعوية لكن الأعمال الأدبية كانت أحد الأهداف الرئيسية.
والكتاب يقع في أربعمائة وعشر صفحات من الحجم المتوسط، وقد جاء في أربعة فصول قبلها مقدمة ومدخل وبعدها خاتمة مستفيضة، حيث خصص الفصل الأول لمعاني المداولة وتأويلاتها والفصل الثاني لضوابطها والفصل الثالث لتجلياتها وطرق الاستدلال عليها، والفصل الرابع لمصادرها ومفاهيمها المتجاورة.
والمؤلف لا يخفي أنه يقصد بعمله كله نصرة الأدب الإسلامي المعاصر بالأساس ويعلن ذلك صراحة في أول جملة من مقدمة كتابه بعد حمد الله والصلاة على نبيه ثم يوضح المقصود بهذا الأدب الإسلامي المعاصر، فهو –أي الأدب الإسلامي- باختصار شديد: المعادل الجمالي للصحوة الإسلامية المعاصرة. وقد وضع له المهتمون به عدة تعاريف؛ فهو عند عماد الدين خليل تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود. وعند نجيب الكيلاني”تعبير فني جميل مؤثر، نابع من ذات مؤمنة مترجم عن الحياة والإنسان والكون وفق الأسس العقائدية للمسلم.” وتعرفه الرابطة العالمية للأدب الإسلامي بأنه: “التعبير الفني الهادف عن الحياة والكون والإنسان وفق الكتاب والسنة.” …
——————–

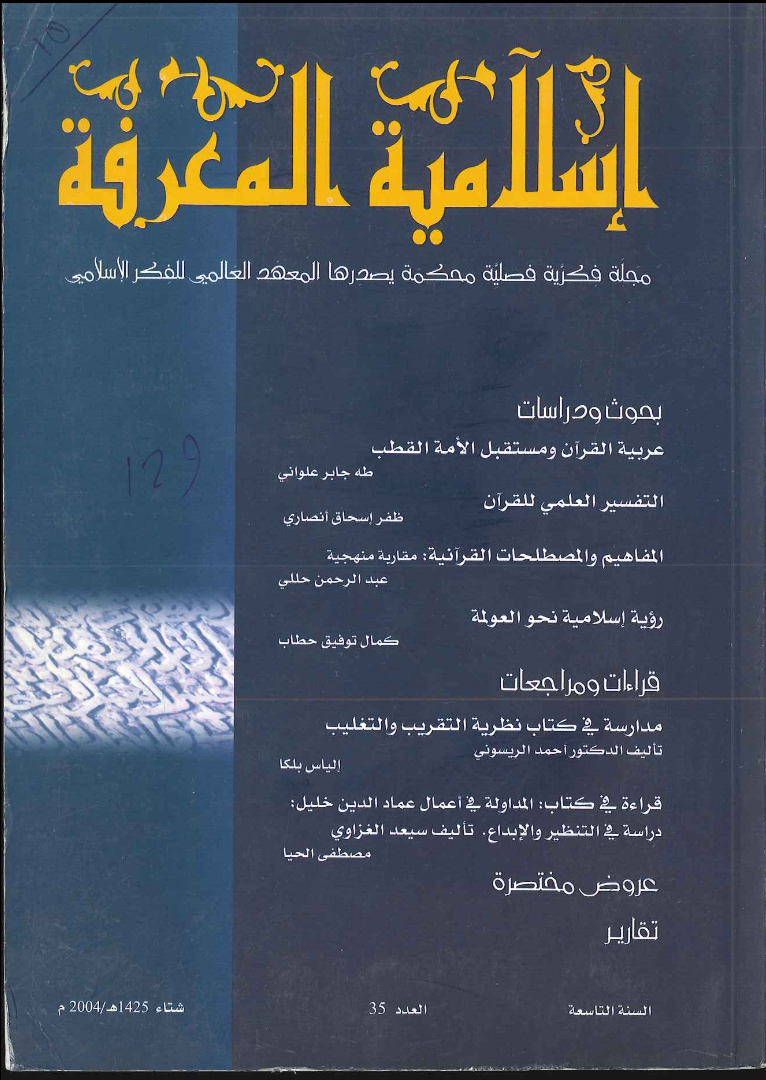
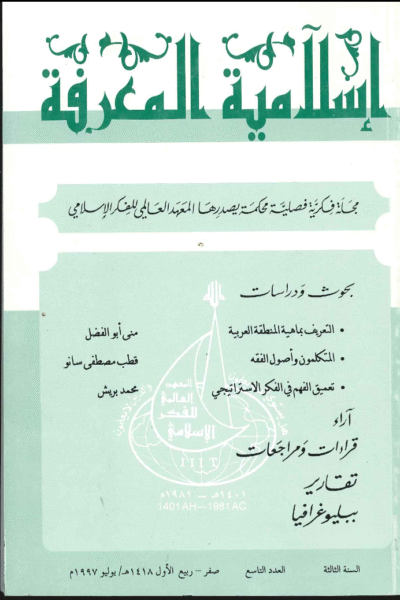
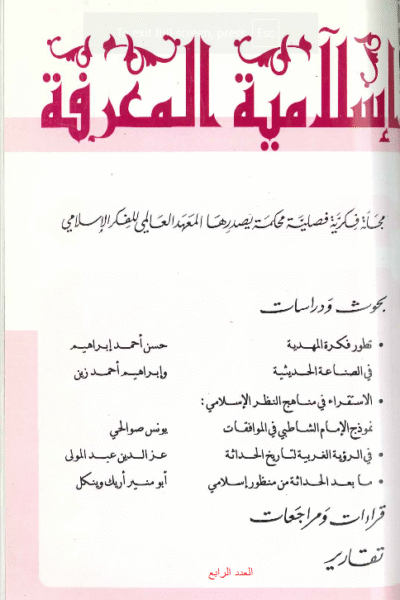
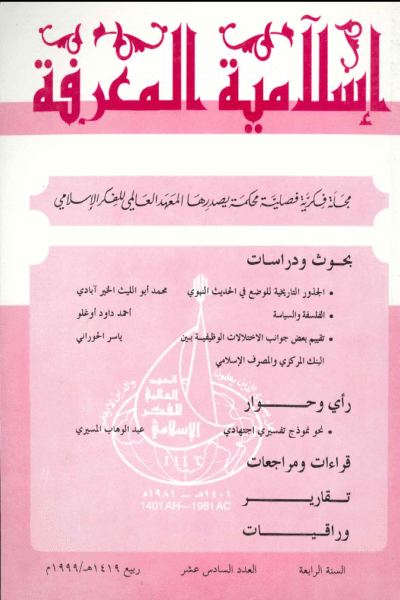
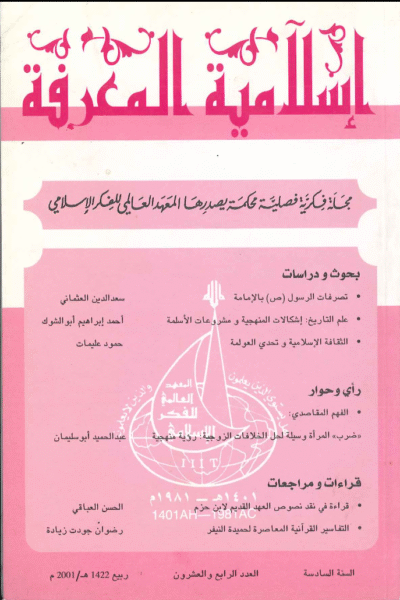
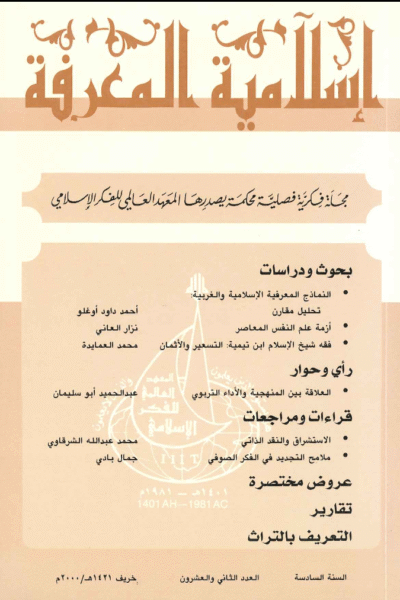
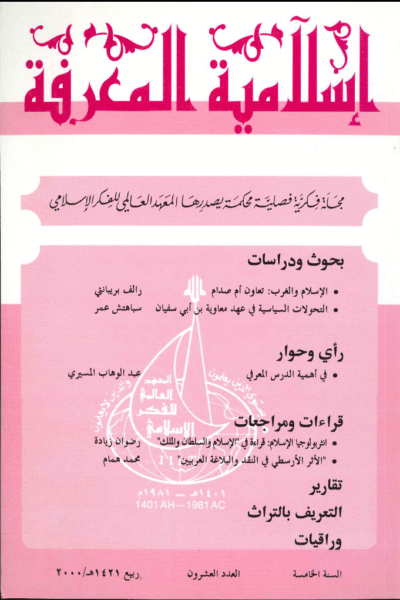
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.