الوصف
كلمة التحرير
===========
كلمة التحرير
قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي قضايا متشعبة، وتتعلق بالتفكير والبحث، كما تتعلق بالتعامل مع النصوص والأفكار والأشياء والأحدث والأشخاص. وتميل الرؤية المعرفية إلى الواقع وقضاياه ومشكلاته إلى محاولة بناء علاقة بين مناهج التفكير أو مناهج البحث أو مناهج التعامل من جهة والصورة التي نجد عليها واقع الناس وأحوالهم من جهة أخرى. ومن ثمّ تصبح هذه العلاقة وسيلة لفهم الظواهر وتفسيرها، وتصبح دراسة قضايا المنهجية على هذا الأساس مهمة جداً في جهود الإصلاح. والأمر في هذا الشأن لا يقتصر على واقع المسلمين، بل هو أمر إنساني عام. لكن الفارق أن المجتمعات الأخرى تبدو أكثر وعياً على القضايا المنهجية. وفي كلمة التحرير هذه مجموعة من الإشارات الموجزة إلى صور مختلفة من الأزمة القائمة في ميدان البحث العلمي في هذه المجتمعات الأخرى، تبين كيف يستشعر المعنيون بالبحث هذه الصور، لعلّ في ذلك ما يدفع قراءنا الأعزاء إلى تتبعها، وتتبّع تمثّلاتها في واقعنا الراهن، وحثّ الخطى على إيلاء الموضوع ما يحتاجه من اهتمام
1. تعليم مناهج البحث العلمي في العلوم الدينية
تقدم معظم الجامعات ضمن برامجها للدراسات العليا مادة بعنوان “مناهج البحث” لتساعد الطلبة الباحثين على استكمال متطلبات البحث المطلوب منهم للحصول على الدرجة العلمية. ونظراً لأن معظم البحوث التي تتم في برامج التعليم الديني تستبعد مناهج البحوث الميدانية الكمية، المألوفة في معظم العلوم الإنسانية والاجتماعية، فإن الاهتمام ينصرف إلى الوراقيات والأدبيات الخاصة بموضوعات الدراسات الدينية؛ أي أن تدريب الطلبة ينصرف إلى كيفية تحديد المصادر والمراجع والحصول عليها وأخذ المعلومات منها. وحيث لا تتوافر كشافات وفهارس عامة بالبحوث والكتابات الخاصة حول الموضوعات المختلفة تيسر للباحث …
بحوث ودراسات
==============
يطرح الباحث في البداية السؤال الآتي: ماذا يقدّم فكر القدماء من عُدّة ما زال المحدثون والمعاصرون في أشدّ الاحتياج إليها؟ ؟ وتعظم فائدة السؤال إذا عرض القارئ أنّ الحديث يتصل بشخصية متعددة المجالات المعرفية من فقه، وقضاء، وفلسفة، وطب. إنها شخصية ابن رشد التي اجتمعت فيها خصائص الموضوعية، القاضي والنزاهة، واستقامة الفقيه وأخلاقيته، وحكمة الطبيب وتفاؤله.
وقد اختار الباحث جانبين رئيسين للحديث عنهما من فكر ابن رشد الفقهي، يختص الأول بالعقائد، ويتصل الثاني بالمقاصد.
استهدفت الدراسة الكشف عن الفراغ في تقعيد علم أصول التفسير، عبر دراسة تاريخ التقعيد، وحاولت تفهّم المسوّغات التاريخية التي أدّت إلى هذا الفراغ. وقد رأى الباحث أنّ علم أصول الفقه هو أكثر العلوم أهلية، ليكون أساساً لتكوين علم أصول التفسير. وتتبع الباحث تلك الدراسات التي حاولت اعتماد أصول الفقه أساساً لعلم التفسير. وقد استعرضت الدراسة منظـور أصول الفقه مقارناً بمنظور علم النحو. ويرى الباحث ضرورة استثمار كل مباحث الدلالة والتأويل في الدراسات العربية الحديثة وعلومها التقليدية، كما يؤمن بأهمية الدرس اللساني الحديث ومناهج النقد الأدبي في تطوير البحث الدلالي التفسيري، مع ملاحظة خصائص النص القرآني بوصفه نصاً ذا وظيفة دينية، وإلا دخلنا في متاهات لا تحمد عقباها.
الملخص
يناقش البحث المسوّغات الفكرية لمجموعة من الفرضيات التي أفضت إلى ظهور التفسير الإسلامي للتاريخ في النصف الأخير من القرن الماضي، ويحلّل الأطروحات الإسلامية التي قُدّمت في هذا الشأن بوصفها بدائل للأطروحات الغربية الخاصة بتفسير التاريخ، ثمّ يستعرض الإشكالات المنهجية التي تواجه هذه الأطروحات، وكيفية تقويمها.
ويصل إلى أن التفسير الإسلامي للتاريخ يقف على قاعدة صُلبة أفضل من قاعدة التفسير الغربي العلماني. إلا أنّه عاجز عن توظيف النظريات الفكرية السائدة في الحضارات الأخرى توظيفاً إيجابياً في إطار تصوره الإسلامي العام.
يناقش البحث موضوع المرأة، وهو موضوع واقع تحت تأثير نقيضين: موروث مبتدع أو واقع فاسد، فصارت أعرافاً تتحكم في نظرة الناس للمرأة وتعاملهم مع قضاياها بما يتعارض مع ثوابت الشريعة وأحكامها.
جاء البحث تأصيلياً بهدف بيان العلاقة بين العرف والشرع في التعامل مع قضايا المرأة من خلال ثلاثة مباحث: الأول كان تعريف المصطلحات، وأقسام العرف. وجاء الثاني لبيان العلاقة بين العرف والشرع. أمّا الثالث فقدّم نماذج من الأعراف السائدة قديماً وحديثاً في المجتمعات العربية، وبيان مخالفتها لثوابت الشريعة. ليخلص إلى أن الشريعة حاكمة على الأعراف ومهيمنة عليها، فما وافق الشرع فهو شرع، وما خالفه فهو باطل.
يعرض البحث بعض جوانب التحيّز في الفكر التربوي الغربي، ويوضح كيف أن هذه الجوانب تمثل عقبات كأداء في طريق الإصلاح التربوي في العالم الإسلامي، نظراً لأن معظم جهود الإصلاح تستمد مفاهيمها ونظرياتها ونماذجها من الغرب. هذا مع عدم الدعوة إلى القطيعة الفكرية مع الغرب في مجال الإصلاح التربوي.
وقد جاء البحث بمقدمة عن كلمة (التحيّز) ودلالاتها، ثم طبيعة الفكر التربوي الغربي، الواقع الإعلامي والسياسي يعزز التحيّز، والمصدر المعرفي والمنهجي في التحيّز في الفكر التربوي الغربي، ثم مفهوم العلمانية وأثره في التحيّز في الفكر التربوي الغربي، ثم خاتمة تؤكد عدم القطيعة مع الفكر التربوي الغربي.
قراءات ومراجعات
===================
يسعدني أن أقدم هذه المراجعة لكتاب “العالمية الإسلامية الثانية” الذي دبّجه يراع المرحوم المفكر السوداني الأخ محمد أبو القاسم حاج محمد، وهو فيلسوف أخذ من الفلسفة والفكر والعلم بنصيب وافر، وهذا الكتاب شاهد على ذلك، حيث يشير إلى حظّه من الفكر المستنير، والقدرة التحليلية المتماسكة، لكن الأهم من ذلك كله تلك الطاقة والصبر والجلد على دراسة القرآن الكريم، وهي دراسة تتصف بالتلاوة والتحليل والتتبع، وتتبنى وجهة نظر متميزة؛ مفادها أن هذا القرآن المحيد معادل موضوعي للكون، فالقرآن كتاب الله المسطور، والكون كتاب الله المنثور، والإنسان مستخلف في الأرض يهتدي فيها بالجمع بين القراءتين، ويكون من تدبره للوحي ما يعينه على اكتشاف آفاق الكون وقوانينه وتوظيفها في بناء العمران، ومن تدبره للكون وسننه ما يهتدي به لفه القرآن ولاكتشاف سننه ومنهجيته الناظمة له كله.
عرفت الفقيد قبل أن ألقاه، وذلك عند قراءة الطبعة الأولى من كتابه “العالمية الإسلامي الثانية”، وقد لفت نظري في البداية عنوان الكتاب، وإذ شرعت في القراءة لم أستطع أن أفارق الكتاب قبل أن أنتهي منه في قراءة أولية مررت بها على صفحاته كلها، فأدهشني في الرجل تلك القدرة التي لم ألقَها لا في قدامى المفسرين ولا في معاصريهم على فهم آيات الكتاب فهماً قائماً على النظر إلى …
——————–
يحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يعالج إحدى الإشكاليات الشائعة في الخطاب العربي – الإسلامي المعاصر والمتمثلة فيما سمّاه بمشكلة التفسير بأثر رجعي، والتي تحاول أن تجد جذوراً توراتية تلمودية للظاهرة الصهيونية المعاصرة، بأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية، ويقدم كبديل لهذه الرؤية تصوراً يتعامل مع الصهيونية كمفرز استعماري غربي محض، ذي ديباجات زخرفية يهودية.
ويؤكد المؤلف بداية على أن الصهيونية ليست انحرافاً عن الحضارة الغربية وإنما هي إفراز عضوي لهذه الحضارة بكافة تجلياتها وخصائصها، وأن الدولة الصهيونية ذاتها ليست سوى دولة استيطانية إحلالية، لا تختلف كثيراً عن أي دولة استيطانية أخرى، تنبع من حركيات الاستعمار الغربي، وليس من التاريخ اليهودي.
وفي هذا السياق يتناول الفصل الأول (الأصول الغربية للرؤية الصهيونية)، الجذور الأصلية للحركة الصهيونية، والتي تعود إلى الرؤية الاستعمارية والثورة الرأسمالية التي شهدها الغرب منذ نهاية القرن الرابع عشر تقريباً، فقد نجم عن تطور المجتمع الغربي من الشكل الإقطاعي إلى الشكل الرأسمالي أن ظهر ما يمكن تسميته بالمسألة اليهودية. وهذه لم تكن نتيجة اضطهاد الأغيار (غير اليهودية) لليهود، كما لم تكن مؤامرة حيكت خصيصاً ضد اليهود، وإنما هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية يمكن فهمها على نحو منطقي وتتلخص في فقدان اليهود للدور الذي كانوا يقومون به، الأمر الذي أدى إلى تحولهم إلى فائض سكاني بدون وظيفة، فطردت الأغلبية العظمى منهم، بعد أن وجد الاستعمار الغربي أن الحل الوحيد لهذا الفائض إنما يتمثل في تصديرهم إلى آسيا وافريقيا (اللتين صَدّر إليهما من قبل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية)، وهذا متسق تماماً مع الرؤية الغربية …

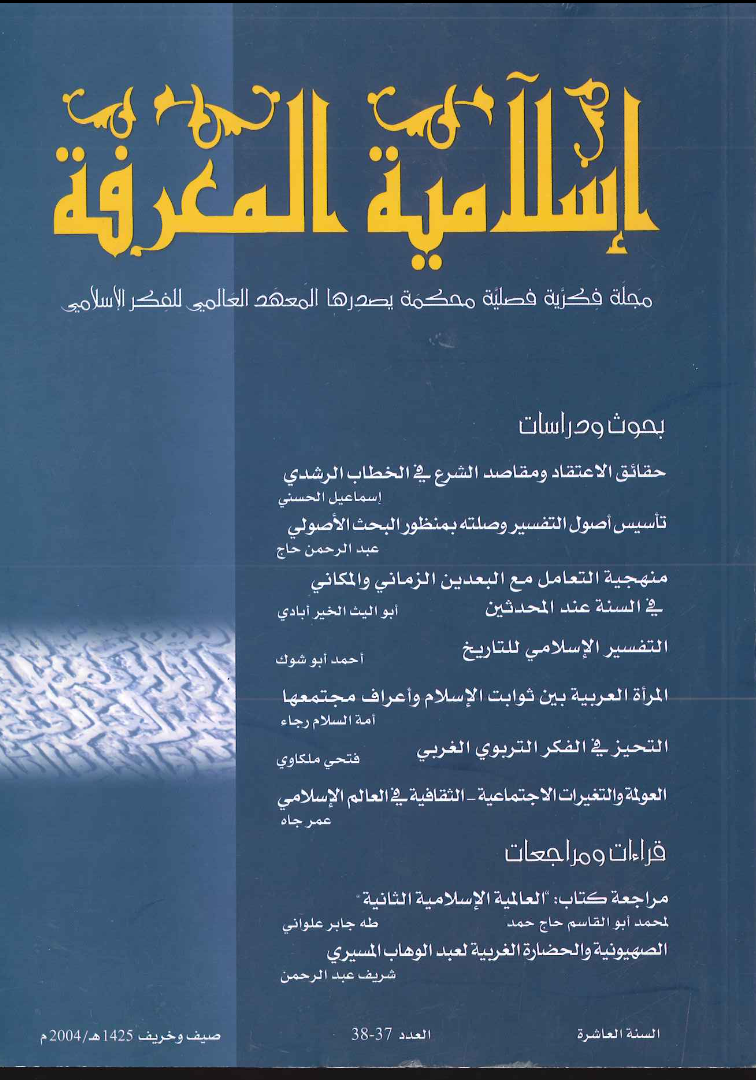
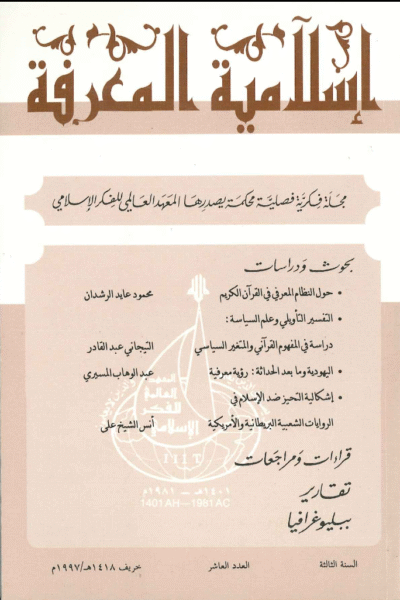
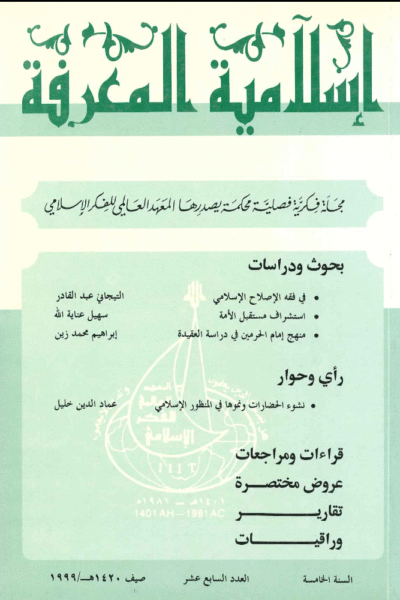
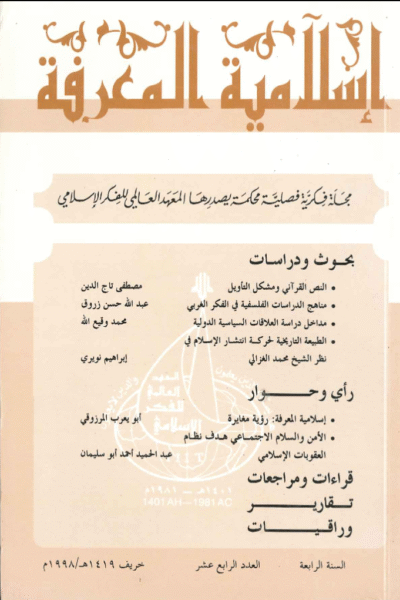
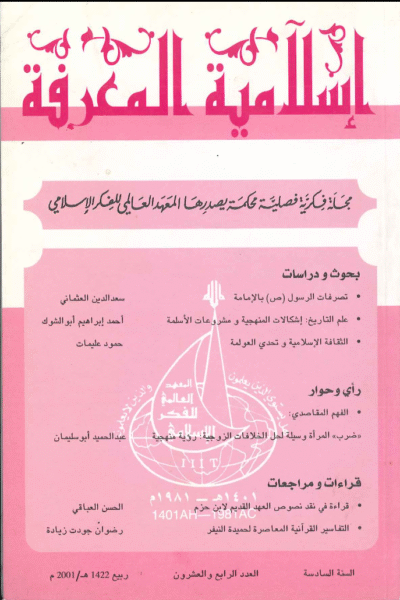
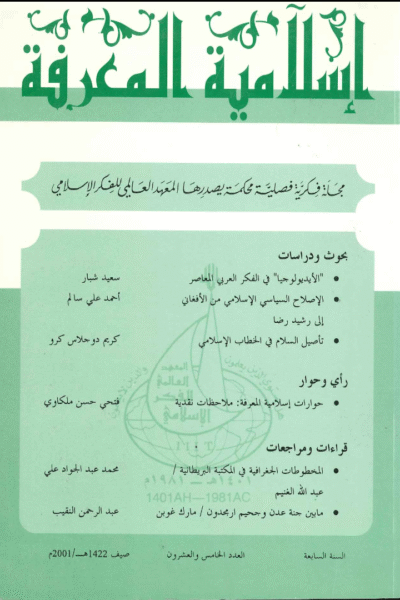
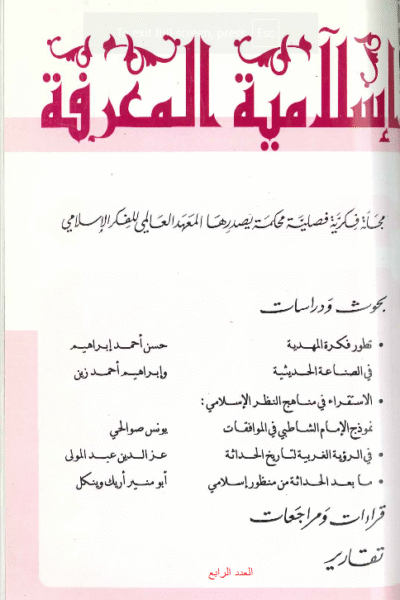
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.