الوصف
كلمة التحرير
===========
يظن عامة الباحثين –اليوم- أن العلوم والمعارف الإنسانية والاجتماعية المعاصرة خرجت من رحم الفلسفة الغربية، وانبثقت عن الرؤية الغربية، وأن الغربيين قد انفردوا ببناء صروحها وإعلاء بنيانها، وأن المسلمين لم يعرفوا كثيرا من هذه العلوم من قبل، ولم يقدموا فيها الكثير، وأن الذين تناولوا هذا النوع من المعارف أو بعضها من علماء المسلمين مثل الغزالي وابن رشد وابن خلدون ومَن إليهم إنما كانوا مترجمين للتراث اليوناني أو الإغريقي الهيليني.
فالمسلمون –في نظر هؤلاء- أمة عنيت بالنقل والرواية، ولم يعنوا إلا بشكل منفرد بالفلسفة، وما يمكن أن يتولد عنها من معرفة؛ ولذلك فإنهم انشغلوا بمعارف “النقل والرواية”، أما الغربيون فإن اهتمامهم بالفلسفة وعنايتهم بها مكنهم من بناء هذه المعارف وتطويرها حتى جعلوا منها علوما ناضجة تستمد علميتها من “فلسفة العلوم الطبيعية”؛ ولذلك فقد اكتسبت هذه العلوم الصفة العلمية بتقبلها وخضوعها للضوابط العلمية والمناهج العلمية الدقيقة.
ثم إن هذه العلوم السلوكية والاجتماعية إنما تعنى بتحليل الظواهر ومعرفتها، والوصول إلى أوصاف دقيقة لها بحيث يمكن التنبؤ بما قد تؤدي إليه، أما تقييم الفعل أو الظاهرة الذي تقوم به العلوم النقلية والفقهية من وصف الفعل بالحل والحرمة أو الإباحة، فتلك أمور لا تتدخل فيها العلوم السلوكية والاجتماعية؛ إذ دأْبُ الأخيرة أن تحلل الظاهرة وتصفها وتجعلها مفهومة مدركة يمكن التنبؤ بما قد تبلغه أو تؤدي إليه.
هذا الظن العام أخذ في التراجع خلال الربع الأخير من القرن المنصرم أمام حالتين مهمتين: حالة المراجعة والتفكير النقدي critical thinking في العلوم الاجتماعية والإنسانية ضمن الدائرة الغربية بتياراتها وروافدها من جهة، وحالة تصاعد وتراكم مدارس إعادة التأصيل والتوجيه لموضوعات هذه العلوم وغاياتها ومناهجها من زوايا حضارية ونماذج معرفية مغايرة من جهة أخرى، من قبيل مدرسة “إسلامية المعرفة” ونظائرها من الدائرة الحضارية الإسلامية.
إن حالة المراجعة هذه أثبتت ضرورة السعة والتكافؤ المنهاجي في تعريف المفاهيم الكبرى، مثل “العلم” و”المنهج” بما يتلاءم مع خصائص الطبيعة البشرية وطبيعة الاجتماع الإنساني، ولا يقف بهما عند حدود المادة وعلومها وقياس علوم الإنسان عليها، رغم الفوارق الشاسعة، ومن هنا برزت الحاجة إلى مراجعة …
بحوث ودراسات
==============
يناقش البحث مفهوم التكامل المعرفي وعلاقته بمفهوم إسلامية المعرفة، وأهم التحديات التي واجهت المفهوم، وصور الاستجابات المعرفية لهذه التحديات، ثم الجهود التي جعلت من التكامل المعرفي عنصراً مهماً في محاولات الاستيعاب والتجاوز لعدد من الأطروحات الفكرية التي نظّرت لقضية النهضة والتحدث بمفاهيم وتصورات التجربة الغربية.
قام الموضوع على دراسة تحليلية ناقدة للأدبيات ذات الصلة بالموضوع، وإجراء عدد من المقابلات (المباشرة، وعبر البريد الإلكتروني، والفاكس) مع عدد من الأساتذة المهتمين بقضية التكامل المعرفي ولا سيما الناشطين في مدرسة إسلامية المعرفة.
الملخص
البحث حديث في مسألة تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية في ضوء المبادئ الإسلامية، ويحتاج هذا التأصيل إلى: إعادة النظر في موقع العلوم الإنسانية في خريطة معارفنا المعاصرة في ضوء تراثنا العلمي وأدبياتنا أولاً، وثانياً إيجاد فلسفة وغاية موحدة لكل العلوم، ووحدة في المنطلقات والغايات، وقد ناقش البحث المسائل الآتية:
المسلمون ومسألة تصنيف العلوم، وقدم بثلاث مراحل هي:
اعتماد النموذج الإغريقي، والنموذج الإسلامي، والنموذج الوضعي المعاصر. وأسس العلوم الاجتماعية والإنسانية المعاصرة وهي نفي الأساس العلوي للمعرفة، ومركزية الإنسان الوجودية، والصراع والبقاء للأقوى، وقانون التغير الدائم. ثمّ أسلمة العلوم الاجتماعية أم إنتاجها؟ وخاتمة تتضمن مفارقة وملاحظة.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
وسم المشاركون هذا العمل بأنه إهداء إلى عبد الوهاب المسيري، صاحب الاجتهاد وفقه التَّحَيُّز، وبأنه حوار مع الذات، وفهم للآخر. وعليه فإنَّ هذه المراجعة لهذا الكتاب يتكَبَّدُها الصَّعبُ من جانبيْنِ:
أولهما: الالتزام بقراءة موسوعية لما هو موسوعي، وأعني بذلك: تعدد الموضوعات التي قدَّمَ فيها كلُّ باحثٍ من المشاركين قراءته الخاصة، التي رافقتها منهجيّة خاصّة، جعلَتْ من قراءته لفكر المسيري قراءة جديدة، تُلِحُّ على رَصْدِها ضمنَ مستويي: التأثير، والتأثر. إلا أنَّنَا قد نستبعدُ رَصْدَ تأثيرِ المسيري في أعمالِ مُرِيدِيهِ، والمشاركين في هذا العمل –سواء أَكان إيجاباً أم سلباً- وذلك لأنَّ الأمانة العلميّة تتطلبُ مِنَّا، لتحقيق هذا الهدف، النَّظَرَ في أعمالِ هؤلاء جميعاً، والبحثَ عن فكرِ المسيري فيها، وهذا لا نملك منه إلا هذه المقالات التي كُتِبَتْ حول فكرِ المسيري. ومِنْ ثَمَّ لا نملكُ أنْ نَدَّعِيَ أنَّ حضورَ فكرِ المسيري فيها كانَ تلقائيَّاً، وانْ صَرَّحَ بعضُهم أنه قد أفادَ من المسيري على المستويين: المعرفيّ، والإنسانيّ. وعليه فإنَّهُ لَمِنَ الأجدر بنا أنْ نرصدَ حالة التأثُّر، والتي تعني هنا: الصورة المعرفيّة التي شَكَّلَهَا كُلُّ باحثٍ من المشاركين، وقدْ أرادوا – جميعاً-من القارئ أن يتلمَّسَها، ثم يدركَهَا من المحتفَى به هنا، عبد الوهاب المسيري.
وثانيهما: رصدُ الإنسانيّ والأكاديميّ في هذا العمل؛ للإدلاء بشهادة إضافية، ربَّما تكون هامَّة لمثله، وما قد يتبعه لاحقاً من أعمال، قد يشكِّلُ فيها صفوة من المفكرين المسلمين جماعة وظيفية راقية، تأخذ على عاتقها إبراز نماذج معرفية حية. ولعلنا ندرك حاجتنا لهذا الأنموذج الذي سَيُمَكِّنُ المثقف العربي المسلم من استعادة الثقة بقدرة ذاته على الإبداع ومحاكاة الآخر …
——————–
المؤلف كان أستاذاً في معهد الدراسات الثقافية واللغوية، جامعة كيو Keio University في العاصمة اليابانية طوكيو. وكان لامعاً في الدّراسات المهتمّة بالقرآن والثقافة الإسلامية. ويلاحظ أنّ عددًا من الدّارسين للإسلام والثقافة الإسلاميّة من الغربيين يرجعون إلى مؤلّفاته. وهو في كتابه الذي نعرّف بمادّته العلمية الآن يحيل إلى كتاب آخر له يبدو مهمًّا في فهم البنية المفهومية للقرآن الكريم، ويحمل عنوان: The Structure of the Ethical Terms in the Koran.
ويبدي المؤلف في هذا الكتاب اقتدارًا كبيرًا في فهم القرآن الكريم والشعر العربيّ، كما تنمّ تأمّلاتهُ على إلمام كبير بتاريخ الثقافة الإسلامية منذ نشأتها الأولى إلى عصور ازدهارها ونمائها. ويستشعر قارئ كتابه رصانته الكبيرة واتّزانه واحترامه الكبير لكتاب الله سبحانه وللمفهومات القرآنية.
أعد كاتب هذا التعريف ترجمة عربية لهذا الكتاب، في طريقها إلى النشر إن شاء الله. أما الكتاب نفسه فقد تناول المؤلف فيه تغيّرَ دلالات الألفاظ العربية التي استخدمها القرآن الكريم عمّا كانت عليه في الجاهلية، وقصد من ذلك إلى بيان أنّ هذا التغيّر الدلاليّ عبّر عن أمر غاية في الأهمية، وهي نظرةٌ جديدة كلّ الجدّة إلى العالم، تقابل ما يسمّى بالألمانية Weltanschauung، أو رؤية العالم. كما يذكر مؤلّفُ الكتاب الأستاذ توشيهيكو إيزوتسو Toshihiko Izutsu في مقدّمته أنّه حاول الإسهام بشيء جديد في سبيل فهم أفضل لرسالة القرآن لدى أهل عصره الأوّل، ولدى أهل زماننا أيضًا …

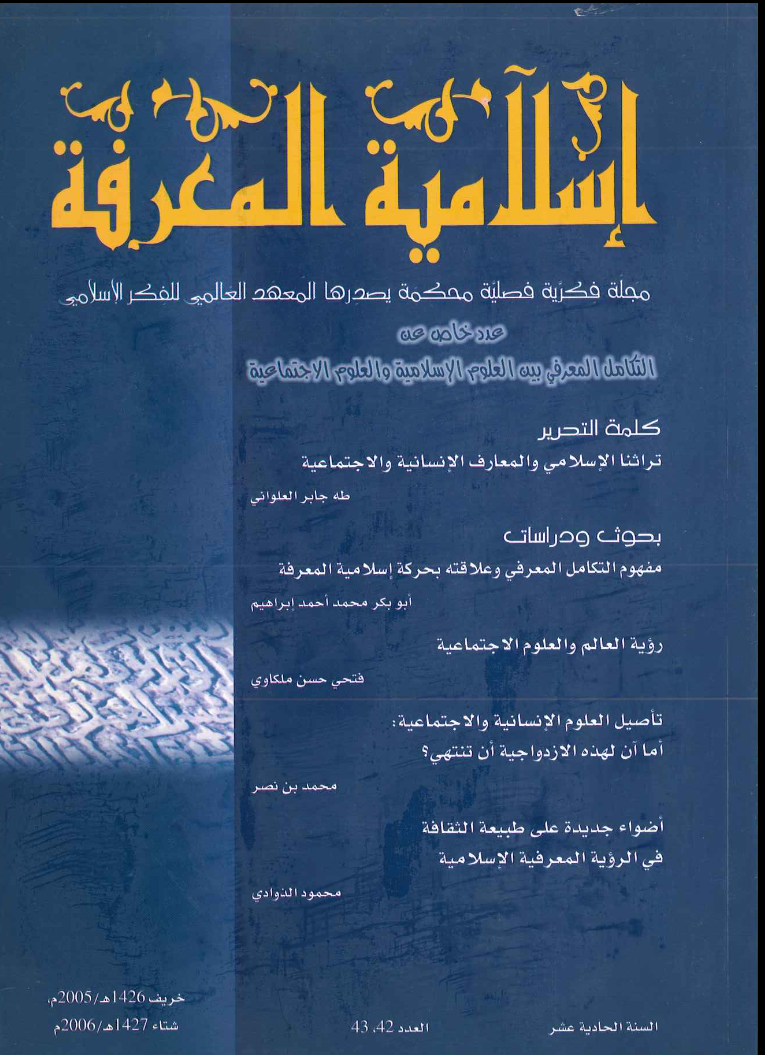
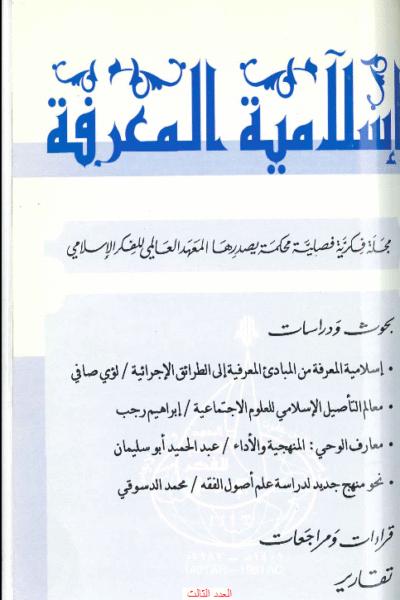
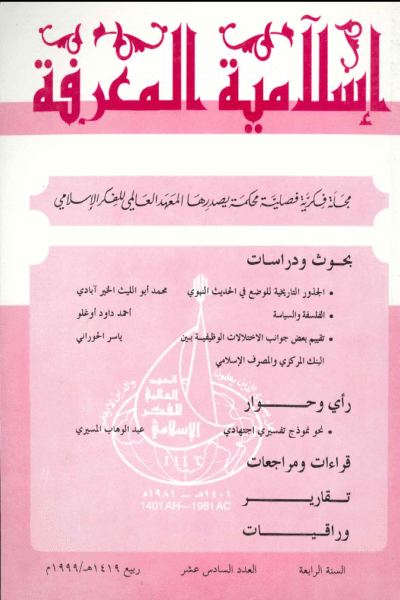
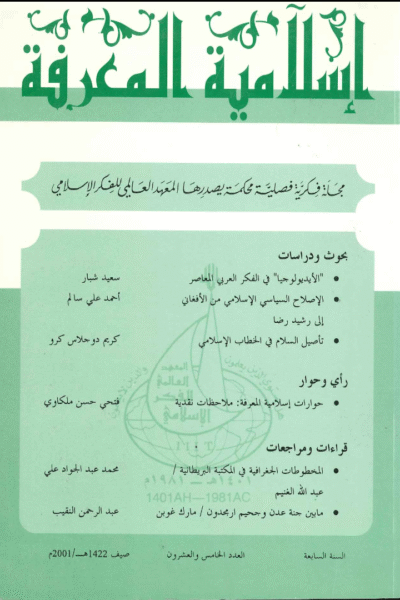
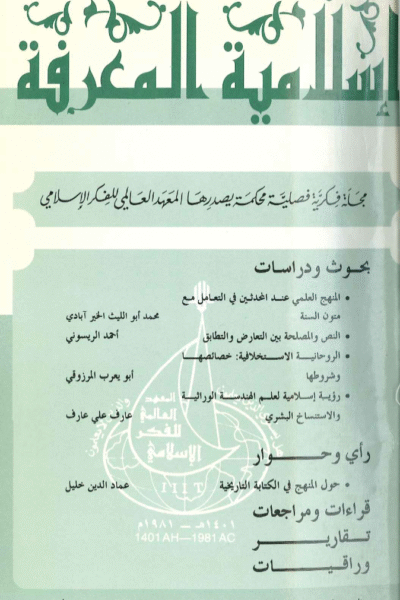
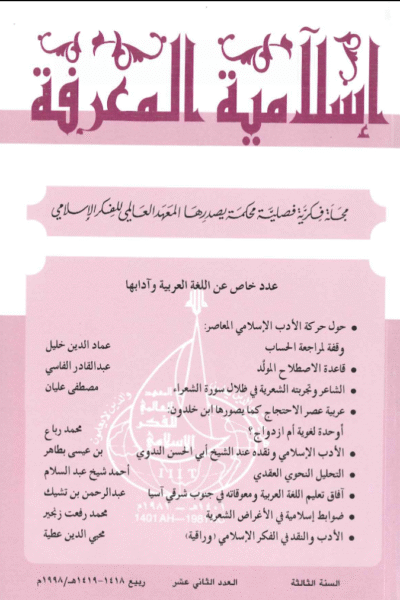
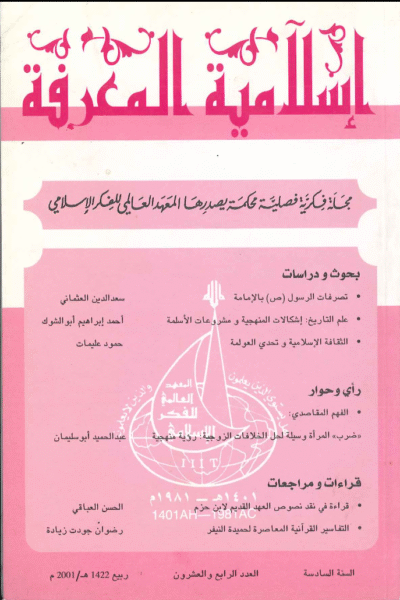
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.