الوصف
كلمة التحرير
===========
واقع المسلمين اليوم، واقع مأزوم بكل المقاييس؛ ففي داخل كل دولة من دولهم استبداد سياسي، وفساد اقتصادي، وتمزق اجتماعي، وانحطاط أخلاقي، وأمية ظاهرة ومقنعة، وانعدام ثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين النخبة والعامة. وبين الدول خلافات ظاهرة وخفية، حالت دون تحقيق معنى الأمة الواحدة ذات الأفق الإنساني الذي يكون شاهدا على الناس بالحق والعدل والخير.
ولم يمنع من الوصول إلى هذه الحالة كل الإمكانات المتوافرة على مستوى المجتمع أو الأمة: من دين توحيدي رباني يفرض العدل والأخوة، أو من موارد اقتصادية هائلة يمكن أن تضمن الرخاء والوفرة، أو من مواقع إستراتيجية يمكن أن يوفر لها فرصة استثمار حاجة الأمم إليها واحترام هويتها ومصالحها.
فالدين عند المسلمين، وبعبارة أدق: الفكر الديني عند المسلمين أصبح ادعاءات متضاربة بين إسلام تقليدي رسمي وشعبي يوظفه المتنفذون عل اختلاف شعاراتهم وتوجهاتهم، ويستعملونه أداة لمشروعيتهم، وإسلام عصري نخبوي تتوزع على تبنيه فئات متضاربة من أقصى درجات الاعتدال إلى أقصى درجات التطرف، حتى إن بعض الناس أصبحوا يشعرون أن الإسلام عبء على المسلمين في علاقات بعضهم ببعض، وعبء عليهم في علاقاتهم بالآخرين، وقد ظهرت بحوث أكاديمية وتوالت تصريحات صحفية …
بحوث ودراسات
==============
يثير البحث إشكالاً يقسم إلى قسمين: أولهما القول بأن جهود الفكر الإسلامي المبكر لم تؤسس علماً مستقلاً يُعنى بدراسة السنن الإلهية على غرار العلوم الشرعية والعقلية. وثانيهما ناتج عن الأول وهو حضور الفقه السُّنني في جهود العلماء المتقدمين كان ضئيلاً ضآلة توحي بضمور هذا العلم في حياة الأمة.
وسيعالج البحث من هذا المنظور النقاط الأساسية الآتية:
الإطار النظري لدراسة قضية السُّنن الإلهية في الفكر الإسلامي المبكر. وحضور الوعي السُّنني والثقافة السُّننية وصوره المنتزعة في جهود العلماء والمتقدمين. ثمّ نماذج للوعي السّنني والثقافة السننية في جهود العلماء المتقدمين.
الملخص
——————–
قراءات ومراجعات
===================
يقع الكتاب في 370 صفحة. ويتكون من قسمين غير المقدمة والخاتمة. في القسم الأول ثلاثة فصول عن: تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حول الحوار مع غير المسيحيين بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة قبل مجلس الفاتيكان الثاني، وهذه التعاليم بعد مجلس الفاتيكان الثاني، وتعاليم مجلس الكنائس العالمي. أما القسم الثاني فيتكون من ثلاثة فصول أخرى: الرؤية المسيحية المعاصرة لموقع القرآن الكريم، ولنبوة محمد صلّى الله عليه وسلم، ولطبيعة المسيح عليه السلام. وتتعلق هذه المراجعة بالقسم الأول فقط. إذ أن أهمية القسم الثاني تجعل من الأنسب تخصيصه بمراجعة مستقلة.
وقد نشر الكتاب “مجلس البحث في القيم والفلسفة” التابع للجامعة الكاثوليكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عام 2002م، ضمن سلسلة “التراث الثقافي والتغير المعاصر.” وقد أصدر هذا المجلس ضمن سلسلة الإسلام إضافة إلى هذا الكتاب المتميز، مجموعة من الكتب باللغة الإنجليزية، منها: الإسلام والنظام السياسي، ودارسة في المنقذ من الضلال …
——————–
الاستشراق من الموضوعات المهمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات العربية والإسلامية المهتمين بهذا المجال؛ وذلك لما له من خصوصية العلاقته الجدلية بالفكر العربي والإسلامي، بل بالإسلام والمسلمين وعلاقتهما بالغرب، وعلاقة الغرب بهما، ودوره النشط في تأجيج الخصومة بينهما، واتهام الإسلام بالأباطيل الزائفة، وتجريده من الخصائص والمبادئ السامية التي حباه الله بها.
والدراسة التي نحن بصددها جاءت بعنوان: “الإسلام في تصورات الاستشراق الإسباني من ريموندس لولوس إلى آسين بلاثيوس”، تأليف محمد عبد الواحد العسيري، هي في الأصل رسالة دكتوراه حصل عليها المؤلف من جامعة السوربون الأولى بفرنسا. وللمؤلف اهتمامات مبكرة بالدراسات الغربية عن الإسلام، وبآراء الغربيين المهتمين بالدراسات الاستشراقية نحو الإسلام والمسلمين.
لقد جاءت حرب الخليج الثانية لتستثير كل المخاوف والتوجسات، وما ترتَّب عن هذه الحرب من خرائط جديدة للعالم، وتنامي اهتمام الفكر الغربي بالإسلام؛ حيث يتابع فوكوياما دراساته المشهورة حول “نهاية التاريخ”، ودراسة صمويل هنتنغتون عن “صدام الحضارات”، لقد أدرج أولهما الإسلام على أنه عالم من الصراعات القومية والأيدلوجية الممتنعة عن الثقافة الليبرالية والديمقراطية. كما رأى ثانيهما وهو (هنتنغتون) في الإسلام انطلاقاً من الأنثروبولوجيا …
تقارير
===================
عقدت الندوة الإقليمية في عمان- الأردن حول “العولمة وانعكاساتها على العالم الإسلامي في المجالين الاقتصادي والثقافي”، خلال الفترة 5-6 ربيع ثاني 1427ﻫ، الموافق 3-4 أيار (مايو) 2006م، بالتعاون بين المعهد العالمي للفكر الإسلامي- مكتب الأردن، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وجامعة آل البيت- الأردن، وجاءت فكرة الندوة إدراكاً من المؤسسات الثلاث لأهمية فهم ظاهرة العولمة، والوقوف على آثارها ومن ثم تحديداً وجه التعامل معها، باعتبارها تحديات وفرص يمكن الإفادة منها، وهدفت الندوة إلى تحليل ظاهرة العولمة وتحديد المفاهيم والأفكار ذات العلاقة بها، وفهم الصور التي تتمثل فيها في المجال الاقتصادي والثقافي. واقتراح سبل التعامل مع التحديات التي تمثلها للعالم الإسلامي والفرص التي تتيحها.
وقد دارت جلسات الندوة السبع -ما عدا جلستي الافتتاح والتوصيات- واقع ظاهرة العولمة في الحضارة المعاصرة، وتأثير العولمة في القيم، والنظر إلى العولمة باعتبارها تحديثات وفرص، وأثر العولمة على اللغة، وانعكاسات العولمة على اقتصاديات العالم الإسلامي، والتحديات التي تواجه الأسرة والواقع الاجتماعي في ظل العولمة، وجهود مناهضة العولمة. وقد شارك في الندوة خمسون باحثاً من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين وسوريا والعراق والسعودية. والبحرين وماليزيا والأردن.
أما جلسة الافتتاح فقد تضمنت –بعد الافتتاح بالقرآن الكريم- كلمة اللجنة …
——————–


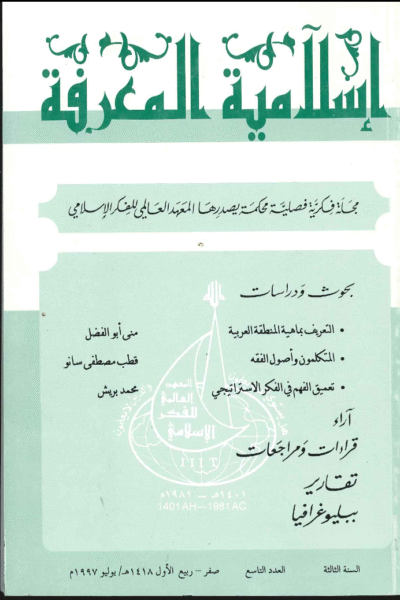
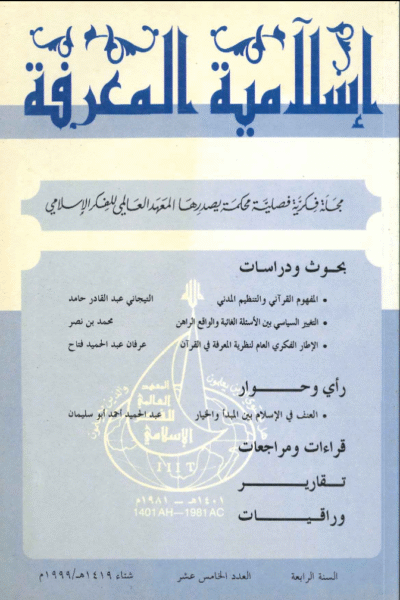
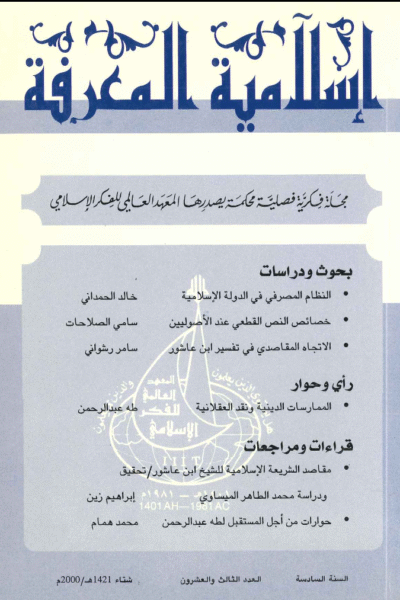
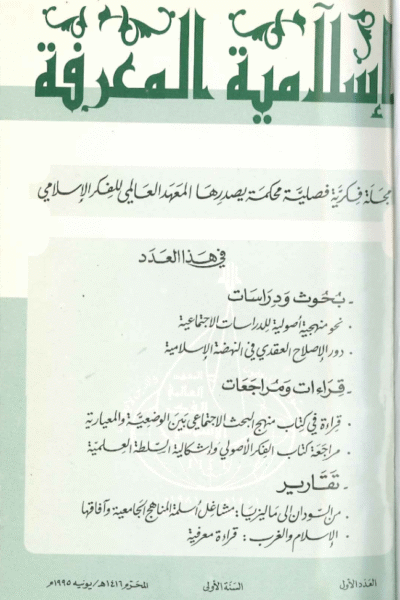
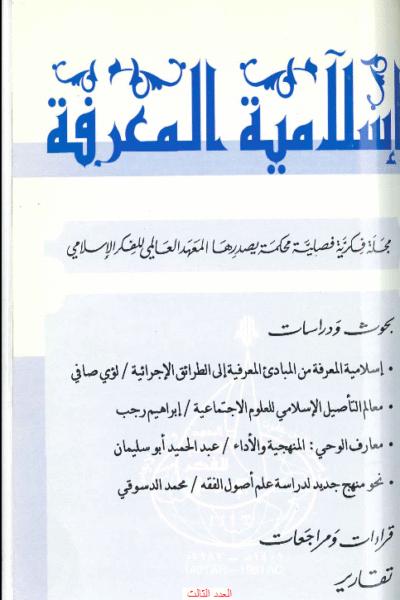
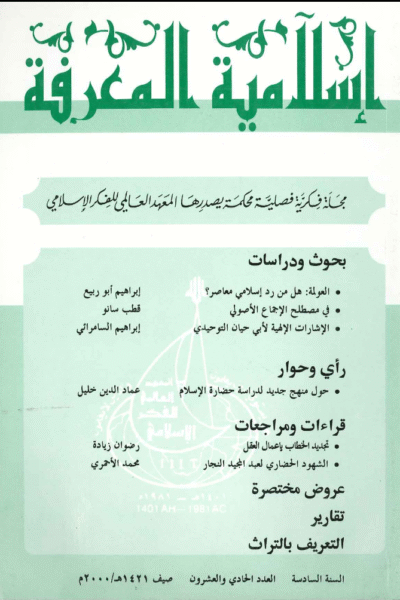
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.