الوصف
كلمة التحرير
===========
اللغة والدين هما المحددان الأساسيان لهوية أية أمة من الأمم وانتماءاتـها على مر التاريخ. ويزداد هذان المحددان قوة في ذلك، إذا التحما في بوتقة واحدة، بحيث تكون اللغة القومية لجماعة بشرية ما، هي نفسها لغتها الدينية.
ورغم المحاولات الحديثة والحثيثة، لإعادة تشكيل الأمم والشعوب وانتماءاتها والانتماء إليها، على أسس جغرافية وسياسية وقانونية، فإن ذلك لم يلغِ ولم يضعف قوة الانتماء الديني والانتماء اللغوي. فما زال الولاء القومي واللغوي، والانتماء الديني، يعلوان فوق الانتماء الوطني السياسي، في حالة ما إذا كانا مختلفين.
وتشكل اللغة الأمّ، لغةُ التنشئة والتعامل، حضنا وغذاء نفسياً وعاطفيا لشخصية الإنسان. فالمفهوم الأولي والبسيط، السائد عن وظيفة اللغة، بأنها أداة للتواصل والتفاهم بين الناس فحسب، هو جزء من الحقيقة، وليس كل الحقيقة. ووصف اللغة بعبارة (اللغة الأم)، هو التعبير الحقيقي الصادق عن دور اللغة ووظائفها. فاللغة (الأم)، تعني أن للغة وظائف كوظائف الأم. وهذا التعبير بمعناه المذكور، يعفيني من إطالة الشرح والبيان لما تضطلع به (اللغة الأم)، من وظائف وخدمات نفسية وعاطفية وتربوية وتثقيفية وتواصلية، مع المحيط القريب والبعيد. بل حتى هذه الوظيفة التواصلية للغة، فإنها ليست بالمحدودية التي تتبادر إلى الأذهان، وهي التخاطب والتواصل بين الناس المتعاصرين، بل هي، فوق …
بحوث ودراسات
==============
يهدف البحث إلى تقديم بعض الملحوظات المنهجية الضرورية للدراسة المتكاملة للسنن، كما يهدف إلى تقديم مقاربة تساعد على التعامل المنهجي مع السنن وإبراز خصائص الرؤية القرآنية في نظرتها تجاه هذه السنن. وتنتظم هذه الدراسة المحاور الآتية:
الإطار المنهجي العام لمقاربة مسألة السنن الإلهية حضاريا. وملحوظات حول مسائل قضية السنن من خلال الفكر الإسلامي المتقدم. وملحوظات حول التناول العلمي المعاصر لقضية السنن. وملحوظات منهجية حول التناول الحضاري للسنن.
كل ذلك وفق منهجية استقرائية، وتحليل النصوص. وخاتمة فيها نتائج ومجالات يجب الاهتمام بها.
الملخص
البحث دراسة في مفهوم (تفسير القرآن بالقرآن) من خلال تحليل ألفاظه إفرادا وتركيبا، مستثمرا معطيات الدرس اللغوي، وموظفا لها في استخلاص خصائـص القـرآن، وخصـائـص تفسيره. كما حاولت الدراسة مقاربة إشكالات جوهرية مرتبطة بالتفسير عموما، وبتفسير القرآن بالقرآن على وجه الخصوص. ثم محاولة تأصيل منهج هذا النوع من التفسير، مع بيان سبل استقصاء أدواته الإجرائية وسبل توظيفها. وقد جاءت الدراسة بفصلين بارزين داخلهما عناوين فرعية كثيرة والفصلان هما: مفهوم تفسير القرآن بالقرآن، والمنهج، ثم خاتمة فيها نتائج.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
مؤلف الكتاب مفكر ورجل قانون فرنسي معاصر، أولى اهتماماً كبيراً لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وكتب عدداً من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين. ويعدّ كتابه (إنسانية الإسلام)[1] الذي ينبثق عن الاهتمام نفسه، علامة مضيئة في مجال الدراسات الغربية للإسلام، بما يتميز به من موضوعية، وعمق، وحرص على اعتماد المراجع التي لا يأسرها التحيّز والهوى، فضلاً عن عدم انغلاقه إزاء الكتابات الإسلامية نفسها.[2] وقد عبّر عن ذلك في أكثر من موقع.[3] ولقد كان الرجل أميناً بحق لهذا المنهج، ولتلك الضرورة، فقدم عرضاً للإسلام وتحليلاً لجوانبه كافة، نادراً ما يقدمه أحد من الغربيين بمثل هذا العمق والشمول.. كما أنه تميّز بقدر كبير من الحساسية والذكاء، إزاء الملامح الأساسية التي تمثل جملة الإسلام العصبية، ومراكز ثقله وفاعليته.
والمادة التي يقدّمها “بوازار” غزيرة بشكل يلفت الأنظار، موزعة على صفحات الكتاب وفصوله كلّها، الأمر الذي يقتضي جهداً كبيراً في محاولة السيطرة عليها، ومتابعة مجرياتها الأساسية. ومن أجل هذا الهدف، وانسجاماً مع المنهج الذي اعتمدناه في هذا البحث، فإننا سنسعى لأن نضع أيدينا على الموضوعات الأساسية الكبيرة التي يعالجها الباحث، ثم متابعة كافة النصوص والشهادات، التي تغذي كل واحدة من هذه الموضوعات الكبيرة، من أجل استخلاص المغزى الذي يريد المؤلف أن يقوله عن هذا الموضوع.
العقيدة والشريعة والعبادة والأخلاق، ومبدأ العدل والمساواة، وقضية انتشار الإسلام والتعامل مع الآخر، هي المسارات الأساسية للكتاب، التي يمكن أن تندرج فيها، وتغذّيها، كافة النصوص التي تتجمع حينا في صفحات متقاربة من كتاب “بوازار”، وتنتشر وتتفرق أحياناً أخرى. وهذه المسارات لا تنفصل عن بعضها في الواقع، بل إنها تتداخل وتتشابك، وتأخذ وتعطي، وتتبادل التأثير، وما هذا التقسيم أو الفصل النمطي، إلا لأغراض التوضيح والسيطرة فحسب …
——————–
هذا الكتاب في أصله، دراسة قدمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1408ﻫ/1987م، وقام المعهد العالمي للفكر الإسلامي بتقديمه للمثقف العربي المسلم في عام 1991م، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية.
يعرض المؤلف للمساجلة القائمة بين المنهجين المتقابلين في العلوم الاجتماعية، الوضعي والمعياري. ويقدم قراءة ناقدة لكل منهما، في ضوء أصول النشأة التاريخية الغربية، ثم ينقضهما بمحاكمتهما إلى أسسهما الأيديولوجية والمنهجية. ولا يقف نقده عند من يمثل هذين المنهجين من الغربيين ، بل هو يطال كذلك، ممثليهما في الوطن العربي، متسائلا عن إمكانية إيجاد بديل منهجي لهما في العالم العربي الإسلامي.
وهو لا يكتفي بالنقد والتساؤل، بل نجده مؤيداً، لأي جهد يعرض مشروع علم اجتماع إسلامي بديل، مقدماً الدلالات المنهجية التي تؤيد هذا التوجه. وهذا المطلب المنهجي الذي ينادي به الباحث، كان باعثاً مهماً في تأكيده على أهمية مراعاة الضوابط المنهجية في البحث الاجتماعي لأسلمة العلوم الاجتماعية، ومن ثم نحو صياغة منهجية لدراسة التراث الاجتماعي في الإسلام …
——————–

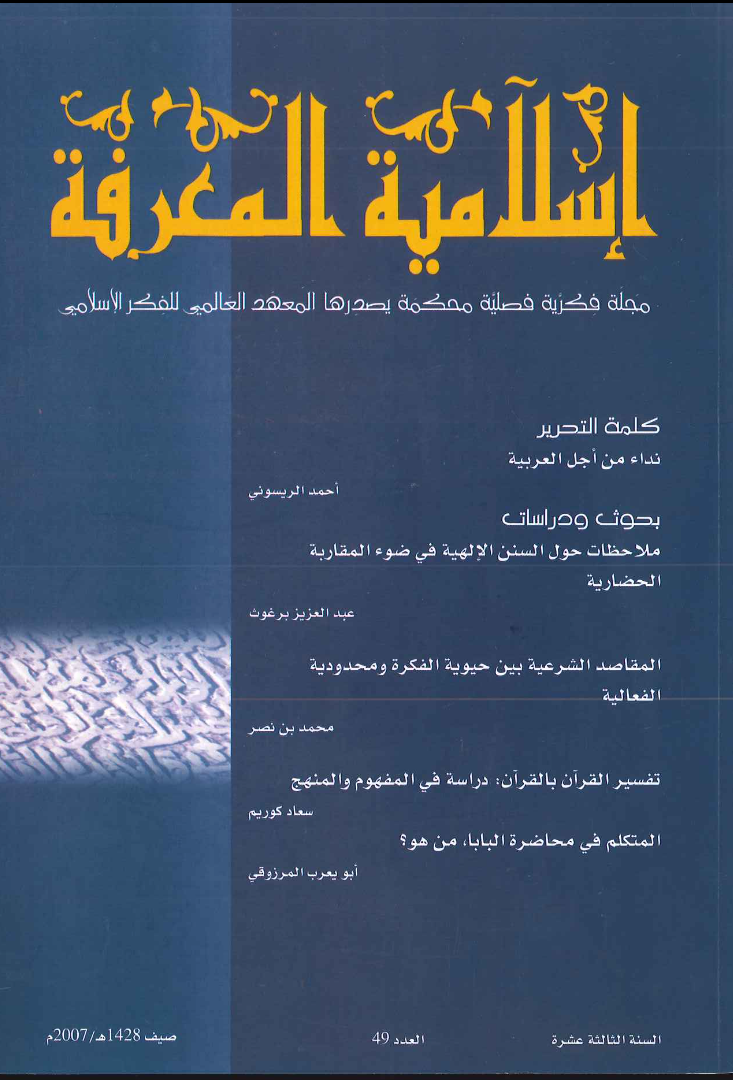
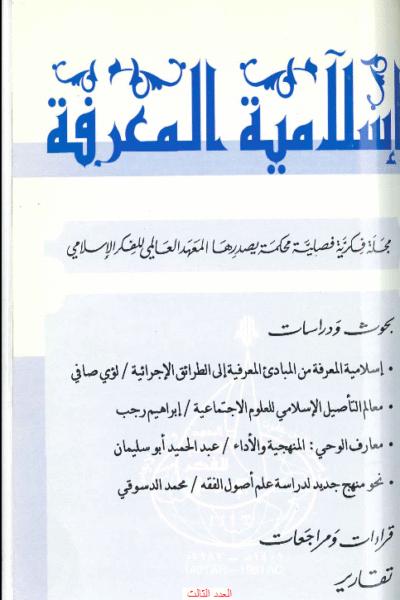
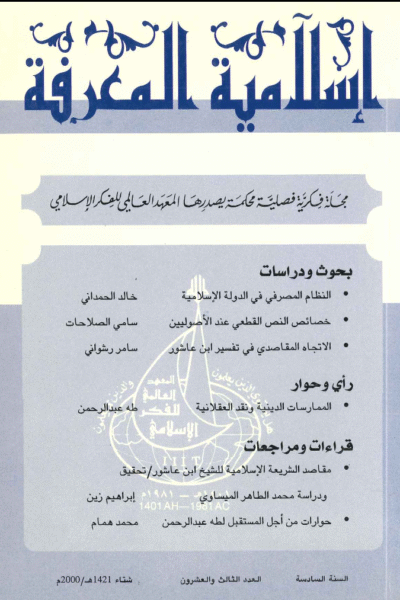
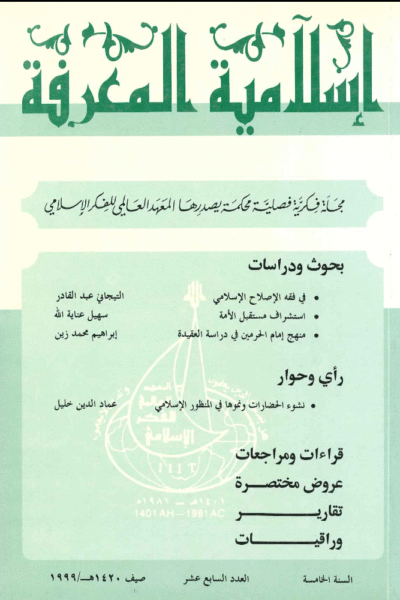
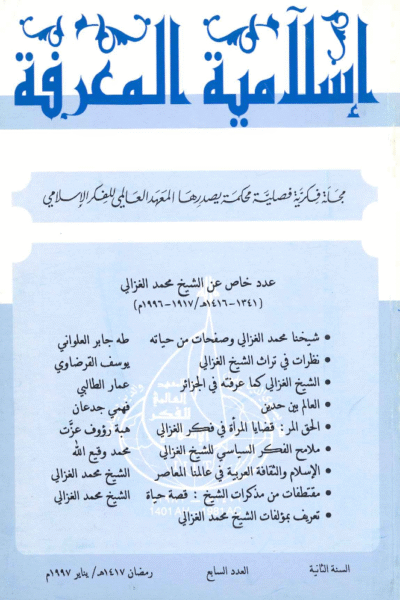
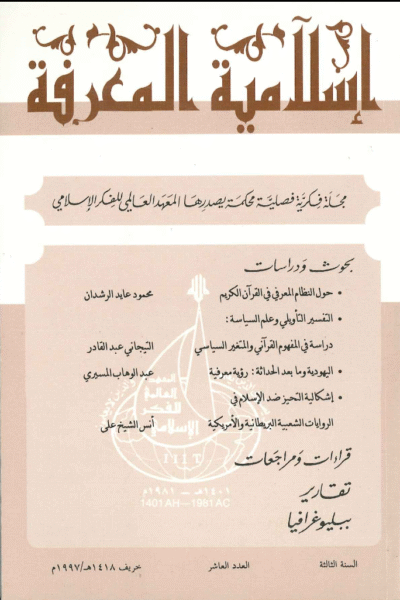
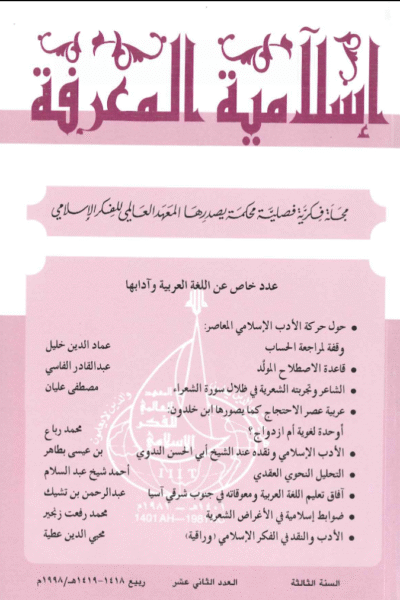
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.