الوصف
كلمة التحرير
===========
مَرّت قرونٌ عديدة على أزمةِ تدهوُرِ الأمَّة، وانحطاطِها وتمزُّقِها، ونيْلِ الأعداءِ منها، ولم يَكن نصيبُ جهودِ الإصلاحِ أكثرَ من معالجاتٍ لَمْ تمنعْ استمرارَ التدهورِ الذي أمْسَى تراجعاً وانهياراً، حين برَزَ إلى الساحةِ مُنافسٌ حضاريٌّ، ملَكَ من المعرفة والقدرة والفعالية والمبادرة، ما لم تعدْ تتحلَّى الأمَّةُ بشيءٍ منه، ولا تملكُ أياً من مقوماتِهِ.
وحَاوَلَتْ الأمَّةُ -عَلَى مَدَى القُرُونِ الثلاثةِ الأخِيرة- النهوضَ من الكَبْوِة، واستعادةَ القدرة والعافية. ولكن جهودها اتّسمت بالتخبط، وعدم القدرة على تحديد رؤيتها، فهي ما بين محاكاة للغرب القاهر، أو اجترار لذكرى أطلال التاريخ. واتصفت ثقافة الأمة -خلال هذه الفترة- بالانفصام والانشطار بين ثقافةٍ مدنية أجنبية مُستلِبة، وثقافةٍ دينية مُنْبَتَّةٍ عن أسئلة العصر وتحدياته. وفشلت مشاريع الإصلاح المدنية الوافدة في تحريك كوامن الطاقة في كيان الأمة، كما فشلت صيحات التقليد التراثية في إعادة بناء قدرات هذه الأمة، وجاءت الرؤى والحلول -في مجملها- سطحيةً تلفيقيةً، تتباهى بالموروث، وتنظر بقصور في الاتجاه الخاطئ، وتلقي اللوم -في رهبة وسلبية وعجز- على الآخر، ولا تَكِلُّ من البحث عن كبوش الفداء.
ومع مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، وإبَّانَ الاستعمار الأوروبي لكثير من بقاع العالم الإسلامي، بدأ تطلعٌ فكري ثقافي يعيد النظر في تشخيص واقع الأمة، وجهود نهوضها، ويبحث عن حلول أكثر عمقاً وجديَّةً لمعالجة تخلفها، وضعف طاقاتها وإمكاناتها، وعدم القدرة على بناء مؤسساتها …
بحوث ودراسات
==============
يرمي البحث إلى النظر في بعض المفاهيم التأسيسية التي قام عليها القول بمقاصد الشرعية؛ أملا في تبين آفاقها النظرية، ومسالكها المنهجية. ولما كان موضوع المصلحة هو المحور الذي دارت حوله الأنظار في قضية التعليل، مثلما هو قوام مقولة المقاصد، فقد جرى التوسع في مناقشته، واستقصاء القول فيه وما تفرع عنه من مسائل مثل العلة، والحكمة، والمصلحة، والمناسبة، والغرض. . . ضمن الأطر الآتية: تعليل الأحكام والبحث عن معقولية التشريع وحكمته، ومقاصد الشريعة والإطار التأصيلي لمفهوم المصلحة، وخاتمة تتضمن حديثا عن مفردات البحث، ونتائج.
تتناول الدراسة مدى تأثير الخلفية الثقافية للمفسر، والممارسات الثقافية المحيطة به، في تفسير الإشارات القرآنية الأنثوية، مما يفضي إلى اختلاف المواقف من التطبيقات القائمة تأييدا ورفضا. . . وتهدف الدراسة إلى إبراز هذه التأثيرات وبيان تطبيقها، وذلك بمنهج تحليلي لمقتبسات من نصوص التفسيرات، والتحليلات الحديثة ضمن الأطر الآتية: الإشارات القرآنية الأنثوية، التأثير الثقافي في تفسير الآيات، مؤثرات ثقافية في التفسير، آليات التفسير، مسائل في الإشارات القرآنية الأنثوية ذات صلة بالخصائص المميزة للمرأة (شخصيتها، حقوقها، تعدد الزوجات، القوامة، اللباس، الميرات. . . ” ثم خاتمة وملاحظات واقتراحات.
الملخص
تأتي الدراسة إسهاما في تأصيل قضية الخلاف مع الآخر المخالف في المرجعية وتقعيدها، من خلال أصول التراث الإسلامي وفق المحاور الآتيـة: الأسـس المرجعيـة لتدبيـر الاختلاف مع الآخر في القرآن الكريم (الأساس القرآني، والأساس النبوي)، وضوابط تدبير الاختلاف في النظر الأصولي (الضوابط الكلية، والضوابط التفصيلية، هي: ضوابط استدلال، وضوابط سؤال وجواب، وضوابط قدح في الدليل. ثم خاتمة أكدت على قضية الاختلاف مع الآخر بحيث تدبيرها في المرجعية الإسلامية بأحكام وأصول رصينة، وقواعد مكينة.
قام العمل في البحث على جمع مفردات منتخبة من منظومتنا العقدية، وسميت بالأنموذج الإيماني التي وظفها المسلمون في الوقت الراهن في مختلف أشكال خطاباتهم المعروضة على الإنترنت، واستقصاء هذه المفردات، لكي تتضح أمامنا مسارات المعالجات العقدية لمسائل تطرح بإلحاح على المسلم المعاصر، مثل: الإيمان، والكفر، والبدعة، وغيرها. إن البحث مسح معلوماتي سيوفر لعلماء الأمة مادة لا بد من دراستها للإفادة منها، وتقويمها. أما محاور البحث فهي: الفضاءات المعلوماتية، الأنموذج الإيماني لصفحة الويب، إنشاء خارطة مفاهيمية للأنموذج، بيانات الأنموذج ومخططاته، وخاتمة.
رأي وحوار
===================
——————–
قراءات ومراجعات
===================
مؤلِّف هذا الكتاب هو الدكتور أنور الزعبي؛ باحثٌ في الفكر العربي الإسلاميّ، وهو يحمل دكتوراه الدولة في الفلسفة، وألّف أحد عشر كتاباً في قضايا الفكر العربي الإسلامي، وحاز جوائز عدة. وكتابه هذا، الذي نقف على مراجعته؛ وافٍ في موضوعه، شاملٌ في منحاه ومنهجيته، كونه جاء تتميماً مستقصياً لانشغالات مؤلفه بقضية المعرفة والمنهج، التي بسط رؤاها وآفاقها في عدد من كتبه السالفة الصدور. وقد جاء هذا الكتاب ليعالج -باستفاضة- “إشكاليّة تمثّل الفكر العربي الإسلامي بكليته وآفاقه.”
وإذ استشعر المؤلفُ هذه الإشكاليّة، وأثرَها في الحياة الحاضرة والمستقبليّة للأمة، فقد نهز لاستعماق آفاقها ونواحيها، وبواعثها ونتائجها، فبسط أغراضه من هذه الدراسة، ومنحنى معالجته ومساءلته لها، ومنهجيته في التدليل عليها، ومن ثم ضبط اتجاهاتها ومراحلها، وأصّل قواعدها الفاعلة والمنفعلة، في مقدمته التي صدّر بها كتابه. وهي مقدمة تفصح عن الركائز الأساسية الثلاث: الغرض، والمنحنى، والمنهجيّة، التي احتكم إليها المؤلف في تجلية أبواب كتابه التسعة.
وتأتي أهميّة هذه الدراسة، من استيعابها واستجماعها للمسائل المتعددة التي عُني بها المفكرون المسلمون، وجهودهم المعرفية والمنهجية في مختلف حقول الفكر الإسلامي، ومشتملاته من المعارف والعلوم، ومواطن اختلاف كل مفكر عن آخر، أو اتفاقه …

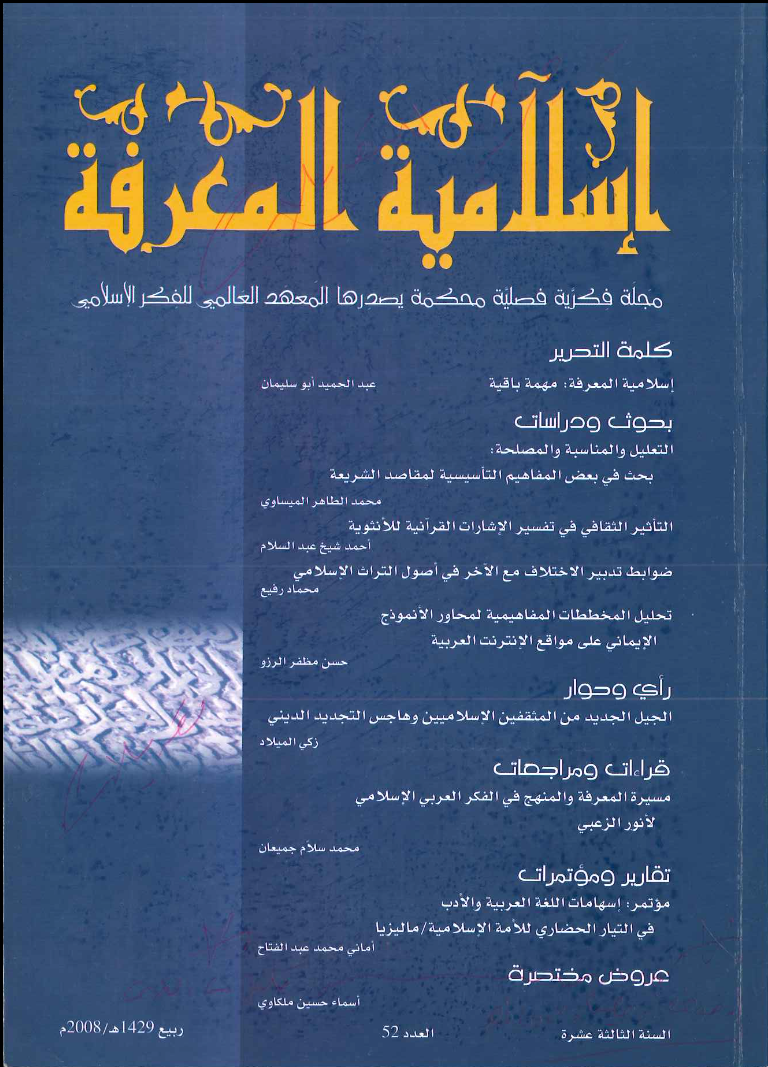
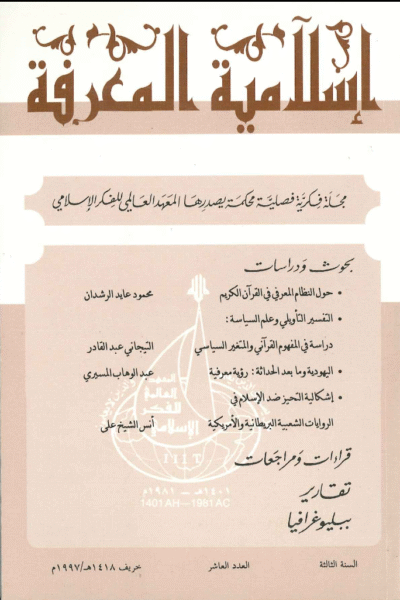
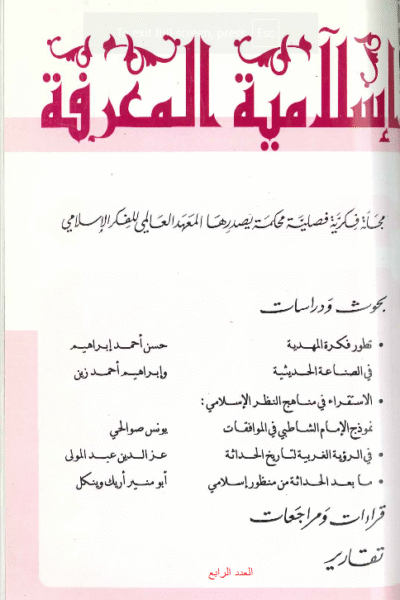
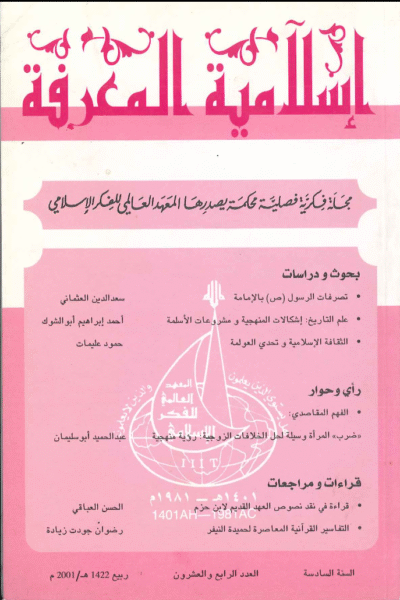
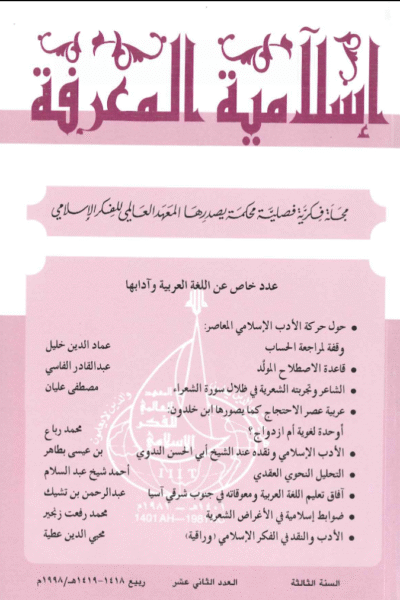
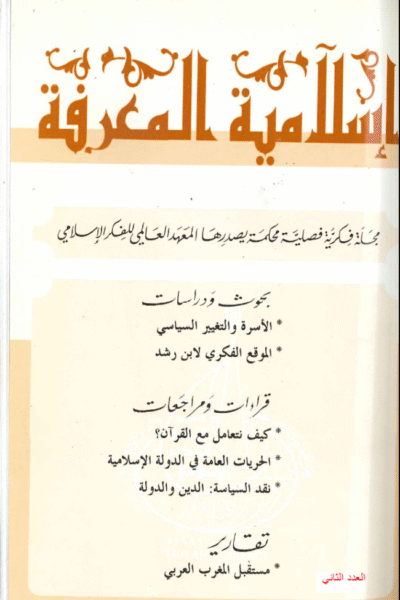
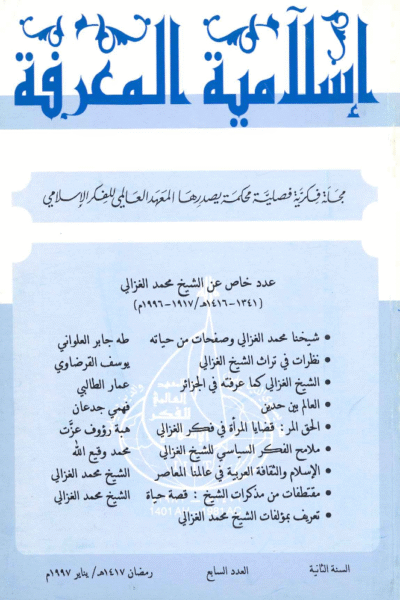
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.