لماذا القرءان دون الكتب السماوية الأخرى ؟ إسلامية المعرفة ــ المفاهيم والقضايا الكونية
تدور أحداث هذا الفيديو، بعنوان “لماذا القرآن دون الكتب السماوية الأخرى؟ أسلمة المعرفة – مفاهيم وقضايا كونية” لمحمد أبو القاسم حاج حمد، حول مفهوم “أسلمة المعرفة” [01:46].
ويوضح المتحدث أن هذا المفهوم لم ينشأ من مؤسسات رسمية بل من خلال حركة فكرية استمرت 400 عام، مع ظهور معاهد منذ عام 1982 [00:24]. ويقر بجهود الدكتور إسماعيل الفاروقي كمؤسس [00:47] ويذكر آخرين مثل الدكتور طه جابر العلواني، وجمال برزنجي، وأحمد التوتنجي الذين ساهموا في تطويره المؤسسي والمالي، خاصة في فرجينيا بدعم من الراجحي والقوانين الأمريكية [01:08].
يتناول جزء كبير من الفيديو الانتقادات الشائعة وسوء الفهم المحيط بمصطلح “أسلمة المعرفة”. يتساءل بعض النقاد كيف يمكن “أسلمة” المعرفة، وهي مفهوم إنساني عالمي [02:09]. ويروي المتحدث حكاية حيث اقترح الدكتور رُشدان بشكل هزلي أسلمة المعرفة بوضع قطعة من الورق على رأسه، مما يوحي بارتباط سطحي بين الفكر الأزهري والفكر الغربي [02:27].
ويجادل المتحدث بأنه إذا كانت “المعرفة الإسلامية” تشير إلى المعرفة الدينية، فلماذا تستثني الأديان الأخرى؟ [05:01] وينتقد فكرة تخصيص المعرفة البشرية، التي هي مشتركة بطبيعتها [05:09]. ويسلط الضوء أيضًا على الانتقاد الذي يرى أن “أسلمة المعرفة” انتهازية، أشبه بـ “البنوك الإسلامية” أو “كوكاكولا الإسلامية”، تستغل مصطلح “الإسلامية” لجذب الانتباه بدلاً من الجوهر [04:12].
ويحدد هيكل محاضرته المكتوبة، والتي تبلغ 23 صفحة ومقسمة إلى ثلاثة أجزاء: “أسلمة المعرفة: مفاهيم وقضايا كونية” (17 صفحة)، وقراءات مصاحبة، وآيات قرآنية ذات صلة [06:05]. ويشير إلى ندوة القاهرة التي ناقشت المنهجية المعرفية كجزء من برنامج أسلمة المعرفة [06:42]، ويسرد الحضور مثل الدكتور إبراهيم، والدكتور عبد الوهاب المسيري، والشيخ محمد الغزالي [07:00].
ثم يتعمق المتحدث في منهجية البحث لأسلمة المعرفة، والتي يذكر أنها تستند إلى التفاعل بين ثلاث جدليات: الغيب، والإنسانية، والطبيعة [11:06]. ويؤكد على ضرورة ربط الغيب بالإنسانية والطبيعة دون أن يسيطر الغيب عليهما [01:11:24]. ويناقش أيضًا مفهوم التسامي البشري والسعي اللانهائي، مستخلصًا روابط بالمفكرين الوجوديين مثل هيغل، وسارتر، وألبير كامو [13:31].
يُعد “الجمع بين القراءتين” جانبًا أساسيًا من منهجه المستمد من سورة العلق [15:00]:
- القراءة الأولى: “اقرأ باسم ربك الذي خلق” [15:10]، وهي قراءة كونية مستمدة من الوحي الإلهي من خلال القرآن [15:47].
- القراءة الثانية: “اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم” [15:32]، وهي قراءة موضوعية دنيوية [16:23].
ويشدد على ضرورة فهم القرآن نفسه على أنه “كون” أو “عالم” يمكن دراسته، وليس مجرد نص مقدس للتبرك [17:01]. ويدعو إلى إثبات علمي للطبيعة المطلقة للقرآن في هيكله ومعانيه، موازياً للوجود الكوني وحركته [18:11]. وهذا يسمح للقراءة القرآنية بالسيطرة على قراءة الكون المرئي [18:51].
ويبرز المتحدث تحديًا رئيسيًا: كيف يمكن لمنهجية مستمدة من الوحي الإلهي الغيبي أن تكون منهجية قابلة للقراءة تعتمد على الاستنتاج العقلاني أو الاستقراء العلمي؟ [19:09] ويوضح أن الثورة المعرفية منذ الثلاثينيات قد فككت القواعد الصارمة للفيزياء، والعلوم الاجتماعية، والفلسفة التقليدية، محطمة الوضعية التي رفضت الغيب والميتافيزيقا [19:36]. ويؤكد أن هذا التحول المعرفي قد أتاح استعادة العلم للدين وتحريره من قبضة الوضعية [25:25]. ويختتم بالتأكيد على أن القرآن هو المرجع الأسمى [31:37]، وأن ملاءمته كمنهجية يجب أن تثبت من خلال اتساقه اللغوي والهيكلي لتجنب سوء التفسير [32:00].

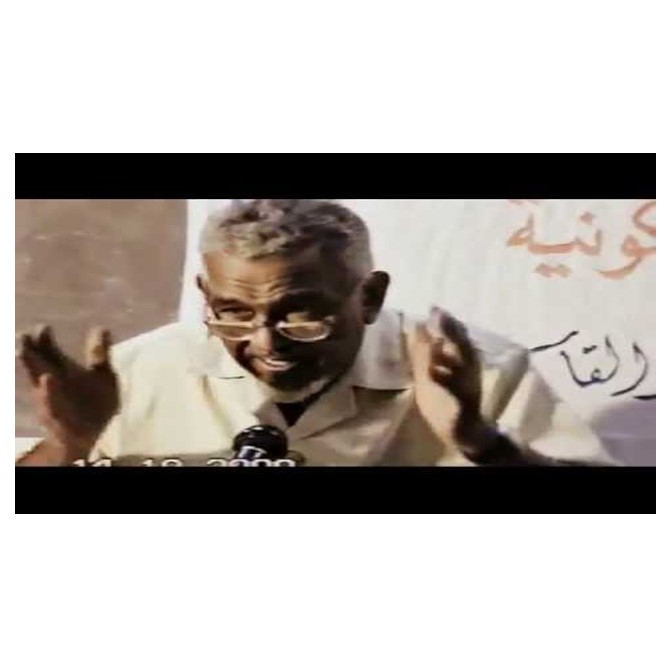

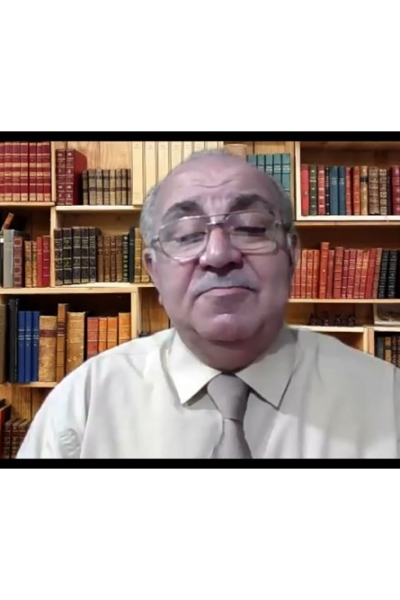

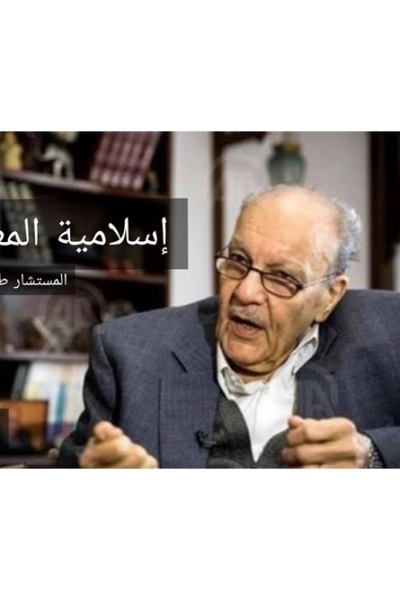
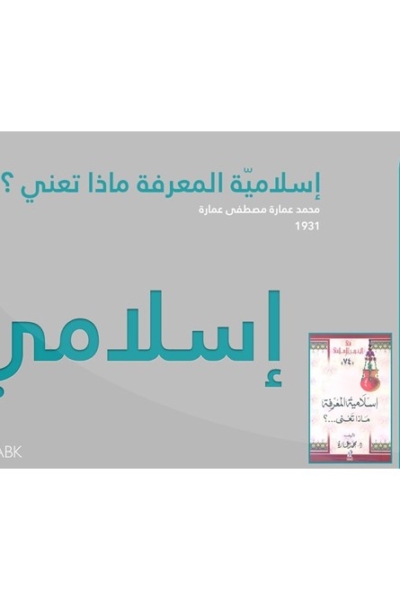
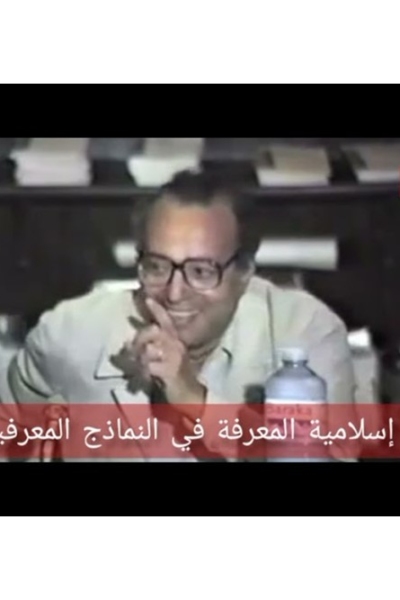
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.