الوصف
الأفكار الأساسية:
-
تعدد المصادر: يؤكد الكتاب أن بناء الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية يعتمد على أربعة مصادر رئيسية: القرآن والسنة (مصدرا تأسيس)، والتاريخ الإسلامي والفقه (مصدرا بناء).
-
المنهجية في التعامل مع القرآن: ينتقد الكتاب المنهج “الجزئي” في تفسير القرآن (تفسير الآية بمعزل عن سياقها) ويدعو إلى اعتماد “المنهج الموضوعي” الذي يجمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد (مثل الجهاد، السلم، الدعوة) ويحللها في إطار الرؤية الكلية للقرآن.
-
ضوابط فهم السنة: يضع شروطاً صارمة للاستدلال بالسنة في العلاقات الدولية، أهمها: ثبوت صحة الحديث، وفهمه في سياقه الصحيح، وربطه بمقاصد الشريعة والأصول الكلية للقرآن.
-
التعامل مع التاريخ: يدعو إلى قراءة التاريخ الإسلامي (خاصة في عهد النبوة والخلافة الراشدة) قراءة استنباطية للعبر والنماذج، وليس مجرد سرد للأحداث، مع ضرورة تطبيق ضوابط نقد الروايات التاريخية.
-
دور الفقه الإسلامي: يرى أن الفقه الإسلامي تراث غني يمكن البناء عليه، لكنه يحتاج إلى “اجتهاد” يتعامل مع المستجدات المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة، ويرفض دعوى إغلاق باب الاجتهاد.
-
الرؤية الكلية: يشدد على أن أي تنظير للعلاقات الدولية في الإسلام يجب أن يُستمد من رؤية عقدية كلية للإنسان والكون والحياة، وأن يرتبط بمقاصد الشريعة العليا (كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال).
-
التكامل لا التعارض: يرفض وجود تعارض حقيقي بين نصوص الشريعة، ويؤكد أن ما يبدو تعارضاً هو توهم ناتج عن قصور في الفهم أو المنهج، ويمكن رفعه بمناهج الجمع والترجيح.
-
قضية النسخ: يتناول إشكالية “آية السيف” والنسخ بشكل متوازن، ويرفض الإفراط (الادعاء بنسخ معظم آيات السلم) أو التفريط (إنكار وجود النسخ مطلقاً)، ويؤكد أن النسخ يحتاج إلى دليل واضح.
-
الدعوة أساس العلاقة: يخلص الكتاب إلى أن “الدعوة إلى الإسلام” هي الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، بينما تكون علاقات السلم أو الحرب أشكالاً متغيرة تبعاً للظروف والموازنات.
-
ضرورة التكامل البحثي: يختم بتوصية عملية بضرورة وجود فرق بحثية متكاملة تجمع بين متخصصين في العلوم الشرعية ومتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
تحليل معمق للكتاب:
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
-
“التنظير لوضوع شديد التشابك والتعقيد مثل العلاقات الدولية في الإسلام، لا يقف عند حد الجمع الميكانيكي بين الآيات الخاصة بالموضوع وتقصي تفسيراتها فحسب، ولكن يتعدى ذلك إلى أقصى الآفاق التنظيرية ومداها.” (الصفحة 26)
-
“إن المصادر وفق هذه الرؤية تفرض المعنى الفني الذي يشير إلى قنوات مصادر من دون الإشارة إلى الأدلة… المصادر هنا هي القرآن والسنة (كمصدر تأسيس)، والتاريخ والفقه كمصادر لعملية البناء.” (الصفحة 9)
-
“إن للمسألة صعوبات نسبية بالنسبة لفريق معظمه ينتسب إلى حقل العلوم السياسية، كان على هذا الفريق أن يصل عرض مشاكله المختلفة حتى يتمكن من مواجهتها أو حلها ضمن أصول منظومة التفكير الإسلامية.” (الصفحة 9)
-
“إن دعوى فتح باب الاجتهاد للفقه التكاملي والفقهاء القادرين على إعادة صياغة حياة المسلمين… تكريس في النهاية ليس فقط استمرار غلق باب الاجتهاد بل وأيضا إحجام العقل المسلم عن التفكير.” (الصفحة 16)
-
“الواقع المنزوي في العالم الإسلامي في الواقع الدول الراهن، لا يجب أن يكون معياراً على المدى الشرعي.” (الصفحة 16)
-
“إن فقد الحديث أو فهم السنة ينبغي أن يتم على مستويات ثلاثة: النظر في الحديث الواحد، والنظر في علاقة الأحاديث الواردة بشأن المسألة الواحدة، وبيان العلاقة بين الحديث وآيات الكتاب.” (الصفحة 12)
-
“التاريخ الإسلامي له مكانة خاصة بين هذه المصادر… إذ يقدم للتنظير عطاء في مفهوم العلاقات الخارجية وأشكالها، ووجهاتها، والفواعل فيها.” (الصفحة 13)
-
“وضابط قراءة الرؤية التاريخية قراءة تستطلع الظاهر والباطن منها، دون تكلف أو اعتساف أو حملها على ما تحتمله من معاني وتأويلات.” (الصفحة 14)
-
“إن طبيعة الفقه هي تخريج أو استنباط هذه الأحكام من مصدرها أو القياس عليها فيما يستجد من حالات، وإن عملية التخريج أو الاستنباط هي في النهاية اجتهاد بشري معرض للخطأ.” (الصفحة 14)
-
“إن الجهود لا يجب أن تفق عند حد إعادة صياغة الفقه التقليدي ليواكب ما استحدث من تطور في العلاقات الدولية، ولكنها يجب أن تتواصل بهدف استنباط الأحكام الشرعية القادرة على مواجهة الحاجات الجديدة.” (الصفحة 16)
-
“إن اعتبار الواقع لاختياره من القواعد الأساسية التي تشير إلى صعوبات مركبة… فإنها غالباً ما تؤدي إلى اعتقاق رأي مسبق بفرضه واقع الضعف.” (الصفحة 21)
-
“والرؤية الكلية لا تقتصر على جرد هذه العناصر (الإنسان والكون والحياة) بل تتسرب إلى ما يتعلق بالمقاصد الكلية العامة للشريعة التي تبحث في جواهر الأفعال لا أشكالها فحسب.” (الصفحة 10)
-
“إن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم ألا يكون عنده تعارض.” (الصفحة 68)
-
“النسخ ليس التخصيص بعد عموم وليس التقييد بعد إطلاق… فإن الإفراط في ماصدقات النسخ، أوقى البعض في الخلف.” (الصفحة 84)
-
“أصل العلاقة وتأييد الحكم، فإن الجهاد يكون ماضياً إلى يوم القيامة… إلا أن هذا التأييد لا ينصرف إلى كونه أصلاً للعلاقة، والأصل في هذا السياق ‘الدعوة’.” (الصفحة 84)
-
“إن الجهاد مرتبط بأسبابه وظروفه، وليس هذا من النسخ… فغير حال المسلمين لا يعني إلا بقاء فريضة الجهاد على المسلم، حيث يكون له حكم، فالحكم يناسب بذهاب سببه مع بقاء الحكم فقها.” (الصفحة 85)
-
“لا نسخ في الكليات… فالكليات الأساسية للشريعة… النظرة للإنسان والكون والحياة.” (الصفحة 86)
-
“عملية مهمة فإن تأسيس العلاقة بين المسلمين وغيرهم شأن خطير، يجب نسبته واشتقاقه من رؤية كلية تأسيس عقدي.” (الصفحة 86)
-
“إن التواصل مع القرآن ووصل مفاهيمه بالواقع المعاصر لابد أن يأخذ مكانه في المساقات الدراسية المختلفة.” (الصفحة 89)
-
“تكمن أهم العناصر التي يهتم بها أصحاب تخصص العلوم السياسية في إثارة الموضوعات وتحديد الإشكالات… بينما يتمتع أصحاب العلوم الشرعية بالتعرف على عناصر الضبط الشرعي.” (الصفحة 88)
الخاتمة:
للقراءة والتحميل

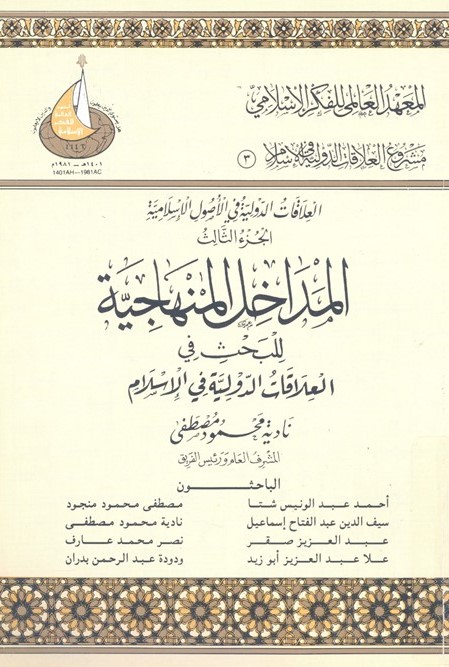
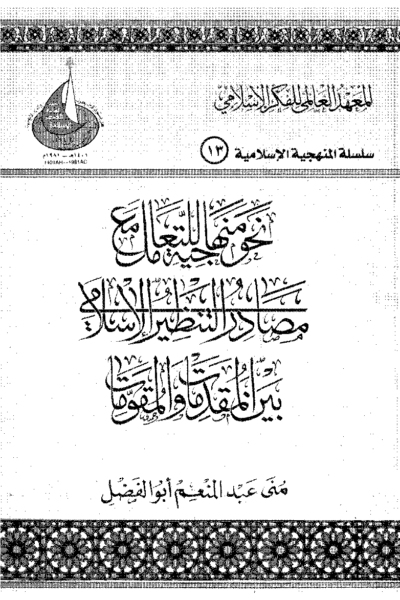



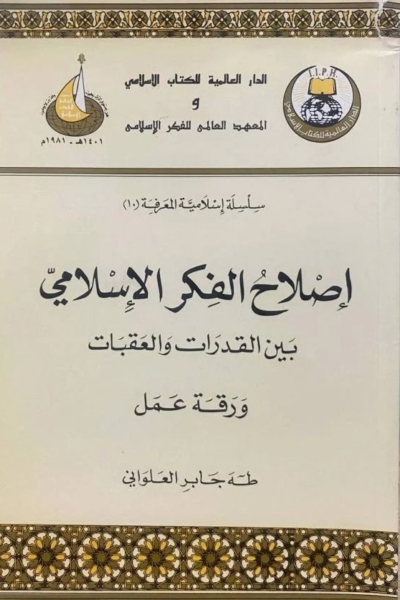

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.