الوصف
الأفكار الأساسية:
يتناول الكتاب العلاقات الدولية للدولة العباسية مقسماً تاريخها إلى ثلاثة عصور رئيسية، مركزاً على تفكيك العلاقة بين تطور البيئة الداخلية (اللامركزية والتعددية) وتأثيرها على السياسة الخارجية:
الفكرة الأساسية المحورية (التحول الاستراتيجي):
- التحول عن سياسة الفتح: انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين لم يكن مجرد تبديل لبيت حاكم، بل كان تحولاً جذرياً في استراتيجية التعامل الخارجي للدولة الإسلامية. حيث تخلت الدولة العباسية عن سياسة التوسع والفتوحات العسكرية كأداة أولى وأساس أوحد للتعامل مع الأطراف غير الإسلامية.
- تبني سياسة التعايش والسلم: ترسخت سياسة خارجية تهدف إلى التعايش مع الأطراف الدولية الأخرى (خاصة الدولة البيزنطية). واقتصر استخدام القتال على حالات الضرورة مثل رد الهجوم، أو التأديب والردع لانتهاك هيبة الدولة.
- عامل الحدود الجغرافية: يُرجع الكتاب سبب هذا التراجع في استخدام القتال الهجومي إلى حقيقة بلوغ الدولة الإسلامية لأقصى اتساع جغرافي يمكن أن تصل إليه، حيث كانت الجبال تمثل حدوداً طبيعية لوقف التوسع (مثل جبال طوروس والبرنيه).
هيكلية الكتاب (الأفكار الأساسية التفصيلية):
- الفصل الأول (٧٥٠ – ٨٦١ م – العصر العباسي الأول):
- الفكرة: استمرار تسيد المركز الإسلامي (العباسي) دولياً في مواجهة الأطراف غير الإسلامية، مع بدء ظهور بوادر اللامركزية والتعددية داخل دار الإسلام.
- التطبيق: تسيد المشرق الإسلامي في ظل استراتيجية التعامل الدولي الجديدة (التعايش). وظهور أنماط تحالفات جديدة في المغرب الإسلامي نتيجة لظهور اللامركزية وتوسع سياسات الفتح هناك (مثل ظهور الدولة الأموية في الأندلس ودول أخرى مستقلة).
- الفصل الثاني (٨٦١ – ١٠٥٥ م – العصر العباسي الثاني):
- الفكرة: انتهاء دور الدولة العباسية كقوة مركزية فعالة في التعامل الدولي وفقدانها القدرة على المبادرة والهجوم.
- التطبيق: تكرس نمط اللامركزية والتعددية. وظهور قوى إسلامية جديدة تتبنى استراتيجيات مختلفة، أبرزها صعود الدولة الفاطمية في المشرق (أو شمال إفريقيا) والدولة الأموية في الأندلس كبديلين للدور العباسي في العلاقات الدولية.
- الفصل الثالث (١٠٥٥ – ١٢٥٨ م – العصر العباسي الثالث):
- الفكرة: فترة التحديات الكبرى التي أدت لسقوط الدولة، من الهجمة الصليبية إلى الهجمة المغولية.
- التطبيق: نشوء مراكز إسلامية جديدة للصمود على الساحة الدولية، مثل دور السلاجقة (بعث إسلامي جديد) ، وتزامن المد الصليبي في المشرق مع المد المرابطي في المغرب ، وتطور علاقات القوى الإسلامية والمسيحية خلال عهد صلاح الدين الأيوبي ، وصولاً إلى سقوط الخلافة العباسية على يد المغول.
تحليل معمق للكتاب:
يقدم هذا الجزء من مشروع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بقيادة الدكتورة نادية محمود مصطفى وتأليف الدكتورة علا عبد العزيز أبو زيد، رؤية تحليلية معمقة لتاريخ الدولة العباسية من منظور العلاقات الدولية. وتكمن قيمة هذا العمل في تطبيقه لأدوات ومفاهيم العلوم السياسية الحديثة (مثل: النظام الدولي، التحول الاستراتيجي، التعددية، اللامركزية) على مادة التاريخ الإسلامي، مما يخرجه من نطاق السرد التاريخي إلى دائرة التحليل العلمي.
١. البعد الاستراتيجي: من “دار الإسلام الواحدة” إلى “التعددية العسكرية”
التحليل الأهم الذي يقدمه الكتاب هو رصد “التحول الاستراتيجي” في السياسة الخارجية للدولة الإسلامية بعد سقوط الأمويين.
- الانتقال من الهجوم إلى الدفاع (Shift from Offense to Defense):
- يؤكد الكتاب أن العباسيين لم يتخلوا عن الفتوحات ضعفاً فقط، بل كان ذلك اختياراً استراتيجياً مدركاً ومرتبطاً بـ “حدود جغرافية طبيعية” (مثل جبال طوروس) وصلتها الدولة في العهد الأموي.
- اعتبر العباسيون أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حدود الدولة المترامية الأطراف أولى من التوسع الذي يتطلب موارد هائلة. هذا يمثل تحولاً في عقيدة الدولة من كونها “قوة توسعية دائمة” إلى “قوة حفظ توازن واستقرار”.
- تشكل نظام دولي إسلامي متعدد الأقطاب (Multipolar Islamic System):
- مع ضعف المركز العباسي (خاصة في العصر العباسي الثاني)، ظهرت دول إسلامية مستقلة كقوى فاعلة على الساحة الدولية (مثل الفاطميين في مصر والشام، والأمويين في الأندلس). هذه الدول لم تعد مجرد أقاليم، بل أصبحت مراكز قرار تمارس علاقات دولية مستقلة، سواء بالقتال أو التحالف أو المعاهدات.
- الكتاب بذلك لا يرى فترة العباسيين المتأخرة كفترة “ضعف شامل”، بل كفترة “تعددية في القوة الإسلامية” حيث توزعت مهام العلاقات الدولية والمواجهة على مراكز جديدة نشطة.
٢. البعد المنهجي: تداخل العوامل الداخلية والخارجية
يتميز الكتاب بتحليل العلاقة الجدلية بين الداخل والخارج، وهو ما يُعرف بـ (Linkage Politics) في العلوم السياسية:
- تأثير اللامركزية على الاستراتيجية:
- يربط الكتاب تراجع الدور العباسي في المبادرات الخارجية بـ اللامركزية المتزايدة (بروز القوى الإقليمية، تزايد نفوذ القادة العسكريين، الصراعات الداخلية).
- استغراق المركز في تثبيت سلطته ومعالجة التمردات والفتن الداخلية أدى منطقياً إلى تحييد طاقته عن التوسع الخارجي أو حتى ردع القوى غير الإسلامية بفعالية.
- المواجهة الكبرى (الصدام الحضاري):
- يُحلل الكتاب العصر العباسي الثالث (فترة السلاجقة والأيوبيين) كنظام استجاب للتحديات الخارجية الكبرى (الحملات الصليبية والمغول).
- يُظهر كيف أن صعود قوى عسكرية إسلامية جديدة مثل السلاجقة ونظام الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي كان بمثابة “بعث إسلامي” ضروري لملء الفراغ الذي تركه ضعف الخلافة العباسية كقوة عسكرية، مما يؤكد أن الإطار الحضاري الإسلامي كان قادراً على توليد آليات استجابة جديدة للتحديات الخارجية.
٣. القيمة المضافة للكتاب على صعيد الدراسات الإسلامية
- تجاوز النظرة الأحادية للجهاد:
- الكتاب يُثبت أن مفهوم الجهاد في التاريخ الإسلامي لم يكن قاصراً على “الحرب الهجومية” (Taliban Doctrine) كما يحاول البعض تصويره، بل تضمن أيضاً سياسات الردع، والتعايش السلمي، وتبادل البعثات التجارية والدبلوماسية. هذا يساهم في بناء نظرية إسلامية للعلاقات الدولية أكثر شمولية.
- التأكيد على المؤسسية (Institutionalism):
- يرصد الكتاب استمرار المؤسسات الدبلوماسية والتجارية، حتى في فترات ضعف الخلافة. فكانت الخلافة العباسية تحافظ على “شرعيتها الرمزية” كمرجع ديني وسياسي أعلى، حتى عندما كانت القوى الإقليمية (البيزنطية، الفاطمية، السلجوقية) هي من تمارس “القوة الفعلية” في الميدان الدولي.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
1. “فكانت سياسة العالم تصنع بحق في مركز الخلافة الإسلامية، وأنتقال السلطة في الدولة الإسلامية تلك من الأمويين إلى العباسيين يعتبر نقطة تحول رئيسية في تاريخ النظام الدولى”. ٩
2. “ولكنه [انتقال السلطة] كان بمثابة تحول جذري في استراتيجية التعامل الخارجي للدولة الإسلامية بما يترتب على ذلك من تغيرات حاسمة في شكل العلاقات الدولية”. ٩
3. “هذا التوجه هو التحول عن سياسة التوسع والفتوحات العسكرية كأساس أوحد للتعامل مع الأطراف غير الإسلامية”. ٩
4. “فاتخذوا من الاجراءات الحاسمة والخطوات الواضحة ما يثبت تخليهم عن القتال كأداة أولى من أدوات ادارتهم تعاملهم الخارجي”. ٩
5. “فنلاحظ منذ عهد المنصور أرهاصات سياسة خارجية تهدف إلى التعايش مع الأطراف الدولية الاخرى ولا تجعل من بين أهدافها الرئيسية القضاء على هذه الأطراف خاصة الدولة البيزنطية”. ٩
6. “ولكنا عندما نراجع بدقة الأحداث التي أعقبت انتقال السلطة… سيتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك ان توقف الفتوحات في الدولة العباسية لم يكن حدثا عارضا… ولكنه سيصبح سياسة ثابتة للدولة”. ١٠
7. “فالقتال في الدولة العباسية لم يعد يستخدم كأداة للتعامل الخارجي إلا في حالات الضرورة والتي تمثلت أساسا خلال العصر العباسي الأول في حالات رد الهجوم وحالات التأديب والردع”. ١٠
8. “والواقع ان تراجع استخدام الدولة العباسية للقتال كأداة هجوم وقصره على كونه أداة دفاع جاء استجابة لعوامل طبيعية أقتنع العباسيون بها وبعدم جدوى تجاهلها”. ١٠
9. “ولعل على رأس هذه العوامل حقيقة بلوغ الدولة الإسلامية لأقصى اتساع جغرافي يمكن ان تصل اليه، فالدولة مثل الكائن الحي لا يمكن أن تستمر في النمو إلى مالا نهاية”. ١٠
10. “فالملاحظ أن الجبال كانت تمثل دائما الحد الطبيعي الذي لا يستطيع المسلمون تخطيه، فكل معاركهم العظيمة كسبوها في السهول… وكل هزائمهم الحاسمة كانت على سفوح الجبال”. ١٠
11. “أما العصر العباسي الثاني… فإنه كان بمثابة مرحلة انتقالية قوية وبلورت من منطلق الضعف… مفهوم التعددية في دار الإسلام”. ١٩
12. “يرجع بعض المحللين تراجع الدولة العباسية عن سياسة الفتح والتوسع إلى استغراق الدولة في المشاكل الداخلية المتعاظمة الدولة مترامية الأطراف”. ١٠
13. “وقد استغلت هذه الدول الإقليمية الجديدة التعددية واللامركزية في دار الإسلام أحسن استغلال، لتعمل على بناء كياناتها القومية في ظل غياب سياسة الفتح… للتعامل الخارجي”. ٥٤
14. “كانت هناك حاجة ماسة لتدعيم الأمن الداخلي ودعم الاستقرار قبل السعي وراء الفتوحات والمكاسب الاقتصادية”. ٥٥
15. “الفصل الثاني: العصر العباسي الثاني (٢٤٧-٤٧٧ هـ / ٨٦١-١٠٥٥م) : انتهاء دور الدولة العباسية كقوة مركزية في التعامل الدولى، وبدء صعود الدولة الفاطمية في المشرق، والدولة الأموية في المغرب”. ٧
16. “ولقد وصلت الدولة [الإسلامية] في عهد الأمويين إلى حدودها الجغرافية الطبيعية”. ١٠
17. “والواقع أن التحرك الذي أمكن أن تقوم به الدولة العباسية على الجبهة البيزنطية هو حركة دفاعية أكثر منه حركة هجوم”. ٢٢
18. “نجاح الدولة العباسية في سياستها الخارجية لم يعتمد على القوة العسكرية فقط، بل كان يستند كذلك إلى علاقات الاستقرار التي شجعت على زيادة النشاط التجاري وتبادل البعثات”. ١٣
19. “الفصل الثالث: العصر العباسي الثالث (٤٧٧ – ٦٥٦ هـ / ١٠٥٥ -١٠٩٧م) : من الهجمة الصليبية إلى الهجمة المغولية، وسقوط الدولة العباسية”. ٨
20. “الملاحظ أن الدولة العباسية لم تسع إلى إفناء أو القضاء على أية قوة أخرى بل استمرت سياساتها على حماية الدولة الإسلامية في حدودها التي بلغت من قبل”. ٢٥
الخاتمة:
للقراءة والتحميل

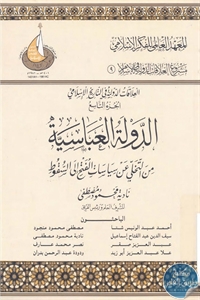

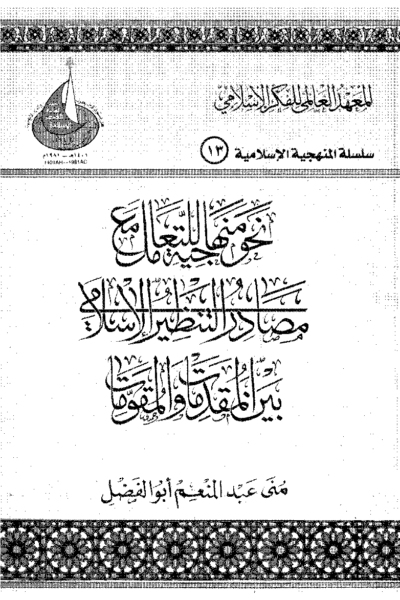

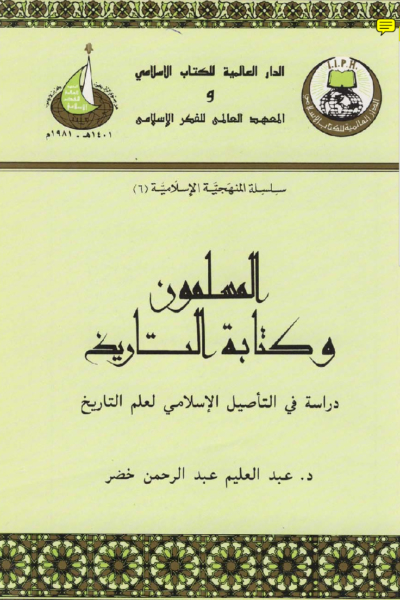

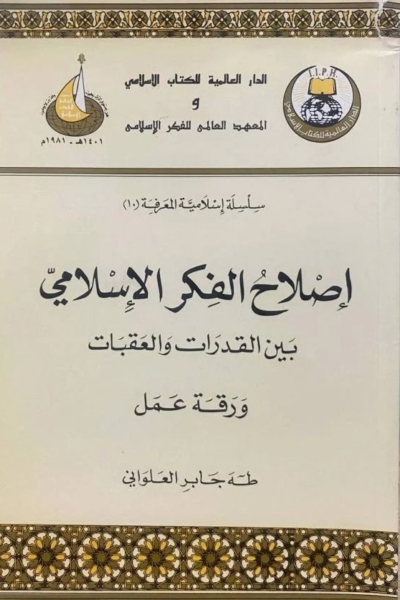
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.