الوصف
الأفكار الأساسية:
الكتاب يركز على تحليل العلاقات في ضوء ثلاثة محاور رئيسية، تمثل الفصول الثلاثة للكتاب:
1. هيكل القوى الإسلامية ومركزية القوة العثمانية (المقدمة):
- شهدت هذه المرحلة تعددية إسلامية دولية بظهور ثلاثة مراكز متزامنة ومستقلة للقوة: العثمانية، الصفوية، المغولية.
- يؤكد الكتاب على أن الدولة العثمانية كانت هي الفاعل المركزي المهيمن، حيث لم تكن أي من القوتين الأخريين تقارن بها في عناصر القوة المادية أو القدرة على ممارسة النفوذ.
- أثار الدور العثماني إشكاليات هامة، أبرزها: طبيعة الدولة العثمانية كـ “دولة الخلافة الإسلامية” والتحول في مركز الخلافة إلى الأستانة (إسطنبول).
2. الفصل الأول: نظام القوة والهيمنة الإسلامية (1520 – 1571 م):
- تمثل هذه المرحلة أوج القوة العثمانية العالمية، خاصة في عهد السلطان سليمان القانوني.
- العلاقات العثمانية-الأوروبية: ركزت على تحالف البوربون (فرنسا) مع العثمانيين لمواجهة الهابسبورغ (النمسا وإسبانيا)، ما جعل الدولة العثمانية لاعباً أساسياً في صياغة “التوازن الأوروبي”.
- الدور العثماني في البحار: كانت القوة البحرية العثمانية قادرة على تحدي القوى الأوروبية في البحر المتوسط والمحيط الهندي والبحر الأحمر.
- العلاقات العثمانية-الإسلامية: تمثلت في التنافس مع القوى الإسلامية الأخرى، خاصة الصفويين في الشرق والجهود المبذولة لإبعاد التهديد الأوروبي (البرتغالي) عن العالم الإسلامي في الجنوب (اليمن، شرق أفريقيا).
3. الفصل الثاني: المرحلة الانتقالية ومولد الهيمنة الأوروبية (1606 – 1774 م):
- بدء تقلص نفوذ وقوة الدولة العثمانية وبداية “المسألة الشرقية”.
- شهدت أوروبا مولد نظام جديد للهيمنة، وتراجع التهديد العثماني لأوروبا بفعل ضغط النمسا وروسيا.
- تزايد انعكاسات تقلص القوة العثمانية على العالم الإسلامي، وبدأت تظهر بوادر “الهجمة الأوروبية” تجاهه.
4. الفصل الثالث: تصفية الدور العثماني وتوالي الاستعمار (1774 – 1923 م):
- يمثل نظام تصفية الدور العثماني وتوالي موجات الاستعمار على العالم الإسلامي.
- التوازنات الأوروبية: أصبحت تتشكل حول مصير الدولة العثمانية، مع تزايد التدخلات الأوروبية في شؤون الولايات العثمانية وعمليات الإصلاح.
- العالم الإسلامي: تزايدت التدخلات والتنافس الأوروبي حول الولايات العربية والمناطق الإسلامية الأخرى حتى السقوط النهائي للدولة العثمانية عام 1923م.
تحليل معمق للكتاب:
لا يمثل هذا الكتاب مجرد سرد تاريخي، بل هو دراسة نظامية (Systemic) تهدف إلى تطبيق مفاهيم ونظريات العلاقات الدولية على فترة تاريخية هامة، لتقديم فهم أعمق لديناميكيات القوة والتفاعل بين الحضارات.
أولاً: الإطار المنهجي: من السرد إلى التحليل النظامي
تكمن أهمية هذا المشروع في تبنيه “مدرسة العلاقات الدولية الإسلامية” التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تجاوز السردية التاريخية
الكتاب لا يكتفي بوصف الأحداث والحروب، بل يقدم “نظام التفاعلات الإسلامية-المسيحية” كمتغير تحليلي. يتم النظر إلى العصر العثماني باعتباره نظاماً دولياً تشكل الدولة العثمانية فيه “الفاعل المركزي المهيمن” (The Central Hegemonic Actor) الذي يمتلك القدرة على فرض قواعد اللعبة أو التأثير عليها بشكل حاسم.
2. تحليل هيكل القوة الإسلامية
الكتاب يقر بوجود “تعددية إسلامية دولية” (العثمانية، الصفوية، المغولية)، لكنه يُبين أن هذه التعددية لم تكن متساوية القوى. يتم التركيز على مركزية القوة العثمانية التي تفوقت على القوتين الأخريين في القدرات المادية والرمزية (بما فيها ادعاء الخلافة)، مما جعلها الممثل الوحيد تقريباً للعالم الإسلامي في التفاعل مع الغرب الأوروبي. هذا التمركز للقوة هو ما سمح للدولة العثمانية بلعب دور رئيسي في التوازن الأوروبي نفسه.
ثانياً: أطروحة الهيمنة العثمانية وتداعياتها الأوروبية
يركز التحليل المعمق على فهم الدور العثماني خلال فترة القوة (1520 – 1571 م) من منظور العلاقات الدولية.
1. الدولة العثمانية كـ “فاعل توازني” في أوروبا
أهم استنتاج تحليلي في هذه المرحلة هو أن الدولة العثمانية لم تكن مجرد تهديد لأوروبا، بل كانت عنصراً فعالاً في صياغة التوازنات الأوروبية الداخلية. ففي الوقت الذي كان فيه الصراع على أشده بين آل هابسبورغ (النمسا وإسبانيا) وآل بوربون (فرنسا)، أتاحت التحالفات العثمانية-الفرنسية (على الرغم من تناقضها الحضاري) إضعاف الهيمنة الهابسبورغية. هذا الدور يوضح كيف أصبحت الأستانة (إسطنبول) جزءاً لا يتجزأ من حسابات القوة الأوروبية، وليس مجرد طرف خارجي.
2. التناقض الجغرافي-السياسي (Geopolitics)
يبرز الكتاب التناقض في الموقف العثماني:
- في الغرب: مواجهة القوى الأوروبية الكبرى (النمسا والبندقية).
- في الجنوب والشرق: مواجهة التوسع البحري الأوروبي (البرتغالي في المحيط الهندي والبحر الأحمر) والحفاظ على طرق التجارة، بالإضافة إلى الصراع الأيديولوجي والسياسي مع الدولة الصفوية في الشرق، الذي استنزف جزءاً كبيراً من الموارد العثمانية. يكشف هذا التناقض مدى اتساع النطاق الجغرافي-السياسي للنظام الذي كانت تديره الدولة العثمانية.
ثالثاً: جدلية التراجع وإعادة تأويل “المسألة الشرقية”
يُقدم الكتاب تحليلاً دقيقاً لمراحل تراجع القوة العثمانية، مما يمثل جوهر التحول في النظام الدولي الإسلامي-المسيحي.
1. الانزلاق من “المُهَدِّد” إلى “الضحية”
التحول الأبرز هو الانتقال من كون الدولة العثمانية مصدراً لـ “التهديد” لأوروبا إلى كونها “موضوع المسألة الشرقية”. ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر تقريباً، لم يعد الأوروبيون يتحدون الدولة العثمانية لدحرها، بل يتنافسون فيما بينهم على تقسيم ممتلكاتها والسيطرة على مقدراتها، وهو ما يمثل ذروة الهيمنة الأوروبية الصاعدة.
2. إعادة تعريف “المسألة الشرقية”
من وجهة نظر العلاقات الدولية الإسلامية التي يتبناها الكتاب، فإن “المسألة الشرقية” هي في جوهرها: تصفية دور “الفاعل المركزي” (العثماني) تمهيداً للاستعمار الكامل للوطن الإسلامي. لم تكن المسألة مجرد مشكلة حدودية أو إدارية، بل كانت عملية نظامية أدت إلى:
- تفكيك النظام: تآكل السلطة المركزية العثمانية في ولاياتها (مصر، الشام، شمال أفريقيا).
- الهيمنة الأوروبية: استبدال الهيمنة العثمانية بالتدخلات والامتيازات والقروض الأوروبية، وصولاً إلى الاحتلال المباشر (مثل حملة نابليون على مصر 1798).
3. العلاقة بين الداخل والخارج
يُشير التحليل المعمق إلى أن التراجع العثماني لم يكن فقط نتيجة لقوة الغرب، بل كان أيضاً نتيجة ضعف وتخلف في البنية الداخلية للدولة العثمانية (البيروقراطية، النظم العسكرية، الاقتصاد). هذا الضعف الداخلي هو ما سمح للقوى الأوروبية بتحويل التنافس مع الدولة العثمانية إلى تدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات أو ضمان التجارة، مما سرّع من انهيارها.
خلاصة الأثر التحليلي
إن الأثر الحقيقي للكتاب يكمن في تقديمه إطاراً مفاهيمياً يحرر دراسة العلاقات الدولية في العصر العثماني من الرؤية التاريخية التقليدية، ويضعها ضمن سياق تحليل ديناميكيات القوة الدولية، مؤكداً على:
- المركزية العثمانية: لقرون، كانت القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على التفاوض والتوازن والمواجهة مع أوروبا.
- نقطة التحول: العصر العثماني هو العصر الذي شهد انقلاب ميزان القوى الدولي، ليصبح الغرب هو الفاعل المهيمن الذي يحدد قواعد النظام، وهو ما ترتبت عليه كل التطورات اللاحقة في العالم الإسلامي.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
- “تعد [هذه المرحلة] من منظور التاريخ الإسلامي العام “المرحلة العثمانية “أى التي لعبت فيها الدولة العثمانية دور الفاعل المركزي في العالم الإسلامي وفي التفاعلات الإسلامية – المسيحية الدولية.” (ص 10)
- “فما من واحدة من القوتين الأخريين [الصفوية والمغولية] كانت تقارن من حيث عناصر القوة بالدولة العثمانية أو توافرت لها خصائص الفاعل المهيمن سواء من حيث عناصر القوة المادية أو من حيث القدرة على ممارسة النفوذ والسلطة.” (ص 10)
- “أثر دور الدولة العثمانية فى تشكيل العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي في مرحلة هامة من تطور تاريخ كل من الطرفين.” (ص 10)
- “تجربة التطور التي مرت بها الدولة العثمانية من قيامها كقوة إقليمية ممتدة ومستقرة، وضم شبه المنطقة العربية آخرها، أدى لتدعيم أركان الدولة العثمانية… وأصبحت إمبراطوريتهم القوة الإسلامية الأولى والتي قامت بدور عالمي هام.” (ص 23)
- “كان السلطان سليمان [القانوني] كان أعظم شخصية في التاريخ العثماني ووصلت الإمبراطورية في عهده إلى أوج اتساعها وقوتها بحراً وبراً.” (ص 23)
- “فإن الدولة العثمانية قامت بدورها في مواجهة الطرف الأوروبي… على إحراز الانتصارات والوقوف في وجه القوى الأوروبية.” (ص 24)
- “كانت كل العناصر النوعية والبنية الأساسية والقوة المادية تؤهل الدولة العثمانية لأن تمثل مركزاً للقوة الكبرى في العالم الإسلامي ومصدراً لتهديد القوى الأوروبية.” (ص 24)
- “كانت التنافسات الفرنسية – الإسبانية على السيادة في أوروبا وكذلك الانقسامات الدينية الكاثوليكية – البروتستانتية في ألمانيا قد استنزفت قدرات أوروبا في عملية المواجهة مع العثمانيين.” (ص 24)
- “استقواء أطراف أوروبية (فرنسا) بالدولة العثمانية في مواجهة نظائرها (إسبانيا) ومن ثم لعبت الدولة العثمانية دورها في تشكيل التوازن في أوروبا.” (ص 28)
- “كان هدف السياسة العثمانية في هذا التحالف [الفرنسي العثماني] هو إضعاف أوروبا الهابسبورج وإبقاء أوروبا مقسمة وبعيدة عن شن حرب صليبية جديدة.” (ص 29)
- “بالرغم من اتفاق المصادر التاريخية الأولية والثانوية على انتقال الخليفة العباسي إلى الآستانة بعد فتح مصر، الا أن الاختلاف ثار حول ما إذا كان قد تنازل للسلطان العثماني سليم أو ابنه من بعده عن لقب الخلافة أم لا؟” (ص 10)
- “لقد كان هذا النمط [التحالف المسيحي – الإسلامي] هو نمط من العلاقات المسيحية الإسلامية، أي أنه عرفته العلاقات العثمانية الأوروبية خلال مرحلة ما قبل سقوط القسطنطينية.” (ص 26)
- “كان هدف الفرنسيين من تحالفهم مع العثمانيين هو استغلال الفرصة لتقديم المصالح الخاصة بهم وتفادي الالتزامات الصليبية.” (ص 29)
- “بـ – كانت هذه المعاهدة [معاهدة الامتيازات] مجرد تصديق على إجراءات كانت متبعة من قبل، فلقد سبق لماليك مصر ولسليمان الفاتح والسلطان سليم الأول أن منحوا التجار الغربيين تسهيلات كثيرة.” (ص 31)
- “تطورّت سياستها [الفرنسية] نحو استهداف السيطرة على طرق التجارة والبحار الهندية والحيلولة دون امتداد السيطرة العثمانية على تلك المنطقة.” (ص 34)
- “لم تكن الدولة العثمانية في حركتها هذه تنطلق فقط من حسابات سياسية بل كانت تنطلق كذلك من حسابات مصالحها الاقتصادية التي كانت تتطلب من إدراك الوعي الطبيعي للتنافس الأوروبي في هذه المرحلة التاريخية.” (ص 35)
- “أضحى حوض المتوسط والبحر الهندي والمحيط الهندي يمر بمرحلة جديدة من الصراع الممتد والعنيف بين الإسلام والمسيحية وهو الصراع الذي انتقل إلى البحار والمحيطات عند الكشوف الجغرافية.” (ص 36)
- “الانتصار على البرتغال في البحر الأحمر والمحيط الهندي كان له أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة.” (ص 49)
- “فقد تحول الاتجاه نحو تعددية إسلامية دولية نتيجة ظهور ثلاثة مراكز متزامنة للقوة الإسلامية ومستقلة عن بعضها وهى العثمانية، الصفوية، المغولية.” (ص 9)
- “كانت كل العناصر النوعية والبنية الأساسية والقوة المادية تؤهل الدولة العثمانية لأن تمثل مركزاً للقوة الكبرى في العالم الإسلامي ومصدراً لتهديد القوى الأوروبية.” (ص 24)
الخاتمة:
للقراءة والتحميل

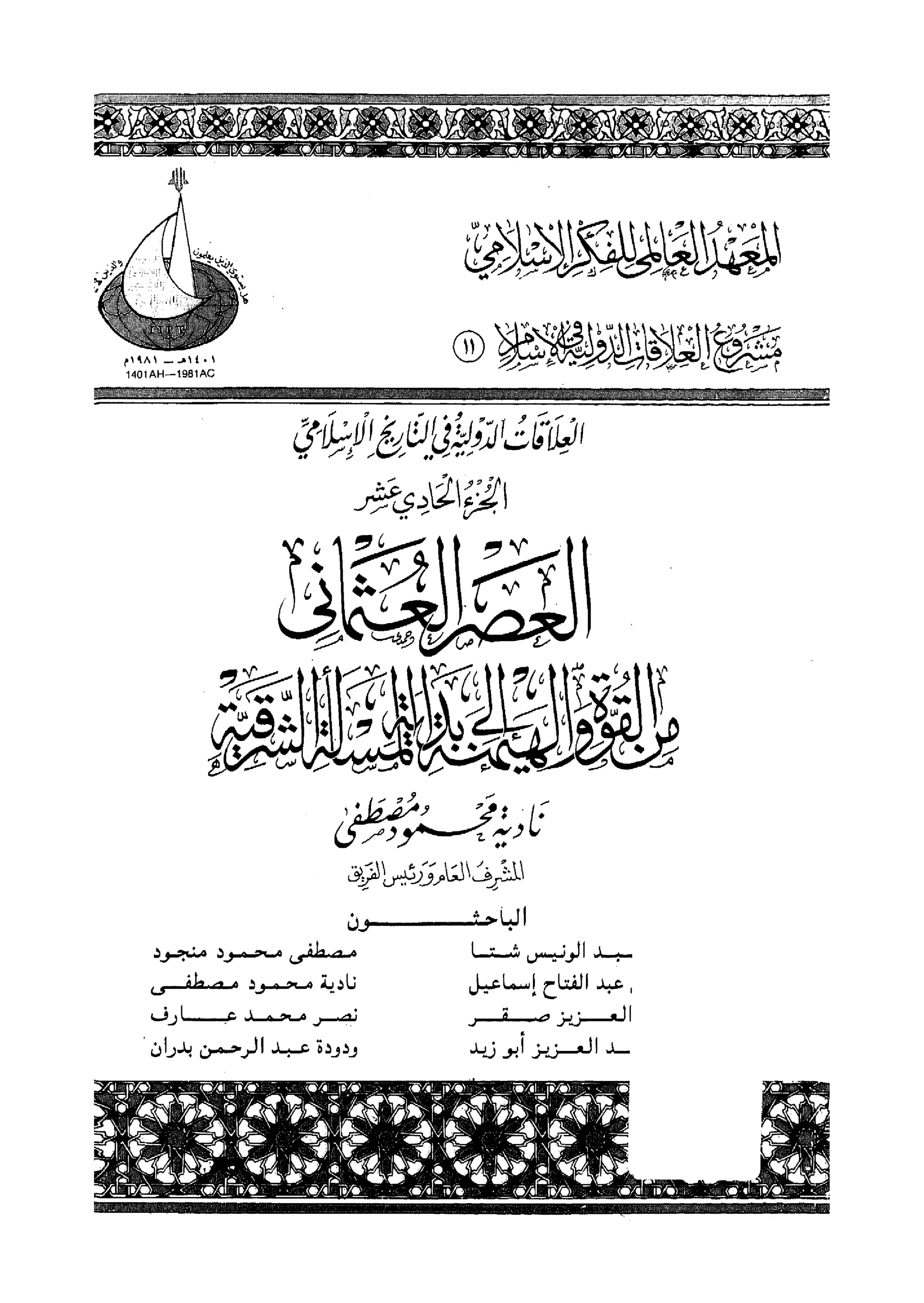
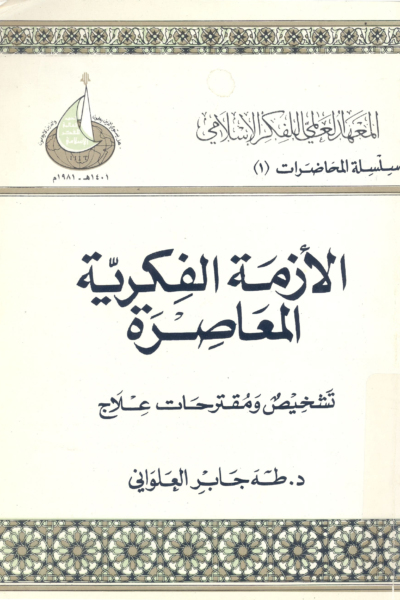



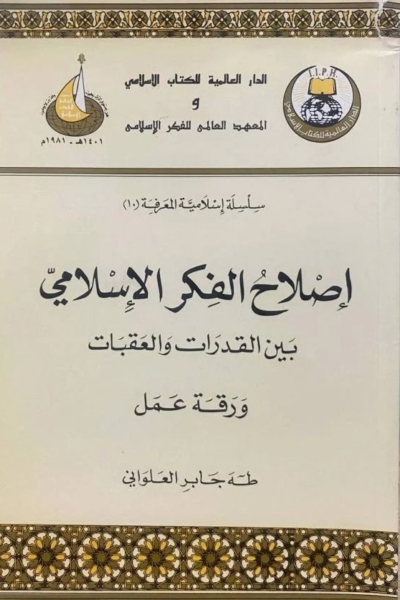
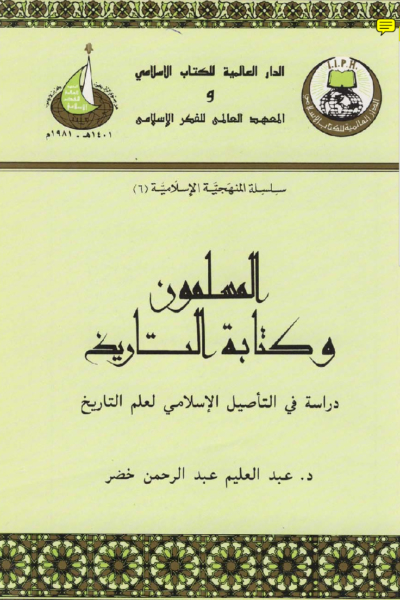
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.