الوصف
كلمة التحرير
===========
إن التقدير المتزايد للمجلة الذي عبرت عنه فئات مختلفة من القراء، تنوعت مستوياتهم التعليمية، واختلفت تخصصاتهم العلمية، وتباينت اهتماماتهم الفكرية، وتباعدت مواطنهم الجغرافية، إن مثل هذا التقدير مؤشر مهم على أن الخطاب الذي سعت المجلة منذ نشأته إلى الإسهام في تطويره وإنضاجه إنما هو خطاب يلتحم بشعور دوائر واسعة من مثقفي الأمة ومفكريها بضرورة أن يرتاد الفكر الإسلامي آفاقاً جديدة في حركيته، تجديداً للمنهج في طرح القضايا والنظر فيها، وتطويراً للرؤية في إثارة الأسئلة والإجابة عنها، خروجاً بذلك من مرحلة الركود التي ارتد إليها العقل المسلم في عصرنا حيناً من الدهر. ففي ظل حالة الركود هذه، أصبح العقل المسلم وكأن لا وظيفة له غير إعادة إنتاج مقالات الآخرين ومقولاتهم، سواء أكانوا سابقين من أجيال الأمة المتعاقبة، أم لاحقين من أبناء حضارة الغرب المهيمنة الغالبة.
وإذا كانت المرجعية التاريخية للأمة، في مراحل ازدهارها الحضاري وإشعاعها الثقافي، قد تأسست على قاعدة الوحي الإلهي قرآناً هادياً وسنّةً مرشدة، فإن العقل المسلم الذي استضاء بنور الوحي وتفاعل مع مقرراته ومعطياته، كان عقلاً اجتهادياً منفتحاً غير منكفئ، مُقْدِماً غير متراجع، انفتح على تجارب الإنسانية ما غبر منها وما حضر، فماز طيّبها من خبيثها، واستخلص من تراثها حكمته الباقية وعبرته الماضية، واستوعب الصالح والنافع من إنجازاتها، وضمّ ذلك كله إلى حقائق الوحي الثابتة وقيمه الخالدة، فشاد للمعرفة صرحاً “ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع”، كما جاء في عبارة الإمام الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى.
تلك كانت الصورة الكلية، ولكنها صورة لم تكن طبعاً تخلو من حالات توتر وشدّ وجذب. ولم يكن ذلك التوتر مَرْضيّاً بقدر ما كان توتراً إيجابياً يدعو إلى الحيوية ويحفز العقل على التجاوز والتجديد، بقطع النظر عن التقويم النهائي لما أنجزه هذا العقل في الحقول المعرفية المختلفة التي نشأت وترعرعت في الإطار الحضاري الإسلامي، سواء نسبنا إنجازاته إلى معيار الوحي أو نسبناها إلى ما تحقق في العصر الحديث في ظل حضارة الغرب وثقافته. فما يهمنا هنا هو أن تلك المرجعية التاريخية التي تشكلت ابتداءً على أساس مقررات …
بحوث ودراسات
==============
يتناول البحث بعض جوانب النظام المعرفي وما أصابه من خلل وتشوهات، وما يمكن عمله من أجل إعادة بنائه وتأسيسه على هدى من النظام المعرفي القرآني. فيبدأ بشرح الأنظمة الثلاثة: الاعتقادي، والمعرفي، والقيمي. ويناقش كيف هُمش القرآن بالتركيز على دراسة آيات الأحكام فقط. ويوضح مميزات النظام المعرفي القرآني، وقيامه على الجمع بين القراءتين (قراءة الوحي، وقراءة الكون). ويشرح مكانة السير والنظر في نظامه المعرفي، وتنوعه وشموله للظواهر الإنسانية والاجتماعية، ولظواهر الكون والآيات والأقوام والأمم.
يعد البحث محاولة للكشف عن قواعد المذهب السياسي كما يقدمه القرآن، ويحاول إيجاد منهجية مناسبة في التعامل معه. ويقدم البحث تمهيداً لعلم التفسير، وانحصاره في الجوانب اللغوية، وتمسك الخوارج بظواهر النصوص، وانصراف المعتزلة عن المعاني الظاهرة إلى التأويل المجازي، ويتناول السياسة وموضوعاتها، وكيف تأسس النظام السياسي على الإجماع، ويعرض لتحليل وتركيب المفاهيم القرآنية، ويشرح النموذج الكلي وكيف يستخرج بطريقة منهجية من نصوص القرآن، ومرحلة التأويل وتحريك النموذج الجزئي، واختبار القدرة التفسيرية للنموذج، ومكانة السنة فيه، والتأويل ومطابقته بين معاني الوحي وأعيان الوجود.
الملخص
البحث إطلالة على الفكر اليهودي وأثره على فكر ما بعد الحداثة، القائم على التفكيك وهدم كل المرجعيات، والدعوة إلى السيولة وغياب المركز، ويسهم البحث في توسيع رؤيتنا للآخر (الغرب). ويُفرق البحث بين العلمانية الجزئية والشاملة، ويبين كيف حمّل النص المقدس لليهودية بالهرطقة، ويفسر بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهود واليهودية، مثل الدال والمدلول، والحضور والغياب في الفلسفة الغربية، ثم التمركز حول اللوجوس، والقصص الصغرى والكبرى، والمطلق والنسبي، ومفهوم الاختلاف في المكان، والإرجاء في الزمان في فكرما بعد الحداثة.
ينهض البحث باستقصاء ملامح صورة الإسلام والمسلمين كما ترسمها الروايات الشعبية في كل من بريطانيا وأمريكا، ويقوم بعملية توثيق وتقويم للاتجاه المعادي للإسلام في هذه الروايات. فيبدأ البحث بتقديم الغرض من الدراسة وإطارها الزمني، ثم الروايات الشعبية وأصنافها ومدى تأثيرها على القارئ الغربي، ثم صورة الإسلام والمسلمين كما ترسمها هذه الروايات. ويعرض لنصوص من عدة روايات تتناول هذه الإشكالية، ويتناول بالشرح العلاقة بين الرواية الشعبية ودواعي الفن والدوافع السياسية، داعياً إلى تحقيق رؤية متوازنة وإقامة حوار حضاري بين الغرب والإسلام.
قراءات ومراجعات
===================
يمثل هذا الكتاب قولاً جديداً في موضوع قديم، فهو يندرج تحت الدراسات النقدية في الفكر العربي الإسلامي الحديث، ويمثل أحد أبرز الاستجابات المعاصرة لنداء الحياة والنهوض والتطور والتي من أبرز مطامحها انتشال العالم العربي والإسلامي من وهدة الانحطاط والتخلف والسير به نحو أفق أكثر تقدماً ورقياً. ويمكن أن يصنف هذا النص ضمن أدبيات الطبقة الثالثة من نتاج مفكري العالم العربي والإسلامي المعاصرين ونقاده، إذا ما افترضنا أن هذا الفكر قد مرّ حتى الآن بثلاث مراحل رئيسة.
وإذا أردنا أن نعطي بُعداً تحليلياً وتاريخياً لكلامنا السابق، فإنه لا بد من التذكير أولاً بأهم التحولات التي دشنت ظهور عصر الحداثة، والتي تمثلت أساساً فيما طرأ على العالم من تغير جذري متسارع على مستوى الأدوات والوسائل، وكذلك ما حصل من تحول عميق وتقدم كبير على مستوى ضبط النشاط البشري وترشيده، والانتظام الاجتماعي بشكل شمولي مطلق، مما أدى إلى تضييق مجال حرية الأفراد وتعقد شبكة العلاقات الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك شيوع النـزعة “الزمنية” بوصفها أبرز العوامل المؤطرة والمنظمة للفعل الفردي والجماعي مما أدى إلى صعود فن التخطيط والضبط، مترافقاً مع ضعف الوازع الديني وتضخم الشعور بأهمية حرية السلوك الفردي الثائر على أدنى أشكال الالتزام الخلقي والقيمي.
وقد تزامن ذلك مع التحولات الاقتصادية بعيدة المدى وتوسع حركة التجارة الدولية والمحلية، وخاصة بعد ظهور الثورة الصناعية الكبرى في القرن التاسع عشر، وتطور الاقتصاد وانتقاله من مرحلة التبادل السلعي البسيط إلى اقتصاديات السوق الحرة، وتعقد عمليات التبادل النقدي، تبعاً للتطور العلمي والتقدم الصناعي، كل هذه التغيرات التي صنعت عالم الحداثة في المجال الحضاري الغربي، لفتت النظر إلى أن التمدن والتحضر ظاهرة معقدة، إذا ما حدثت فإنها تهز جذور الشجرة الاجتماعية، ومروراً بسائر مؤسسات المجتمع، وانتهاءً بدائرة فن العمارة والبناء …
——————–
يذكر المؤلف أن السبب الرئيس الذي دفعه للاهتمام بالموضوع، هو الإجابة على التساؤل المتعلق بكيفية المحافظة على منجزات العمل وحماية إطاره المرجعي بصفة عامة، باعتبار ذلك مشكلة جوهرية من مشكلات البناء الحضاري.
أما لماذا اختار هذا العنوان: “منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية“، فبسبب الطابع “النموذجي الفذ” الذي تكتسبه الحركة النبوية المعصومة بالنسبة لغيرها من التجارب البشرية الأخرى، والسعي إلى لفت الأنظار إلى الاتِّباع الأصوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي الأمثل به…” وهو ما يلزم دعاة المشروع الإسلامي بالعمل على الارتقاء بفهمهم وأدائهم الرسالي…”.
ويرى المؤلف أنه رغم التعدد الخصب لزوايا رؤية السيرة النبوية، فإن العناية “بالمنهج” ظلت قليلة، مما دفعه إلى محاولة تقديم قراءة “للحركة النبوية” في اتجاه البحث عن هذا الموضوع (43-46).
والمؤلف لا يخفي أن انشغاله بهموم العمل الإسلامي المعاصر، ومحاولة الوصول إلى منهجية سليمة، تضمن عدم تسرب الخلل إلى مضمونه المرجعي، وحمايته من التشويه، والتحريف، والاختزال في كل مراحل الطريق، وضمان روح الاستمرارية، والمحافظة على المنجزات، واستثمارها بفاعلية… كل هذا جعله يقدم على دراسة هذا النموذج التطبيقي الفذ الذي تكمن من تجاوز هذه “الإشكالية الكبرى”. وتبدو واضحة روح المؤلف الحريصة الحادبة، المستلهمة للدروس والعبر، التي تسعى لتشكيل رؤية منهجية من خلال الدراسة، حيث يمكن الاستفادة منها في الواقع المعاصر.
غير أننا لا نجد جواباً لتساؤل يلح علينا وهو لماذا المرحلة المكية فقط، وبالذات؟ ولماذا لم يقم المؤلف، سعياً إلى تكامل الرؤية والمنهج، بدراسة المرحلة المدنية مع المرحلة المكية؟ وبطريقة أخرى، هل تكفي المرحلة المكية لاستخراج منهجية نبوية …
——————–

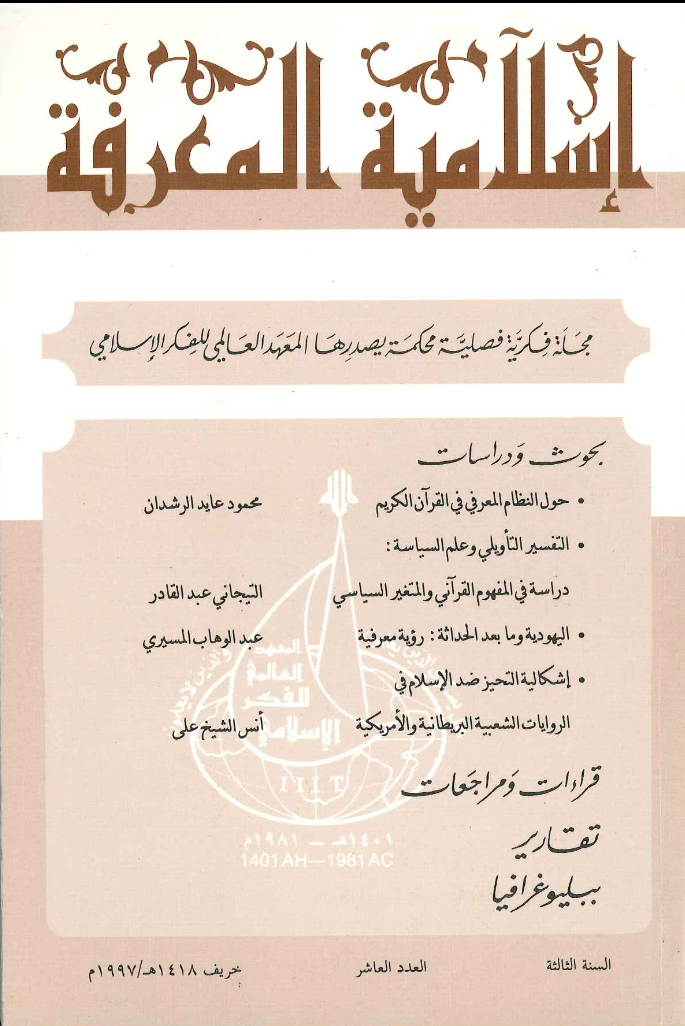
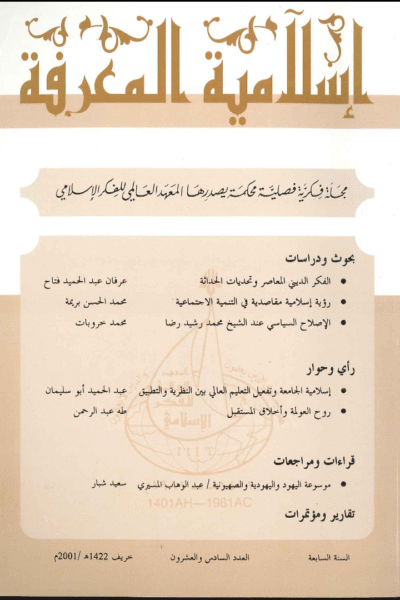
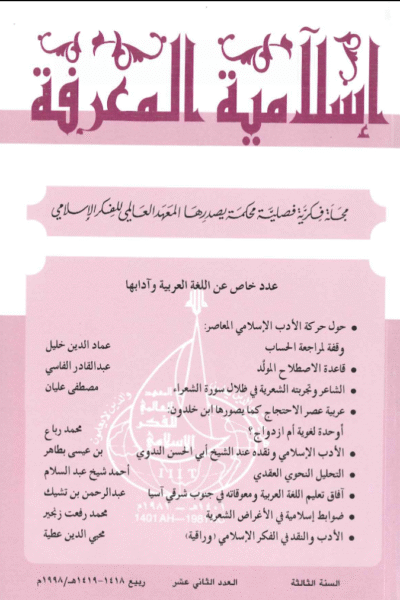
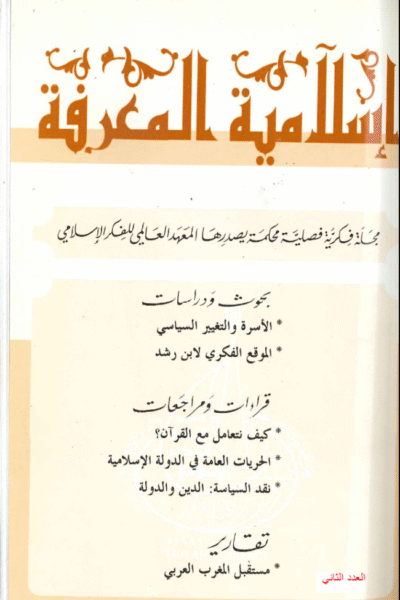
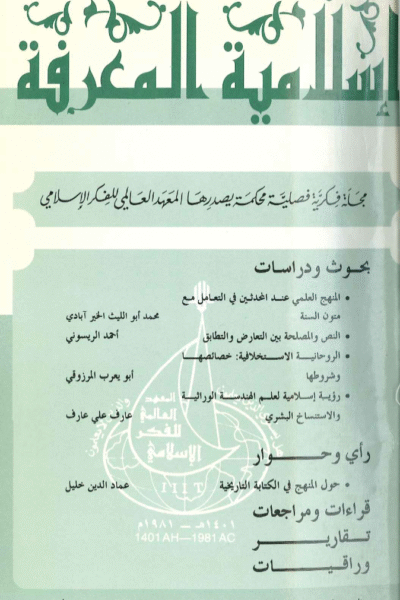
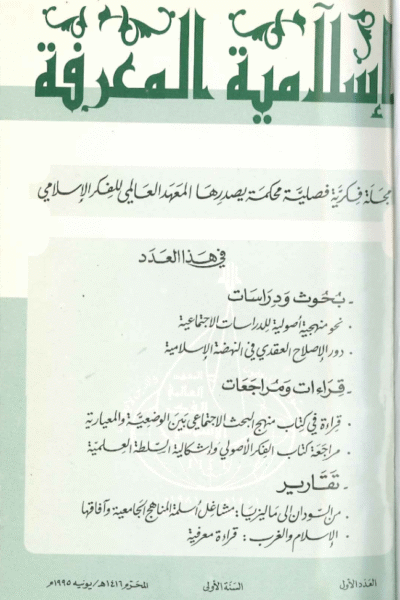
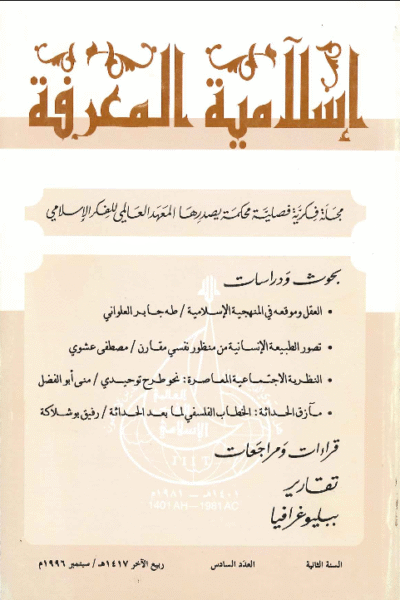
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.