الوصف
كلمة التحرير
===========
بهذا العدد تستقبل المجلة عامها الخامس، آملة أن يكون خطوة إلى الأمــام، فقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة سننية مفادها أن من تشابه يوماه – حــاضره وماضيه – فهو خاسر مغبون.
لذلك فإن المجلة تستمر في تطوير خطابها في اتجاه تأصيل قضايــا الإســلام المعرفية، باعتبارها رسالة المعهد التي يستهدف بها استعادة الهويـــة الحضاريــة للأمة، والإسهام الفعال في تقدم الحضارة الإنسانية.
ولا نعني بالتأصيل هنا الاقتصار على تكرار الأطروحات العامة التي تحمــل مفاهيم كلية، استقرت أو كادت تستقر في العقل المسلم المعاصر، وإنما نضيف إلى ذلك ولوج أبواب البحوث التطبيقية والنماذج الميدانيــة في شتى فــروع المعرفة، كخطوة متطورة في طريق الأسلمة من جــانب، وكاختبــار عملــي للأطروحات الكلية، مضمونا”، وكفاية”، وصلاحية للتطبيق، من جانب آخـــر، وهو ما بدأته المجلة في أعوامها المنصرمة.
ولعل ولوج أبواب البحوث المتخصصة يتطلب إفراد بعض أعــداد المجلــة بفرع واحد من فروع المعرفة أو مجال واحد من مجالاتها، بحيث تستكتب حولــه أقلام الفنيين، وتتجمع الروافد ذات الاختصاص الواحد، لتصب في ملف مؤطر سلفا” لخدمة ذلك المجال. وهو أمر درجت عليه الدوريات العلمية، مــا بــين الإسراف والتقتير، ونحســب أننا سنتخذ طريقا” وسطا” بينهما فنخطــط لمحــاور اهتمامنا، ونستكتب حولها أهل العلم بها، إلى أن يجتمع من إسهاماتهم ما يحقق الخطة المرسومة لملف موضوعي كامل، يستوعب أغلب صفحات العـــدد، دون أن يطغى على أبوابه الثابتة.
ومن الطبيعي أن نشرك الكتاب والقراء في طرح الأفكار الـــتي يمكـــن أن تتشكل منها محاور للمستقبل، ولذلك فإننا نستهل هذا العام بتلــك الدعــــوة المفتوحة لتبادل الرأي حول أولويات الاهتمام لدى العقل المسلم المعاصر التـي يمكن طرحها على صفحات إعداد السنة الجديدة من عمر المجلة.
وفي هذا العدد الذي بين أيدينا، يقدم لنا التيجاني عبد القادر رؤيته عن فقد الإصلاح الإسلامي من خلال قرأته لحركتين من حركات المقاومة المسلحة، أولاهما تلك التي قادها الأمير عبد القادر في الجزائر في ثلاثينيات القرن …
بحوث ودراسات
==============
يبدأ البحث بمقدمة تتناول العلاقة بين إعادة ترتيب القاعدة الفكرية، وتغيير المجتمع المسلم، وتناول ظاهرة الانحطاط الداخلي وظاهرة النهضة التي تتبعها. واكتفى بذكر بعض الظواهر السالبة في المجتمع المصري، والجزائري أثناء الاحتلال الأوربي لهما. ثم تطرق إلى بوادر النهضة الإسلامية الحديثة ممثلة في مدرسة الأفغاني، ومحمد عبده وابن باديس. ويرى أن عملية إعادة قراءة القرآن الكريم، لإيجاد منظومة مفاهيمية بديلة تجيء مرتبطة بعملية إعادة بناء المجتمع المسلم. ويركز البحث على الفروق الجوهرية في مقاومة الاستعمار بين حركة الأمير عبد القادر في الجزائر وحركة أحمد عرابي في مصر وتأثيرهما في شمال إفريقية وفي آسيا، في ظل هذه المبادئ التي تدعو إلى الرجوع إلى القرآن من أجل “النهضة” و”الإصلاح” للأمة متمثلة في الأفغاني، وعبده، وابن باديس.
لقد نمت الدراسات المستقبلية في الآونة الأخيرة، وأصبح لها ارتباط وثيق بالتخطيط للمعاهد السياسية، ومكاتب التخطيط الحكومية. وبحثنا هذا في نقد طرق مقاربة المستقبل، وعرض للمشاهد المستقبلية للعالم الإسلامي، ويغطي كذلك نماذج عالمية متنوعة كنـمـوذج نـادي رومـا “حدود النمو”، ونموذج “البشرية عند المنعطف”، ونموذج “عالم عام ألفين” وغيرها. وانطلاقاً من نظرية ما بعد البنيوية يسأل البحث عما تفتقده هذه النماذج المعرفية؟ وما الذي يجعل تحليله المعرفي متميزاً؟ وأي الأطر المعرفية تؤكد عليها النماذج المستخدمة؟ ويتطرق البحث للأطر المعرفية والحضارية وخاصة من المنظور الإسلامي، ويختم البحث ببعض التوصيات لجعل الأمة الإسلامية أكثر توجهاً نحو المستقبل.
الملخص
إن دراسة العقيدة الإسلامية ومنهجها من خلال الجدل التاريخي الكلامي مفيد لمحاولة استخلاص العبر، لتفعيل العقيدة في واقعنا المعاصر. لذلك يتناول البحث عرضاً وتقويماً لكتاب “منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة” للدكتور أحمد عبد اللطيف، إذ يتناول منهج إمام الحرمين في تناول العقيدة الإسلامية، ومحاولة تقويمه عن طريق الاحتكام إلى منهج السلف كما بينه ابن تيمية، فهو مقارنة بين منهجين. وتعد “مسألة التأويل” قلب الخلاف المنهجي بين المذاهب الكلامية والمدرسة السلفية، وهل يستدل على العقائد بالعقل أم بالنقل؟ ويتناول البحث مدى تأثير المنطق اليوناني في المجال العربي الإسلامي.
رأي وحوار
===================
في ختام سورة يوسف نقرأ هذه الآية الكريمة ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (يوسف:111). وهي تضعنا قبالة التعامل مع التاريخ في المنظور القرآني يستهدف البحث عن العبرة، أي الجوهر والمغزى، وهو خطاب موجه لذوي البصيرة القادرين على سبر هذا المغزى، والإفادة منه في واقع حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وليس لذوي المصالح القريبة والتحزبات والأهواء. وهو –أيضا– معطى يحمل مصداقيته المنبثقة عن علم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي وسع كل شئ علما. فهو –إذن– ليس رجما بالغيب، ولا أهواء وظنونا، كما هو الحال في العديد من الأعمال التاريخية الوضعية.
فإذا مضينا لتدارس القرآن الكريم كله، فإننا سنجد كتاب الله يخصص مساحات واسعة، قد تزيد عن نصف القرآن للخبر المتحقق في الماضي، والسنن التي تحكمه، أي للتاريخ وقوانين الحركة التاريخية.
إن قصص الأنبياء والشهداء والقديسين، أخبار الأمم والشعوب والجماعات والقرى… حلقات الصراع المتطاول بين الحق والباطل والهدى والضلال… كلها في نهاية عروض تاريخية تغذي هذا الفرع المعرفي بالمزيد من المفردات والإضاءات.
والتعامل القرآني مع التاريخ بأخذ صيغاً مختلفة تتدرج بين العرض المباشر والسرد القصصي لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص بمتاز بالتركيز والكثافة للسنن التاريخية التي تحكم حركة الإنسان في الزمن والمكان أي في التاريخ. فإذا ما أضفنا إلى هذا وذاك تلك الآيات والمقاطع القرآنية التي يحدثنا عنها المفسرون في موضوع أسباب الترول، والتي جاءت في أعقاب عدد مزدحم من أحداث السيرة لكي تعلق وتعقب وتفند وتلامس وتبني وتوجه وتصوغ، استطعنا أن نتبين أكثر فأكثر أبعاد المساحات الكبيرة التي منحها القرآن الكريم للتاريخ.
إن جانبا كبيرا من سور القرآن الكريم وآياته البينات ينصب على إخطار البشرية بالنذير الإلهي، وينبثق عن رؤية وتفحص التاريخ، وبمقدور المرء أن يلحظ – عبر تعامله مع كتاب الله – كيف تتهاوى الجدران بين الماضي والحاضر والمستقبل، كيف يلتقي زمن الأرض وزمن السماء، قصة الخليفة ويوم الحساب، عند اللحظة الراهنة، حيث تصير حركة التاريخ، التي يتسع لها الكون، حركة متوحدة لا ينفصل فيها زمن عن زمن، ولا مكان عن مكان، وحيث تغدو السنن والنواميس، والمفاتيح الضرورية التي لا بد منها لفهم تدفق الحياة والوجود، وتشكل المصائر والمقدرات. ولنا أن نتصور القيمة البالغة التي أولاها كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم[1] لأحداث الماضي ذات الدلالة، أي للتاريخ. يعتمد القرآن الكريم في معطياته عن الوحدة …
قراءات ومراجعات
===================
حاول الباحث في هذا المقال بيان الأفكار الآتية:
– الراغب الأصفهاني في تاريخ الدراسات القرآنية عامة ومعجمات القرآن خاصة، بسبب عنايته بالسياق (لخصوصية مدلولات ألفاظ القرآن).
– هذا الكتاب مرجع في تحقيق مفردات القرآن، وفي تجديد العديد من مصطلحات العلوم الشرعية. بل في علوم أخرى أيضاً.
– إعادة النظر في عد المفردات ضمن كتب الغريب، فصحيح أن فيه الغريب، ولكنه ليس كتابا في الغريب.
– أن الراغب اهتم بمفردات القرآن ضمن نسق معرفي تطلع من خلاله إلى بناء رؤية أو نظرية في علم بيان القرآن. كما وقف الباحث عند بيان:
– مظاهر التدخل بين مفردات القرآن وبين مصطلحات العلوم الشرعية: ومنها: تنوع صور المصطلحات الواردة في الكتاب بالنظر إلى علاقتها بالقرآن الكريم. فمنها المصطلح الذي احتفظ بصورته القرآنية (كالبيع) ومنها الذي اختلفت صورته لكنها مشتقة من لفظ القرآن (كالملاعنة)، ومنها الذي هو مستقل بصورته ومفهومه (كالمحاضرة).
– تنوع مصطلحات العلوم الواردة في المفردات بين مصطلحات فقهية وأصولية وكلامية ومصطلحات أخرى، والعرض أورد نماذج منها مما يظهر فيه ضرب من التداخل والتكامل.
كتاب مفردات القرآن “لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، من أهم وأحسن ما ألف في مجال الدراسات القرآنية واللغوية. وهذه الأهمية نابغة من كون الكتاب محتويا على ثروة لغوية نفسية، محررة، ومرتبة ترتيبا معجميا، يفيد عموم الباحثين في العلوم الإسلامية والعربية، وقد وظف الراغب هذه الثروة اللغوية في تحقيق ألفاظ القرآن وتحصيل معانيها. وانتهى به منهجه في الكتاب إلى نموذج متفرد في تحديد الدلالة القرآنية تحديدا دقيقا. ذلك بأنه اجتهد في …
عروض مختصرة
===================
- Christopher Melchert, The Formation of The Sunni School of Law, 9th-10th Centuries (Leader, Brill, 1997) pp 272.
- Richard Yeomams, The story of Islamic Architecture, (London: Garmet Publishing, 1998) pp. 252.
- Hasan Kayali, Arabs and Young Truks: Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918 (Berkeley: University of California Press, 1997) pp. 308.
- Azmi Ozcan, Pan-Islamism: Indian Muslims, The Ottoman and Britain (1877-1924) (Leiden: Brill, 1997) pp. 237
- – Jakob Skovgaard-Petersn, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar al-Ifta, Social Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia (Leiden: Brill, 1997) pp. 431.

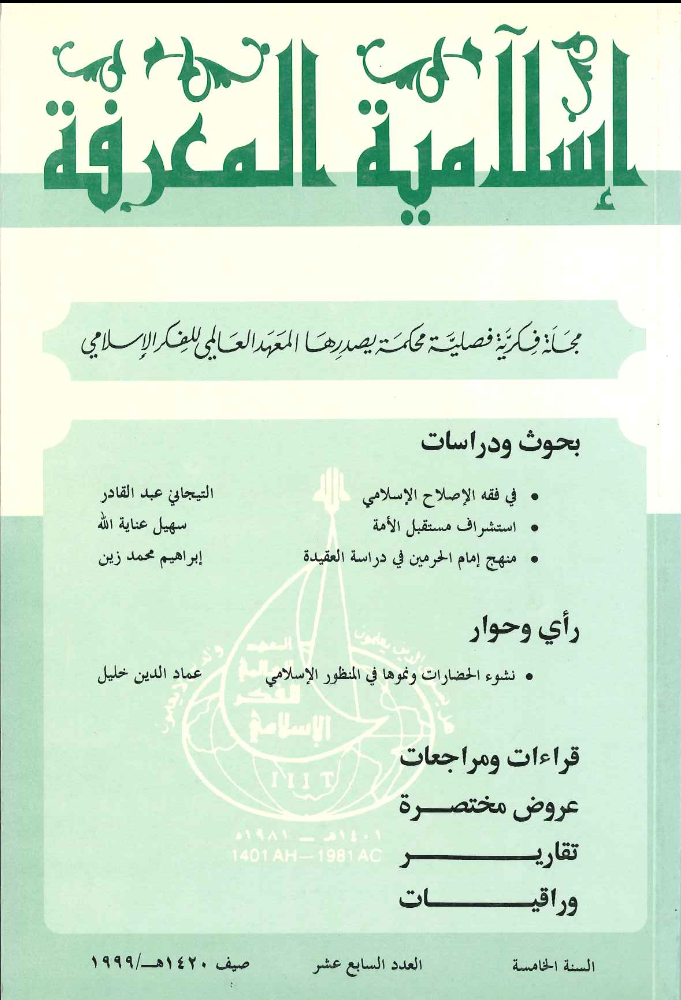
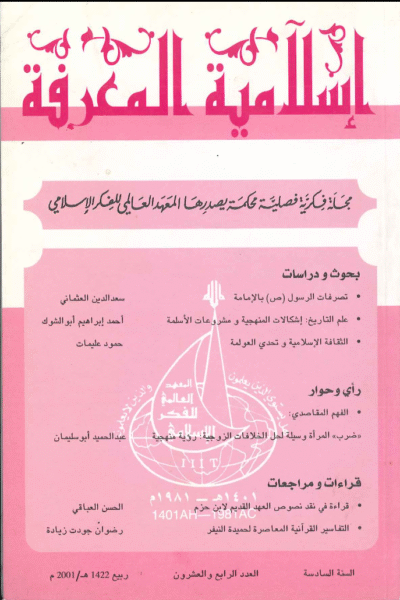
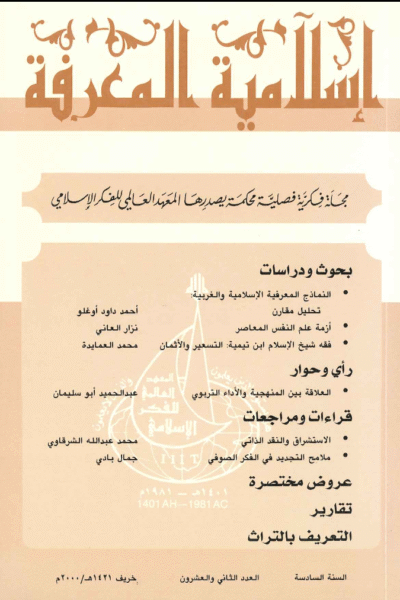
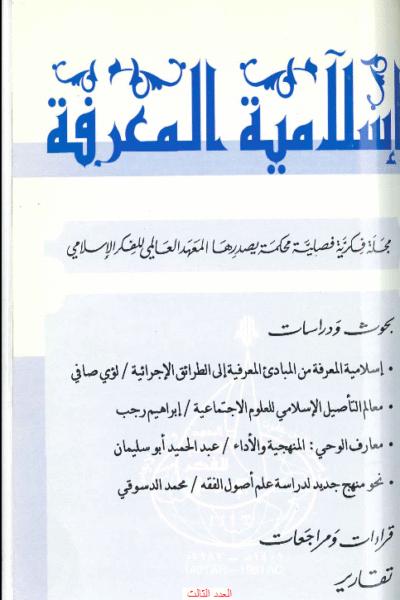
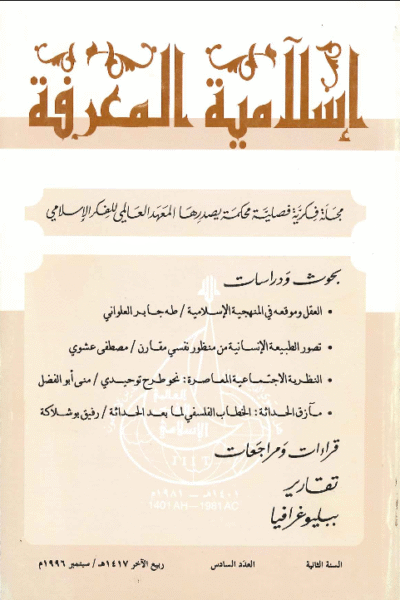
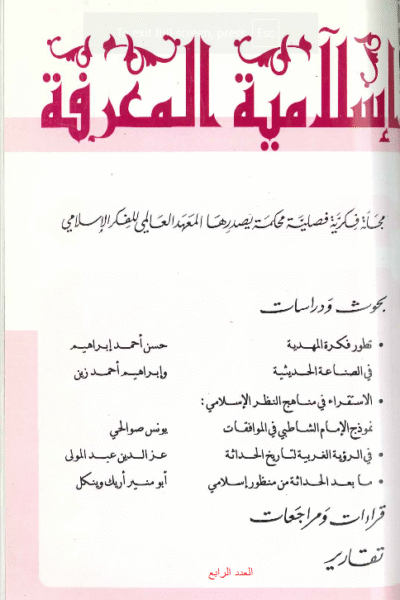
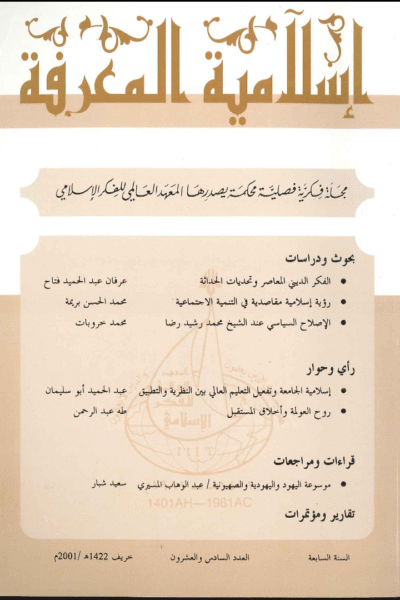
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.