الوصف
كلمة التحرير
===========
هذا هو العدد الثامن عشر من المجلة في عامها الخامس، استهله عبد الرحمن الكيلاني بدراسة أصولية بالغة الأهمية, تستهدف تقعيد مفاصد الشريعة، وإحصائها بإطار من المعايير الحاكمة والمعالم الهادية المرشدة. فبيّن حقيقة القاعدة المقصدية الأصولية، منتهياً بالدعوة إلى مزيد من البحث والدراسة لموضوع قواعد المقاصد حتى يغدو بحثاً خاصاً من مباحث مقاصد الشريعة، وأوصى بدراسة تللك القواعد دراسة تحليلية تأصيلية يبين حقيقتها وتظهر أدلتها وتكشف عما ينبثق عنها من قواعد وأصول، وتعمد إلى تفعيلها بالصور التطبيقية والوقائع العملية.
ويقدم لنا عبد الجبار سعيد إسهاماً متميّزاً في واحد من المحاور التي تدور عليها رسالة المجلة، ذلك هو محور منهجية التعامل مع السنة النبوية. وهو يحاول في بحثه أن يتحسس الأسباب التي حادت بالسنة النبوية عن أداء دورها التشريعي إلى دور آخر فاعل في البناء الحضاري، وأن يستكشف الضوابط المنهجية التي يمكننا من خلالها أن نحسن قراءة النص النبوي بعد إثبات صحته.
إن منهجية التعامل مع السنة النبوية رواية ودراية باب مفتوح للبحث والتأليف، وهذا البحث يعد إسهاماً في هذا الاتجاه.
ويقدم لنا نعمان بو قزة رؤيته لابن حزم الأندلسي باعتباره صاحب مشروع ثقافي أصيل استهدف إعادة الإعتبار لسلطان النص والعقل اللذين شوهتهما مشروعات أخرى قامت على الثقافة الغنوصية والباطنية وكتناه الأسرار وتعطيل السنن الكونية. لقد لقد تناول الكاتب في ورقته أصول نظرية المعرفة عند ابن حزم وأبعادها، كما رسم ملامح المنهج العقلي والتفكير العلمي عنده، ثم شرح موقفه من المنطق والفلسفة، وعرج على موقفه من بقد القياس الأصولي، مبدياً كيف أدرك ابن حزم طبيعة المأزق الذي وقعت فيه الأمة في زمنه، وكيف أخذ المبادرة بثورته الفكرية التجديدية عند نقد أصول الفقه بهدف تأصيلها، وكيف أن ظاهرية ابن حزم تجاوزت بذلك حدود المذهب الفقهي إلى رحابت المشروع الثقافي البديل.
وفي باب الرئي والحوار يقدم لنا وليد منير رؤية لأبعاد النظام المعرفي في الاسلام، انطلاقاً من أن لكل دائرة حضارية نظامها المعرفي في الاسلام ينبع من مفهوم التوحيد ليمتد إلى أبعاد أربعة، هي الوحي والكون والعفل والتاريخ، وأنه بذلك يتميّز عن غيره من الأنظمة بخصوصية كل من ثقافته وحضارته على حد سواء. وإذا كانت المنظومة التشريعية تعتمد الوحي المنزل مصدراً فإن المنظمة الفكرية – كما يرها الباحث – تتشكل من البيان والبرهن والعرفان. وإذ يعرض تفصيلاً لهذه المفردات، يؤكد أن النظام المعرفي في الاسلام لا ينفصل بحال عن نظام الاعتقاد والقيم، كما يؤكد على المفاهيم الحديثة للوسطية باعتبارها سبيلا بين العقلانية العمياء واللامعقولية العاطفية، أو بين الايمان النفرط بالعلم من جهة وتشويه سمعة العلم من جهة أخرى، كما يؤكد على قيمة الشورى كمنهج إجرائي يوفر جماعية القرار من ناحية ويضمن جماعية المسؤولية من ناخية أخرى …
بحوث ودراسات
==============
يتناول الباحث حقيقة القاعدة المقصدية، ومكانتها في التشريع، وعلاقة القواعد الكلية بجزئيات الشريعة وفروعها. ثم يبين كيفية الاسترشاد بالقواعد، وكيف أنهـا لا تقبـل النسـخ ولا النقض، ويرشد إلى تميز القاعدة المقصدية، مبيناً الفرق بينها وبين القاعدة الفقهية، من حيث الحقيقة، والحجية والمكانة، والأهمية والاعتبار، ومن حيث الاختلاف والاتفاق على مضمونها. ثم يبين الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الأصولية، من حيث المضمون والموضوع، والمصدر، ويوضح أقسامها من حيث المضمون، والكلية والعموم، ومن حيث صاحب القصد. موصياً بمزيد من البحث في الموضوع.
يبين الباحث أهمية الموضوع وأهدافه، شارحاً جهود السابقين فيه. ثم يتناول مصطلحات الموضوع، ومصدرية السنة، ويذكر سبعة مظاهر للخلل في التعامل معها. ثم يضع الضوابط المنهجية التالية: التوثق من الحديث سنداً ومتناً وفق قواعد وشروط محددة، وعرض السنة على القرآن الكريم، وعرضها على السنة سنداً ومتناً، وعرضها على الحقائق الكونية والتاريخية والعلمية، وعرضها على المقاصد، وفهم السنة في سياقها الزمني الواقعي الذي وردت فيه، وحسن تنزيلها على الواقع. مختتماً بالدعوة إلى تواصل جهود علماء الأمة ومفكريها للاستجابة لما أثاره البحث من قضايا وإشكالات.
الملخص
يحاول البحث الإجابة عن سؤال: هل الظاهرية مذهب فقهي أم مشروع ثقافي بديل؟ ثم يتناول نظرية المعرفة عند ابن حزم: أصولها وأبعادها، وملامح المنهج العقلي والتفكير العلمي عند ابن حزم، ومواقفه من المنطق والفلسفة، ونقده للقياس أصولاً، ويشرح مفهوم الدليل وحجيته في النظرية، وظاهرية ابن حزم في ضوء مفهوم البيان، مختتماً بتقرير أن ابن حزم قد أدرك طبيعة المأزق الذي وقعت فيه الأمة في زمنه، وكان من اللازم القيام بثورة فكرية تجديدية مبدؤها نقد الأصول بتأصيلها، وطرح ما نتج من خيارات خاطئة ما زالت حضارتنا أسيرة لها إلى اليوم.
لا بد أن تطرح كل أيديولوجيا نظامها المعرفي الخاص بها حيث تمثل مقولاتها شبكة تفسيرية واضحة تدعم القدرة على الفهم الشمولي والفعل المؤثر في آن. بيد أننا نذهب إلى أن النظام المعرفي في الإسلام لا ينبثق من أيديولوجيا سابقة لأن كل أيديولوجيا لا تخلو –بقدر ما– من يزييف نسبي للوقعي إذ تتبنى، عن عمد، زاوية محددة للنظر يفضي تغليبها على زوايا النظر الأخرى إلى اعتبار الجزء المرئي من الحقيقة بمثابة الحقيقة كلها. وهنا يكمن الاختلاف الأساسي بين الأيديولوجيا والعلم.
ينبع النظام المعرفي في الإسلام من تحاور المنظورات المختلفة داخل سياق واحد يجد مردوده الأصيل في مفهوم “التوحيد” وتتمثل تأسيساته الجذرية في التفاعل الزمني المتبادل بين ثلاثة أطراف: الله، الكون، الإنسان. ويعلن هذا التفاعل الزمني عن نفسه بصور شتى في النص الذي يعد مرجعاً مهيمناً على ما سواه، إذ يمتلك فضاءً واسعاً من الاستجابات المرنة لأفعال التاريخ التي تعثر بدورها على مفهوماتها الكبرى ووظائفها المتجددة في النص، وبه، وعبر امتداداته.
وإذا كان العلم هو الضد المباشر للأيديولوجيا، فإن النص، هنا، لا يعني – في جوهره – العلم كما نعرفه أو نعرِّفه، ولكنه يعني فضاء القيم الثابتة التي تشمل وقائع العلم بعد تجريدها من تعارضاتها المتحولة ومن تبدياتها الجزئية بحيث تصبح النتائج الأخيرة للوقائع العملية إشارات إبى الحقيقة الكلية التي تمثلها هذه القيم الثابتة. لذلك نستطيع أن نقول إن العلم يبدأ من نقطة تقع المعرفة وراءها.
ولما كان العلم هو تاريخ الخطأ المصوّب كما يقول باشلار، فإن المعرفة – وفقاً للمفهوم الإسلامي عنها – هي المدى الذي تلوح في أقصاه جملة التصويبات التي تشكل الحقيقة الأخيرة للمعنى. وبذلك يكون النظام المعرفي الإسلامي مكوناً من أربعة أبعاد هي: الوحي، الكون، العقل الإنساني، التاريخ. تناظر هذه الأبعاد مستويات أربعة تمثل تدرجات الفعل، وتعبر عن دور الممارسة في نظرية المعرفة هي: الوعي، والمادة، والتفسير والتأويل، والحدث في الزمان والمكان.
إنّ المعرفة سبيل إلى التعارف، والتعارف سبيل إلى الفعل، والفعل سبيل إلى التقويم. هكذا يكون الله تعالى مصدؤ جميع التسلسلات على هذا النحو:
الله – فعل الله – الكون الوسيط – معرفة فعل الله – تعارف الذوات المدركة – فعل الذوات المدركة – تقويم هذا الفعل بواسطة الله.
يقول تعالى: ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ (النمل: 93).
ويقول:﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13) …
——————–
قراءات ومراجعات
===================
إذا كان الجابري قد انتهى في دراسته لـ(نقد العقل العربي): (بأن العربي عقلٌ يتعامل مع الألفاظ أكثر مما يتعامل مع المفهيم، ولا يفكر إلا انطلاقاً من أصلٍ أو انتهاءً إليه أةو بتوجيه منه، الأصل الذي يحمل معه سلطة السلف إما في لفظه وإما في معناه، وإن آليته، آلية هذا العقل في تحصيل المعرفة –ولا نقول في إنتاجها– هي المقاربة والمماثلة معتمداً على التجويز كمبدأ، كقانون يؤسس منهجه في التفكير ورؤيته للعالم).
فإن كاتب السلطة في الإسلام يرى أن العقل الإسلامي “الراهن” يتجاهل بدرجة مؤسفة اعتبارات الواقع البشري المعاصر، مصراً على التعامل مع “النص” من خلال “الفقه” –الذي تكوَّن قديماً بأحكامه مع النص– فهم الشريعة من خلال السلف، والنتيجة لن تكون لإلا تغييباً للواقع الراهن خلف واقع السلف، هنا يفتقد النص طاقته التشغيلية الكاملة، ويظهر ذلك بوضوح في الفجوة الفاصلة بينه وبين العصر، وليس ذلك مقتصراً على العقل الإسلامي “المعاصر” أو “الراهن”، بل يؤكد على أن التعامل مع النص من خلال “سلفٍ ما” هو عادةٌ سلفية مستقرة، وحسب تعبيره فإن السلف أنفسهم كانوا “سلفيين” منذ البواكير الأولى.
لكنه يعود ليقرر أن لذلك ما يبرره لا سيما في هيمنة المنهج اللغوي إحساساً من هذا العقل في لا شعوره بمحدودية النص أو ثباته، فلقد كان من الطبيعي في ظل هيمنة هذا المنهج، أن يعجز العقل الفقهي عن التوصل إلى “قانون للنص” أي مبادئ الحركة التي تحكم عمل النص في الزمان، تلك المبادئ التي تكشف في النص عن قدرةٍ ذاتية على التمدد في الزمن من غير حاجة إلى مساعدة خارجية، ذلك أن النص في الحقيقة ليس محدوداً ولا ثابتاً.
وهكذا ينبئ الكاتب عن هدفه وهو الكشف عن قانون للنص، انطلاقاً من أن الحجة في الإسلام ليست لشيئٍ سوى للنص الهالص كتاباً أو سنة، في البدء كان النص حسب تعبيره، وأن “الإلزامية” في النص الخالص أيضاً ليست لشيئٍ سوى للنص الجازم وجوباً أو حرمةً، وأن عدم النص هو في ذاته “نص” بالإحالة على دائرة المباح، مما يؤدي ضرورة على القول بأن الأحكام في الإسلام لا تخرج عن دائرتين اثنتين، دائرة المباح أولاً ودائرة الالزام ثانياً، وبقدر ما تضيق الأولى تتسع الثانية، وبقدر ما تتسع الأولى تضيق الثانية.
وهكذا فإن ما سكت النص عنه كان مقصوداً، ومِن ثَمَّ فإن القول بالإجماع أو القياس وما ألحق بهما من مرجعياتٍ مفارقة للنص، مناقضةٌ لمقصود الشارع العليم في إنشاء دائرة الحرية، أو الكشف عن هذه الدائرة التي هي كائنةٌ بالأساس على سبيل الأصالة والابتداء، وذلك أن الإجماع والقياس كما هو معروف ووفقاً لصريح الشافعي نفسه لا يبدأان في “العمل” إلا عند …

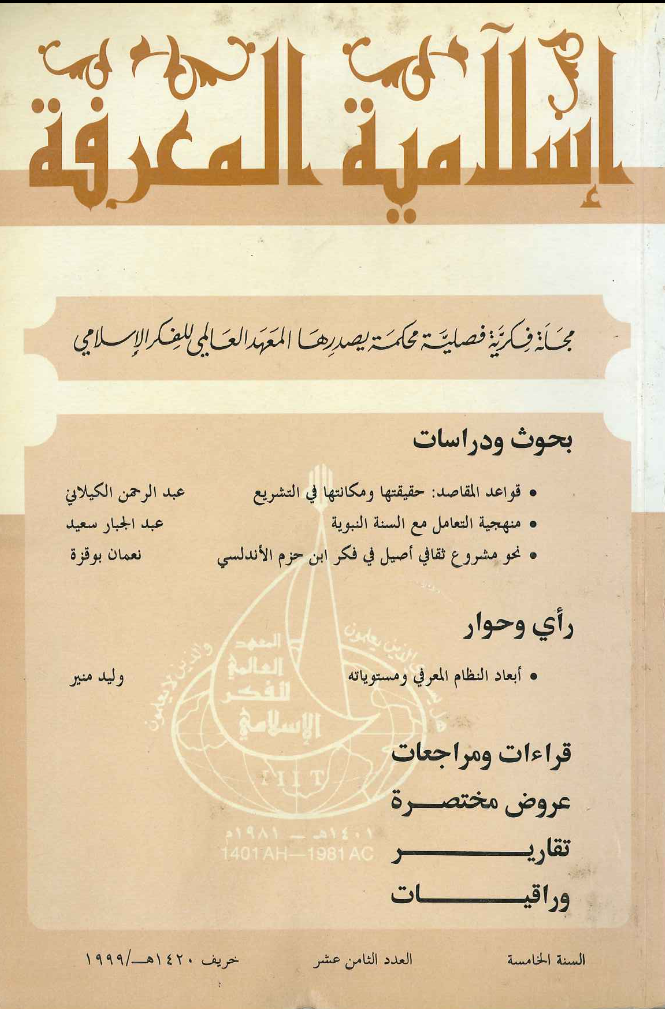
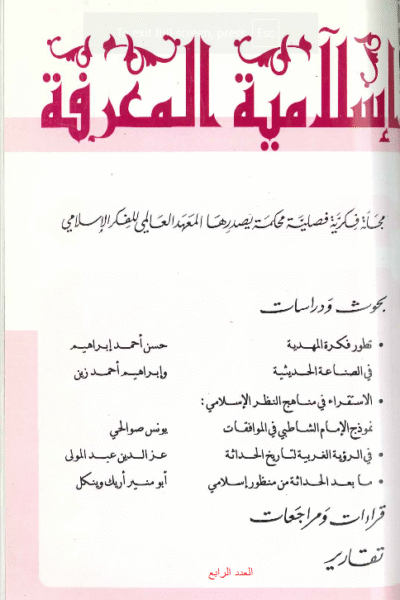
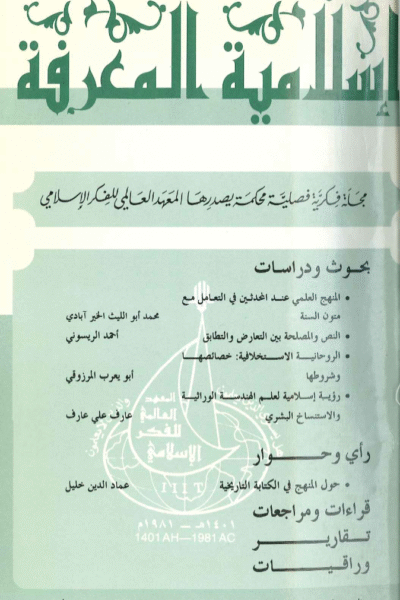
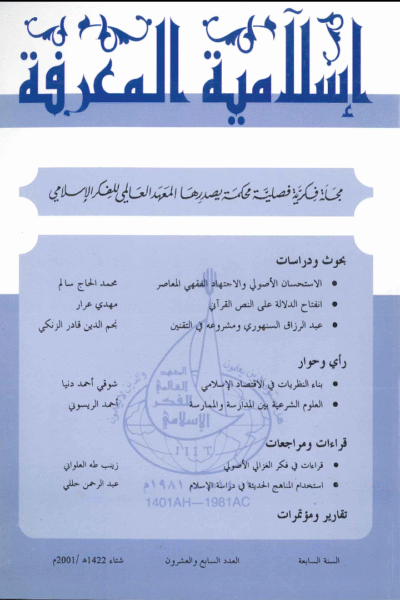
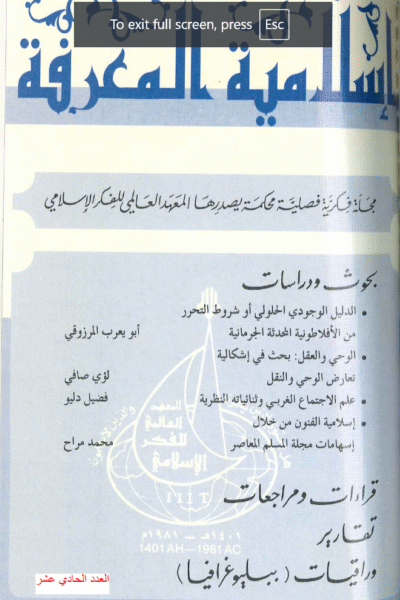
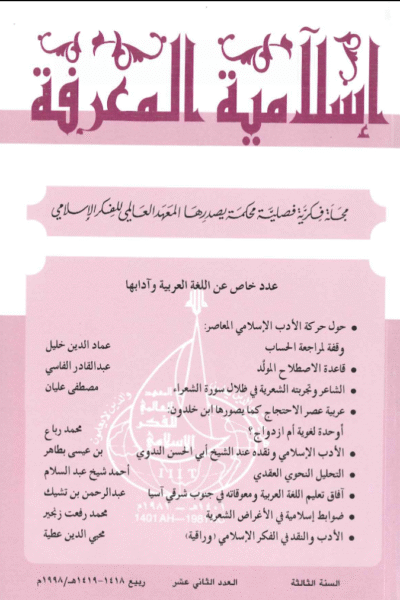
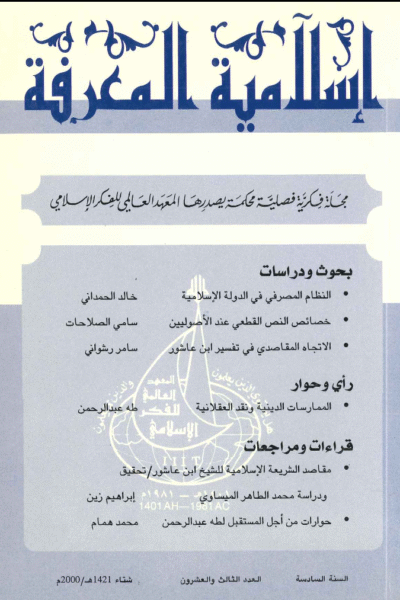
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.