الوصف
كلمة التحرير
===========
ملخص
إسلامية المعرفة” أو “التأصيل الإسلامي للعلوم والمعارف ” أو “توجيه العلوم وجهة إسلامية” أو “إسلام المعرفة” أو “النظام المعرفي الإسلامي” أو “علم العلوم والمعارف”، هذه وبعض مصطلحات أخرى تمثل تعبيراً عن قضية أساسية واحدة هي قضية “البديل الفكري والمعرفي والثقافي ثم الحضاري” الذي يمكن للإسلام أن يقدمه لعالم اليوم، بما في ذلك عالم المسلمين.
فمنذ أوائل هذا القرن و”المنظومة الفكرية والمعرفية والثقافية” الغربية تكتسح العالم كله، وتُعمل يد التفكيك في نظمه المعرفية والثقافية على اختلافها، لتحل هي محلها في سائر الجوانب وعلى سائر المستويات ودون تمييز. ومع هيمنة ذلك “النظام المعرفي الموضوعي الغربي” على الأرض انزوت وتراجعت “سائر النظم المعرفية الأخرى”، ومن بينها النظام المعرفي الإسلامي.
ولقد بدأت آثار هذا النظام المعرفي الوضعي تتجلى في شكل نظم وقوانين ومناهج تعليمية، وأنماط حياة وممارسات متنوعة، وذلك بفعل عوامل عديدة، منها:
أ- الجهود المكثفة التي بذلتها قوى الغرب لجعل ذلك النظام المعرفي وما انبثق عنه من مؤسسات وأنماط وسلوك وأساليب حياة سهلة ميسرة تستمد مرجعيتها من مركزية الإنسان ذاته، فلا يحتاج إلى مرجعية خارجية تشده إليها، أو ترهقه بنصوصها، أو تضطره إلى التسليم بقيادة مفسّري تلك النصوص أو إعطائهم سلطة قد لا يستحقونها!
ب- القدرة التفسيرية الهائلة لذلك النظام بقطع النظر عن صحة تفسيراته أو خطتها، وبقطع النظر عن اقترابها من الحقيقة أو مجانبتها لها، فالمهم أن يكون لكل حدث أو ظاهرة تفسير يمكن أن يقتنع إنسان العصر الحديث به اقتناعاً مؤقتاً أو دائما، لوقت قصير أو طويل، فالمهم أن تحدث له قناعة ما.
ج- نجاحه المادي الظاهر في تحقيق أهداف عاجلة حددها النظام المعرفي الوضعي ذاته، ونصبها أمام الإنسان قيماً عليا وغايات قصوى، كالرفاه والتنمية والتقدم ونحوها، بقطع النظر عن الثمن الذي قد تدفعه …
بحوث ودراسات
================
الملخص
تدعو الباحثة إلى تجاوز الجدل بين المؤيدين والمعارضين لإسلامية المعرفة، وتحاول الخروج من دائرة النظرية الاجتماعية الغربية، بتقديم منظور إسلامي قادر على تقديم إطار تحليلي أكثر تفسيرية للظواهر الاجتماعية والسياسية. وتبحث الدراسة في الوظيفة السياسية للأسرة في التغيير بمعناه الواسع الذي يروم استعادة إسلامية المجتمع والدولة. فتستعرض موقف الرؤية الغربية من الأسرة ووظيفتها السياسية، وإشكالية المجتمع والدولة في الغرب. ثم تعرض موقف الرؤية الإسلامية من المسئولية السياسية للأسرة، وتركز على وظيفة الأسرة في التغيير السياسي بشقيه الاجتماعي والثقافي، واختتمت بحثها بعرض خبرة الانتفاضة الفلسطينية بوصفها تجربة حضارية رائدة.
محمود الذاودي
الملخص
حلل البحث موقف المشرع التونسي من مسألة تعاطي الخمور في الإطار الثقافي والاجتماعي الذي تغلب عليه حالة من اللامعيارية والازدواجية، مبرزاً موقع النخبة ومسؤولياتها، ومشيراً إلى أن النتائج التي توصل إليها صالحة للتعميم على أكثر المجتمعات العربية الإسلامية. فيبدأ البحث بتناول الظاهرة، ويناقش عامل الزمن فيها، وموقف الإسلام منها، والموقف المتذبذب للمشرع القانوني في تونس وانعكاسه على المجتمع، ومدى قدرة هذا المجتمع على مجابهة آثاره. ثم ناقش مشكلة الجمع بين النموذج الإسلامي، والغربي في التعامل مع تلك الظاهرة، وكيف يمكن تبني النموذج الإسلامي لمعالجتها؟
يركز البحث حول إبراز الموقع الفكري لابن رشد الحفيد من خلال دراسة بعض القضايا الإشكالية في تراثه الفكري مثل العلاقة بين الحكمة والشريعة، ومفهوم التأويل، ومفهوم الحقيقة. يبدأ البحث بعرض تعريفي بابن رشد وتاريخه، ومؤلفاته، وفلسفته حول العلم الإلهي بالجزئيات، وعلاقة العناية الإلهية بالأفعال الإنسانية، وقدم العالم وحدوثه، وعلاقة الفلسفة الإسلامية بالشريعة، وموقفه من الخوارق والمعجزات، والمقارنة بين مفهوم التأويل في الفكرين العربي والغربي، ويركز حول كتابه (فصل المقال) ناقداً تحليل فرح أنطون لفلسفة ابن رشد من خلال النموذج الوضعي العلماني لا من خلال النموذج الإسلامي الذي انطلق منه ابن رشد.
——————–
يدعو البحث إلى ضرورة الطرح المعرفي للقضايا السياسية التي تهم العالم العربي بوصفه كياناً تاريخياً. وذلك من خلال دراسة مفاهيم ثلاثة هي (الإصلاح، والمصلحة، والتصالح) مستخلصاً أن وحدة الدلالة فيها تفيد معنى التلازم والترابط؛ إذ إن المصالحة تستلزم الإصلاح، لتحقيق المصلحة. ويسأل الباحث لماذا المصالحة العربية وكيف تتم؟. ثم يعرض لمعنى الإصلاح، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الدولة والمجتمع، والتفاعل بين وحدات الكيان العربي. ثم مفهوم المصلحة في ظل الواقع العربي الراهن، ومفهوم التصالح أو المصالحة، مختتماً بالنقد والرفض لمفهوم الشرق الأوسط الجديد المقصود به الانسجام مع متطلبات النظام العالمي الجديد.
——————–
قراءات ومراجعات
===================
في هذا الكتاب –المدارسة- المعنون بصيغة السؤال (كيف نتعامل مع القران ؟)يكشف عن أسباب القصور ومواطن الخلل في فهم القرآن وتفسيره، مسلطاً الضوء على وسائل هذا الفهم وأهدافه، وقد حاول تحديد الضوابط والأسس القويمة في كيفية تلقي القرآن كي تحقق الأمة من خلاله النهضة والشهود الحضاري كما تحقق لها ذلك في سالف تاريخها.
يمكن تصنيف القضايا التي تناولها المتدارسان في هذا الكتاب إلى محاور ثلاثة هي:
أولاً: أسباب الأزمة ومظاهرها:حيث عرض الكتاب لأسباب تخلف الأمة عن الارتقاء إلى مستوى الخطاب القرآنى والشهود الحضاري، وأشار إلى أن الأزمة أزمة عقيلة فكرية بالأساس، مبينا العوامل المسببة لها. وأهمها: الحكم اللاشوري والاستبداد السياسي، وانفصال العلم عن الحكم مما أنتج تخلفا في مجالات حياة الأمة كافة، وكذلك تعطيل قانون السببية، والاعتماد على المرويات الضعيفة أو المدخولة وإعطاؤها الأولوية بحيث أصبحت حاكمة على القرآن الكريم، وعدم الوعي بالخطاب القرآني من حيث الشمولية والعالمية، والغفلة عن الفقه الحضاري، وفساد مناهج تعلم القران وتدريسه، وتقديس الأبنية الفكرية القديمة، وترجمة فكر اليونان ومنطقهم.
ثانيا: مناهج التعامل مع القران الكريم فهما وتفسيرا، حيث عرض الكتاب للمناهج القديمة والحديثة، وبين أسباب عجزها عن التعامل مع القرآن دون إغفال للجوانب المحمودة فيها. ويكمن قصور هذه المناهج، في رأي الشيخ الغزالي ومحاوره الأستاذ عمر عبيد حسنة، في العجز عن اكتشاف الأدوات الموصلة إلى الفهم الصحيح، والعجز عن إدارك محاور القرآن والمعاني الجامعة فيه، وإغفال فهم السنن الإلهية في الأنفس والآفاق، والتكلف في فهم القرآن، وتطبيق مبدأ النسخ في كل قضية تُشكل …
الملخص
يهدف هذا الكتاب إلى إبراز بعض الضوابط والمعالم المهمة التي تعصم المرء من سوء فهم السنة، ومن إساءة التعامل معها، ويرمي في الوقت نفسه إلى تجلية جانب من مناهج السنة التي لا تزال الدراسات حولها نادرة، على الرغم من شدة حاجة الأمة إلى مثل هذه الدراسات.
وقد ركز الشيخ القرضاوي على تأصيل هذا المنهج، فحاول، في أبواب الكتاب الثلاثة، أن يبلور بعض المعالم والضوابط الأساسية في هذا الموضوع. فتطرق في الباب الأول إلى بيان “منزلة السنة النبوية وواجبنا نحوها، وكيف نتعامل معها”، تلك المنـزلة التي تكمن في كونها تفسيرا عمليا للقرآن، بل منهجا عمليا للإسلام، ذلك المنهج الشامل لمجالات حياة الإنسان وجوانبها كافة. وهو منهج يتميز بالتوازن بين الروح والجسد، وبين العقل والقلب، وبين الغيب والشهادة، وبين الحرية والمسؤولية، لأن أي اختلال يطرأ على هذه الثنائيات، يؤدي، حتما، إلى البوار في حياة الإنسان. كما أنه منهج يتميز باليسر والسماحة.
وقد كان خليقاﹰبالمسلمين في كل عصر ومصر –كما يرى المؤلِّف- أن يحسنوا فهم ذلك المنهج الشامل المتوازن الميسر، وأن يعاملوا مع السنة النبوية الشريفة فقهاﹰ وسلوكاﹰ، قولاﹰوعملاﹰ،كما تعامل معها جيل الصحاة، والتابعين. بيد أن حال المسلمين اليوم يظهر بوضوح أنهم يمرون بأزمة حادة تتجلى في طريقة تعاملهم مع سنة نبيهم –عليه الصلاة والسلام-،وفهمهم إياها. ولهذا، ولكي تحق الصحوة الإسلامية الىمال المعقودة عليها، وتبلغ الأهداف التي تنشدها، فإن عليها أن تحسن فهم السنة فهماﹰ يجنّبها الآفات الثلاث التي حذّر منها الرسول-عليه الصلاة والسلام-، في حديث “يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين” …
ليس من سرف القول إن الفكر الإسلامي المعاصر يشهد دورة معرفية نشطة تسعى نحو توجيه ذلك الفكر في اتجاه مشكلات الحضارة وعمليات النهوض الحضاري للأمة الإسلامية. وتهدف هذه الدورة المعرفية إلى تطهير الفكر الإسلامي من كل رواسب التخلف والانحطاط رقيا إلى التجديد والاجتهاد ليعود ذلك الفكر أصيلا مستجيبا لتحديات العصر متجاوبا قضاياه في إطار المرجعية العليا للوحي الإلهي.
وتتجلى هذه الصحوة في الثورة المفهومية في مجالات حياتنا الفكرية، ولا غرابة في ذلك إذا ما نظرنا إلى التجديد الإسلامي بوصفه ظاهرة تاريخية دورية كلما اعترى المسلمين ذبول في دوافع الإيمان وخمول في الفكر وجمود في الحركة واستفزهم التحدي الخارجي.
وقد تجاوز توسع هذه الظاهرة وامتدادها دائرة النشاط الإسلامي المنظم حتى غدت تيار فكريا ممتدا وظاهرة اجتماعية واسعة وشعورا قويا بضرورة التحرر من سلطان قيم الفكر و أنماط الحياة الغربية وبالأوبة إلى أصول الانتماء الإسلامي، والسعي لتمكين قيم الدين في واقع الحياة مما جعلها تتحول إلى حركة تجديد شاملة لكيان الأمة الإسلامية ولقدرتها الجماعية على الفعل الحضاري.
من الجدليات الشائكة والساخنة والمتجددة التي شغلت الفكر السياسي الإسلامي الحديث مسألة الديمقراطية والحريات العامة في العقل الغربي والعقل الإسلامي. وتعد هذه الإشكالية، دون مبالغة، قضية القضايا في الفكر الإسلامي الحركي الحديث. وإذا كان الاسلام بوصفه نظاماﹰ شاملا ومتكاملا واجه في كثير من بلاد المسلمين ضغوطا شديدة الوطأة محورها أن الإسلام لا يملك القدرة على تنتظم الحياة السياسية والاجتماعية ولا ضمان فيه للحريات العامة والفردية وحقوق الأقليات، وبالتالي لا يملك تصورا محددا للدولة، فإن الديمقراطية الليبرالية الغربية قد قدمت بالمقابل، على أنها الضد النقيض للإسلام. ليس ذلك فحسب. بل كلمة الديمقراطية الغربية تفرض على أنها النظام الأمثل القابل للتطبيق في مواجهة شعارات الإسلاميين التي تتهم بأنها ستثير المشاعر والعواطف فحسب، ولا تصلح منهاجا لتنظيم الحياة في مختلف جوانبها! …
نقد السياسة: الدولة والدين من آخر الكتب التي صدرت للدكتور برهان غليون. ويعد هذا المؤلف بمثابة تتويج لكتاباته السابقة التي تناولت هذه الإشكالية مثل المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (1979) واغتيال العقل (1989) ومجتمع النخبة (1989) و الوعي الذاتي (1988) والتي تلاها المحنة الغربية: الدولة ضد الأمة ( 1990) إلى جانب الكتاب الذي بين أيدينا.
صدر نقد السياسة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عام 1991م. وقد تضمن هذا الكتاب خمسة أقسام كبرى مهد لها المؤلف بمقدمة تأطيرية، كما تضمن كل قسم من الأقسام الخمسة فصولاً فرعية.
الثورة الدينية
يمكن القول، من خلال ما يتم متابعته ورصده من كتابات الدكتور برهان غليون، إن هاجس الفكر الإسلامي وإحيائه بما يستجيب لحاجات نهضة العرب والمسلمين في وضعهم الحاضر قد مثل محور اهتمام خاص لديه انتظم كتبه: الوعي الذاتي، ومجتمع النخبة، واغتيال العقل، ليتم تناوله بصورة مركزة في الكتاب الأخير نقد السياسة: الدين والدولة. والإسلام بالنسبة إليه ما زال ذا أثر بعيد في تحديد ملامح الواقع العربي ومسارات مستقبله. كما أن الممارسة السياسية معنية بالشأن الديني الإسلامي، سواء كان ذلك داخل السلطة أو في المعارضة نظرا لما للإسلام من وظائف في تحديد أسس المشروعية وتوجيه القيم الثقافية والرمزية المهمة للفعل السياسي والاجتماعي.
ونحن نعلم أن الإشكالية السياسية قد طرحت، من الناحية التاريخية، بحدة على الفكر العربي الإسلامي في مطلع هذا القرن بعد تداعي آخر مقومات الشرعية الرمزية المجسدة بـ “فكروية الأمة الجامعة” التي كانت تقدم نفسها، بالرغم من “تفسُّخها”، على أنها غطاء مقبول لمشكل الشرعية التي تستند إليها السلطة، وعلى أنها نبع للقيم السياسية التي يمارس بها الحكم، وإطار للسيادة والقوة والولاء المعنوي لجماعة قد ترسخت في الوعي باعتبارها الإطار الجامع لأمة الإسلام والمسلمين؛ فما كان من الممكن لانهيار هذه السلطة إلا أن يحدث، ضرورة، فراغا حقيقياً في عالم العرب الفكري والسياسي وفي واقعهم العملي.
وقد مثل كتاب الشيخ الأزهري علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، الذي جاء في غمرة تلك الحيرة والتردد التي لفت الفكر العربي الإسلامي تزامنا مع اهتزاز مقومات الشرعية وبدايات التوسع الغربي، بمثابة إعلان عن تلك التمزقات التي …
——————–
مقلاتي صحراوي
درجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، في السنوات الأخيرة، على عقد ندوة سنوية باسم “مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل” حيث يتم التركيز في كل مرة على محور خاص يدعى المشاركون في الندوة إلى دراسته والبحث فيه من الجوانب كافة.
والكتاب الذي بين أيدينا يضم أعمال الندوة الثانية التي انعقدت في الفترة ما بين (16-18شعبان1413ﻫ/8-10شباط/فبراير1993م)، والتي خصصت موضوع “الفكر الحركي الإسلامي وسبل تجديده“.
وقد جاءت هذه الندوة في ظرف شهد فيه العالم الإسلامي أحداثا وتغيرات سياسية وثقافية واجتماعية هي نتيجة طبيعية للتداخل والتفاعل التاريخي بين عدد من المتغيرات الذاتية الداخلية وعدد من المتغيرات الخارجية ، خاصة في سياق العلاقة مع الغرب.
وقد دارت أعمال الندوة على أربعة محاور، وشارك فيها عدد من المفكرين والباحثين مثلوا مساحة مقدرة من جغرافيا العالم الإسلامي. كانت المحاور على النحو الآتي: …

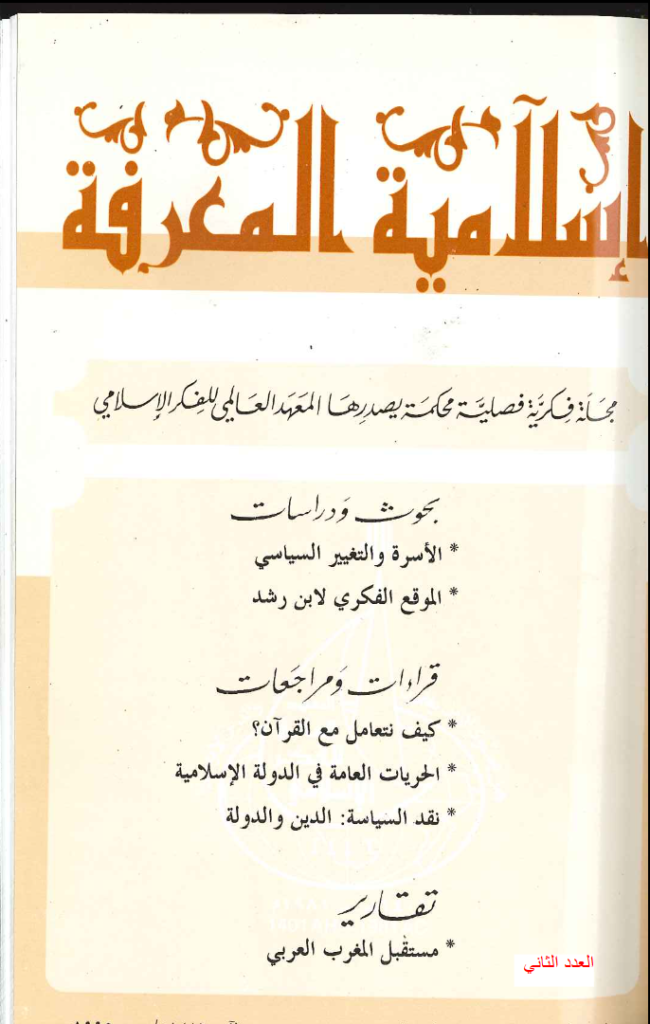
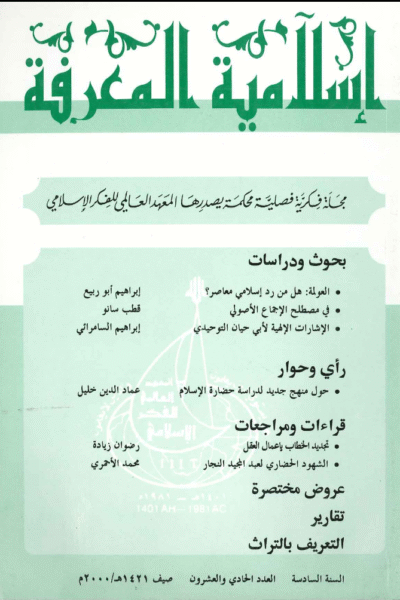
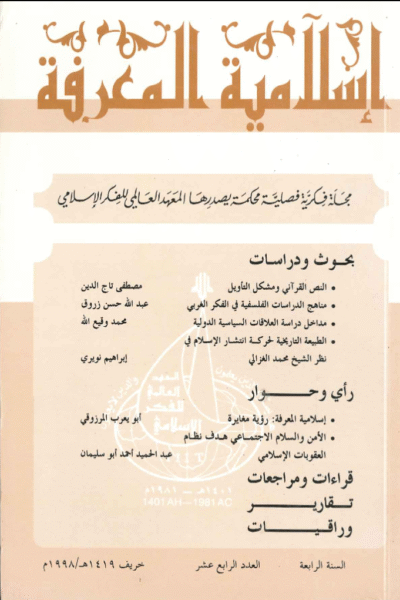
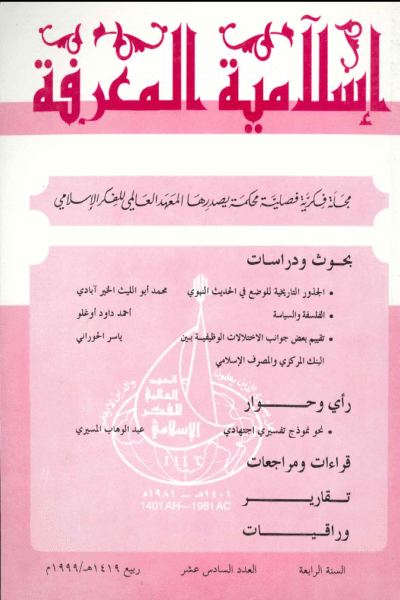
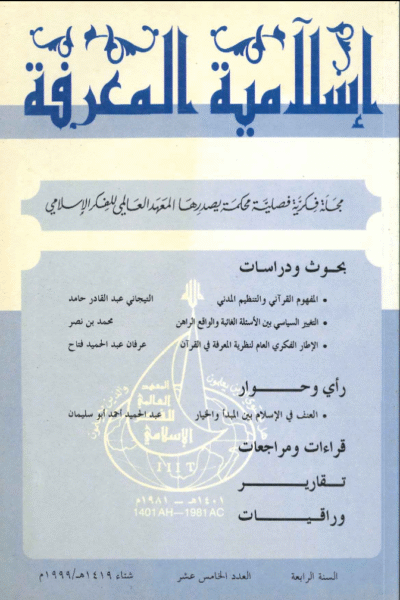
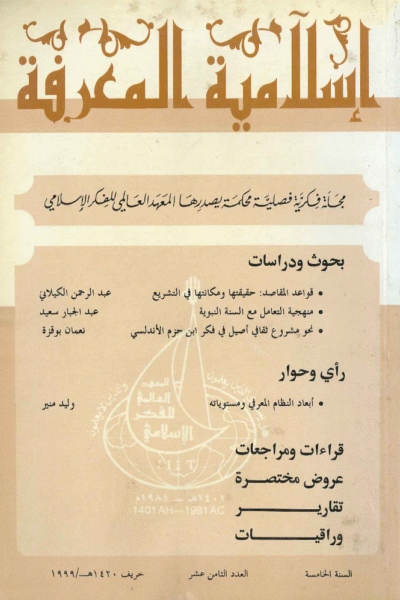
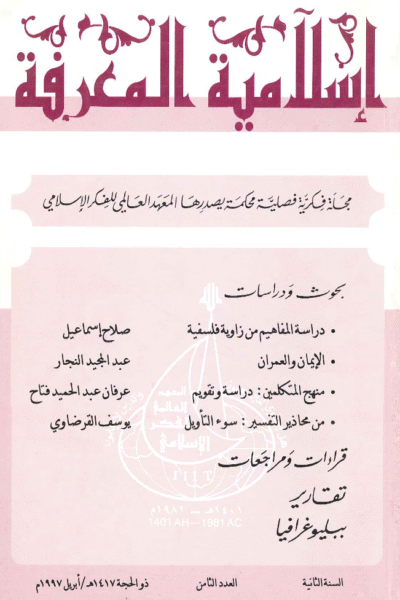
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.