الوصف
كلمة التحرير
===========
بهذا العدد “العشرين”، تختتم مجلة “إسلامية المعرفة” سنتها الخامسة من عمرها المديد، إن شاء الله. ولعلّ من المفيد في هذا المقام أن نذكّر قراءَنا الأعزاء بمضمون الرؤية العامة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي جعل من رسالة “إسلامية المعرفة” وشعارها علَمَاً على جهوده، وجعل من مجلته “إسلامية المعرفة ” لساناً لبيان مضمونها.
تنطلق الرؤية التأسيسية للمعهد، ومشروعه في إسلامية المعرفة، ومجلته “إسلامية المعرفة”، من الإسلام باعتباره “الدين” الذي رضيه الله للإنسان في ختام موكب النبوات، وباعتبار هذا الدين “نظام حياة” للفرد والجماعة والبشرية. وعلى هذا الأساس تم تحديد رسالة المعهد في الإسهام في مهمة إصلاح الفكر الإسلامي ومناهجه، لتمكين الأمة من استعادة هويتها الحضارية، وإبلاغ رسالتها الإنسانية، وتحقيق حضورها العالمي، ومن ثم الإسهام في مسيرة الحضارة البشرية وتوجيهها بهداية الوحي الإلهي.
وقد اعتبر المعهد هذه المهمة –الإصلاح الفكري والمنهجي– ميداناً واحداً من ميادين العمل على بناء المشروع الحضاري الإسلامي المعاصر، ووجه خطابه في هذا الميدان إلى العلماء والمفكرين والباحثين، ونخبة المثقفين في الأمة. لكن المعهد، مع تأكيده على مهمة النخبة المشروع الحضاري، فإنّه أكّد في الوقت نفسه على أن إنجاز المشروع هو إنجاز الأمة بفئاتها كافة؛ لذلك فإن التواصل والتفاعل مع هموم الأمة وقضاياها كان حاضراً في منطلقات التخطيط للإصلاح الفكري والمنهجي، الذي يتولاه المعهد. وقد اهتمت أدبيات المعهد في المرحلة السابقة، بمحاولة بناء الرؤية الإسلامية الشمولية والمنظور الكلي، الذي يعد منطلقاً للمشروع الحضاري الإسلامي الشامل، أو لأي ميدان من ميادين هذا المشروع. فهذه الرؤية الكلية ضرورية لتوسيع إطار التفكير المشترك بين فئات الأمة وأفرادها، وتعميق الوعي على أوجه التكامل والتناصر بين العاملين في ميادين الإصلاح المختلفة، وهي ضرورية لتحديد عناصر خصوصية الأمة وتميزها أو عناصر اشتراكها مع الأمة الأخرى في القيم والأهداف الإنسانية العامة، وضرورية كذلك لتوضيح الفرص والتحديات التي تجدها الأمة أمامها، في علاقاتها بواقعها وواقع العالم والأمم من حولها …
بحوث ودراسات
==============
يدعو الباحث بعد المقدمة إلى العمل المشترك بين العالمين الإسلامي والمسيحي. محللاً العالم الإسلامي في عصر ما بعد الاستعمار، ومشيراً إلى النظرة المسيحية الجديدة إلى الإسلام على الصعيد العالمي، ومبيناً المشتركات العقدية بين الإسلام والمسيحية بوصفه أساساً للعمل المشترك، والقانون الطبيعي بوصفه ركيزة للتفاهم. معطياً نموذجاً للعمل المشترك في مجال القيم الاجتماعية، ومختتماً بعرض مشاكل وآفاق المئوية الرابعة عشرة. ذاكراً أن الحضارة تواجه تحدياً لقيم المؤمنين بالحياة الروحية عموماً، إذ إنّ الأبعاد العقدية للروح واقعة تحت الحصار. وداعياً المسلمين إلى ربط النسق القيمي الإسلامي بقيم العالم غير الإسلامي المشابهة من أجل جهد مشترك للتأثير على المجتمع البشري.
يتحدث الباحث عن استناد معاوية إلى القوة والدهاء في الحكم. ويبين العلاقات بين القيادتين السياسية، والعلمية في عهده، وكيف تفاقمت هذه العلاقات عند مبادرته لمبايعة ابنه يزيد بولاية العهد، مؤكداً أن معاوية كان كفؤاً لمنصب الخلافة إلا أنه كان مضطراً للاستناد إلى القوة والدهاء في الحكم، وأن الفصام بين القيادتين أدى إلى جهل القيادة السياسية لحاجتها في وجود قاعدة فكرية تخدمها، وتواكب معها المتغيرات، وتمدها بالفكر، والسياسات، والبدائل بحيث إن القيادة السياسية تحولت نتيجة لذلك إلى سلطة مستبدة تأخذ الناس بالقهر والخسف، وليس للشورى فيها نصيب.
رأي وحوار
===================
نبدأ هذه الدراسة بتعريف مصطلح (المعرفي) في مقابل السياسي والاقتصادي والتاريخي…الخ، فالمعرفي من أكثر المصطلحات خلافية. وفي الخطاب الفلسفي العربي، يكون مصطلح (معرفي) عادةً ترجمة لكلمة(Epistemology) المشتقة من الكلمتين اليونانيتين (Episteme) بمعنى (معرفة) و(Logus) بمعنى(علم) بمعنى (دراسة) أو (نظرة). والإبستمولوجيا هي علم دراسة مانزعم أنه معرفة، إما عن العالم الخارجي (المادي) أو عن العالم الداخلي (الإنساني)، وهو علم يدرس (بشكل نقدي) المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية؛ بهدف بيان أصلها وحدودها، ومدى شموليتها، وقيمتها الموضوعية، ومناهجها، وصحتها والإبسمولوجيا في اللغة الإنجليزية: هي بشكل عام نظرية المعرفة (التي تتناول العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف)، أما في اللغة الفرنسية، فهي تعني أساساً نظرية العلوم أو فلسفة العلوم وتاريخها. وقد سبب اختلاف المعنى بين المعجمين الإنجليزي والفرنسي اختلاطاً كبيراً في اللغة العربية، إذ يتخذ كل مؤلف على حدة من معجم غربي معين دون غيره مرجعيته، فتظهر الكلمة في اللغة العربية بمدلولين مختلفين وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف يتجاوز إلى حد ما الاختلاط الدلالي.
وفي تصورنا، فإن الكلمة” المعرفي” بمعناها العريض تعني (الكلي والنهائي)، و(الكلي) مقابل (الجزئي) هو ما ينسب إلى الكل،و(الكل) في اللغة اسم لمجموع أجزاء الشيء، وكلمة (كلي) تفيد الشمول والعموم، وهي لا تعني الكليت بالمعنى الفلسفي ؛ أي الحقائق التي لا تقع تحت حكم الحواس، بل تدرك بالعقل والمنطق وحسب. وعلى هذا، فإن كلمة (كلي) تشمل كل الشيء في جوانبه كافة؛ ما يقع منها تحت حكم الحواس وما لا يقع، أما كلمة (نهائي) فهي كلمة منسوبة إلى (نهائي)، ونهاية الشيء غايته وآخر هو أقصى ما يمكن أن يبلغه الشيء،فالنهائي يحوي في طياته الغائي.
وعادة ما نضع المستوى المعرفي في مقابل المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري. وهذا المعنى، رغم جدته، متضمن في كثير من تعريفات كلمة (إبستمولوجيا) والإبستمولوجيا، بالمعنى الضيق للكلمة، تتناول موضوعات مثل طبيعة المعرفة ومصادرها، وإمكانية تحققها، ومصداقيتها، وكيفية التعبير عنها، ولكنها تعني أيضاً المسلمات الكامنة وراء المعرفة. وهذا المجال الأخير ينقلنا من المعنى الضيق إلى المعنى الواسع. فالإبستمولوجيا تعني أيضاً توضيح المقولات القبلية في الفكر الإنساني، ولذا يذهب بعضهم إلى أن الميتافيزيقا تنقسم إلى: أنطولوجيا وإبستمولوجيا، وأن كل رؤية للعالم Worldview تحوي داخلها ميتافيزيقا (أي أنطولوجيا وإبستمولوجيا) كما يرى بعضهم أن الإبستمولوجيا تعني (رؤية العالم) …
قراءات ومراجعات
===================
على غير عادة الباحثين في عرضهم لمنهجيتهم في مقدمة كتبهم، حيث يشرحون فيها طريقة تناولهم لمادة البحث، قام مؤلف هذا البحث بعرض منهج دراسته في نهاية البحث ربما ليجعلنا نكتشف تقنية التطبيق قبل التأصيل النظري وربما ليقنعنا –كما ذكر- بأن صياغة موضوعه إنما كانت محصلة اجتهاد مفاهيمي، واشتغال معمق بالمصادر والمراجع، وليس قضية أولية وضعت بصورةٍ قبلية مسبقة حتى يعقبها العمل التحليلي البحثي.
مهما يكن فإن الباحث يعد عمله هذا دراسة تاريخية تحليلية نقدية، تشكل مساهمة في البحث في عمليات التطور السياسي والاجتماعي في العقود الأولى الحاسمة من التاريخ الإسلامي، إن الكاتب يقسم الدراسات التي تناولت هذه الفترة إلى مناهج ثلاثة:
– الأول ينطلق من أن تكوين الدولة الإسلامية الأولى قد جرى من خلال نشوء الدين الجديد وتنظيم حياة الأمة في المدينة، ومن ثم فهنـاك تطابـق بين ظهور الدين الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية، وتمت ثنائية وازدواجية بين النظام القبلي ونظام الدولة الحديثة طوال التاريخ المبكر للإسلام، ومن هؤلاء المستشرق المعروف فيلهاوزن وعبد العزيز الدوري ومونتغمري واط وغيرهم.
– أما الثاني فتختلف منطلقاته النظرية اختلافاً جدياً عن الاتجاه الأول، إذ ينطلق هذا الاتجاه من أن الطابع الثوري العاصف للرسالة المحمدية أحدث ثورة جذرية في كلية الحياة الاجتماعية للعرب أنهت بها النظام القبلي كنظام سائد ودشنت بدلاً عنه دولة تزعمها الرسول بنفسه، وخير من يمثل ذلك الباحث الأمريكي دونر الذي درس “الفتوحات الإسلامية الأولى” والمستشرق كرون والمستشرق هندز، وتدخل الرؤية الماركسية في إطار هذا الاتجاه ممثلة بأحمد صادق سعد في دراسته “في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج –تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي” وطيب تيزيني في “مشروعه” وحسين مروة في “نزعاته المادية” …
أصل الكتاب أطروحة لنيل دكتوراه الدولة عام 1991م. والكتاب يقع في (700 صفحة)، قدم له العلامة الدكتور أمجد الطرابلسي حيث تناول بعض الإشكالات النقدية والمعرفية الملتصقة بالبحث وقضاياه؛ فأوضح أن كتابي “الشعر” و”الخطابة” لأرسطو لم ينقلا للعربية على أنهما من كتب النقد والبلاغة، بل بوصفهما من مجموعة كتب أرسطو المنطقية المسماة بـ”الأورغانون“؛ أي الآلة. وتكلم عن ظروف ترجمة كتب أرسطو من قبل السريان، في وقت احتاج فيه المسلمون في جدلهم وتناظرهم بينهم وبين العقائد الأخرى إلى حدود الكتاب وحججه. كما دفع ادعاء بعض النقاد أن كتاب “الشعر” لأرسطو يقدم نظرية كاملة للأدب والشعر، في وقت هو يتحدث عن نظرية المأساة كما عرفها الشعر والمسرح اليونانيان. ومن ثَمَّ لم يكن بإمكان الأوساط العربية الشارة التي نقل إليها الكتاب أن تفهمه، لأن يحدثها عن موضوع لم تكن تعرفه. والشيء نفسه يمكن قوله عن كتاب “الخطابة” وإن كان موضوعة أقرب إلى المدركات العربية.
أما السريان فإنهم كانوا ينقلون كتباً لا يفهمون موضوعها إلى لغة لا يتقنونها (ص 16)، كما أشاد بأطروحة الباحث وأعلن اتفاقه مع معظم النتائج التي انكشف عنها البحث،؛ بل استفاد منه وصحح من خلاله مجموعة الأفكار التي تقلقه. وخالفه في عنفه وجدله! وبارك له شعوره الإسلامي العربي الفياض.
وفي مقدمة الكتاب أظهر المؤلف انه برغم الاتفاق بين الناس حول ظاهرة التفاعل بن الحضارات إلا أن القوم اختلفوا في أصول المعارف وطرق تشابكها وتفاعلها بين الأمم والشعوب (ص 21). كما أن ظاهرة التأثير تسربت إلى العالم العربي تحت مظلة المستشرقين، ومتوازية مع المد الإمبريالي في العصور الحديثة، لتهيئ الإنسان العربي المسلم للذوبان في الحارة الأوربية المعاصرة (ص22). وتبني الفكرة نفسها ثلة من المفكرين العرب لتبرير التبعية للفكر الغربي في العصر الحديث؛ بل أعطوا “المشيخة” لأرسطو على الثقافة العربية.
أما موضوع الكتاب فهو تتبع دقيق وشمولي لرحلة الثقافة الأرسطية في بعديها النقدي والبلاغي، ومراجعة لكيفية تفاعل الفكر العربي الإسلامي مع الفكر الأرسطي (ص 22). وقد حفز المؤلف للبحث في هذا الموضوع ذلك السؤال: هل كان أرسطو بحق معلم العرب في البيان؟ كما ادعى تلامذة المستشرقين!! وكيف يكون هذا بالنسبة إلى أمة امتازت هويتها بالبيان وتحققت …

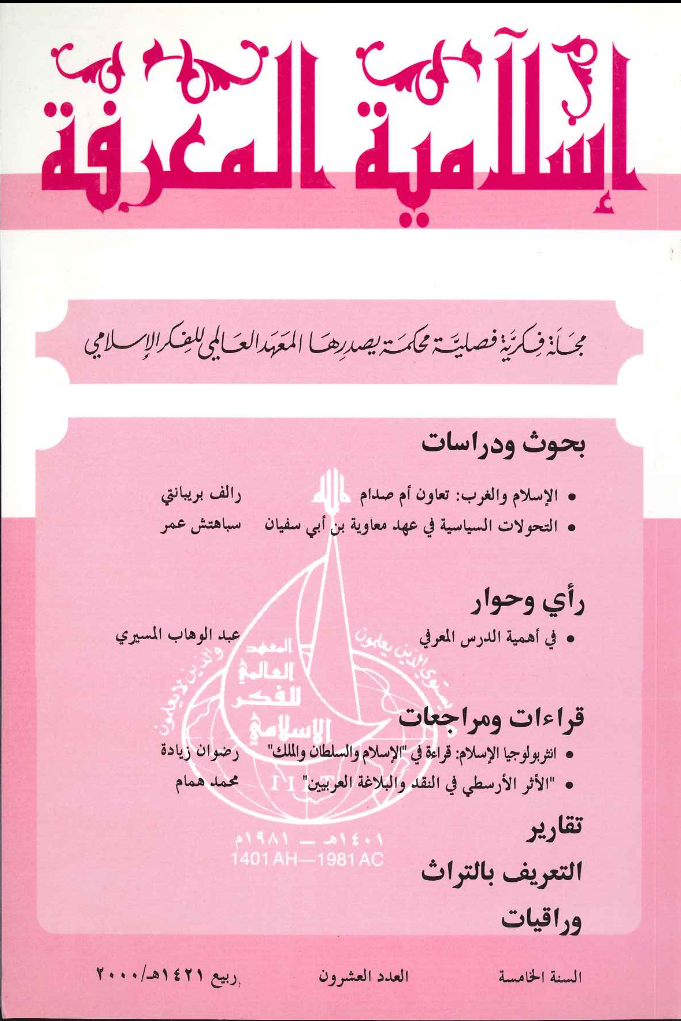
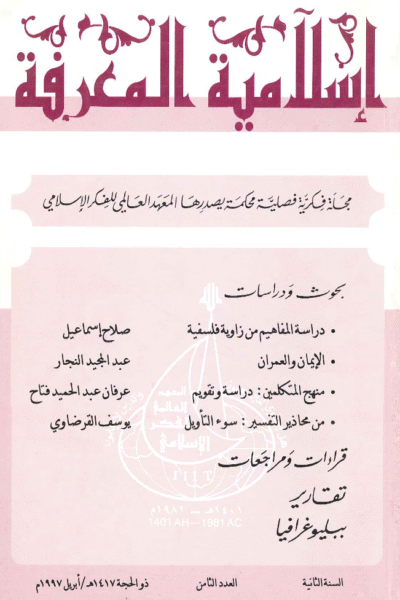
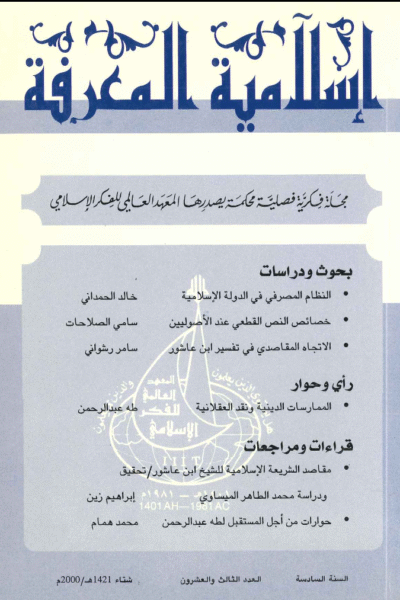
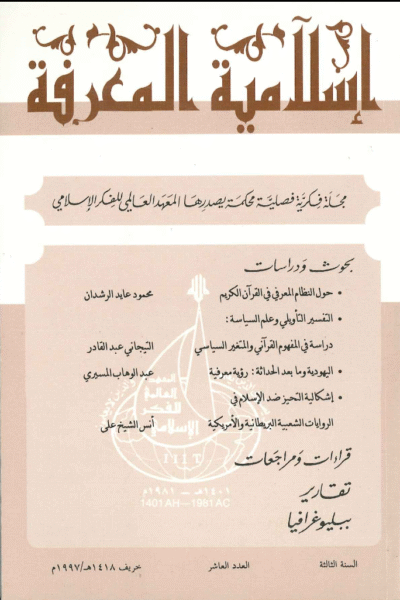
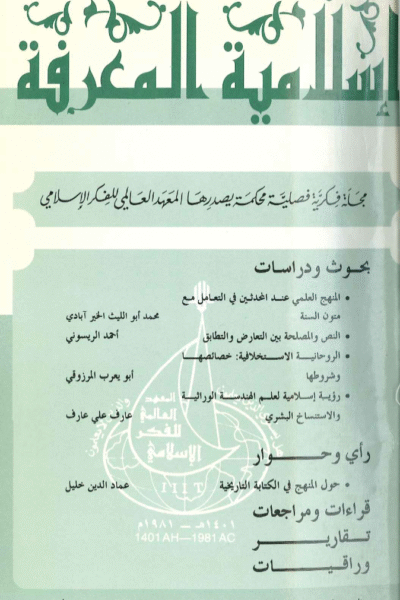
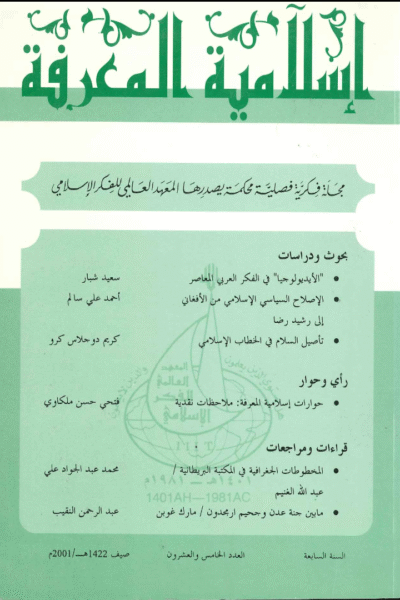
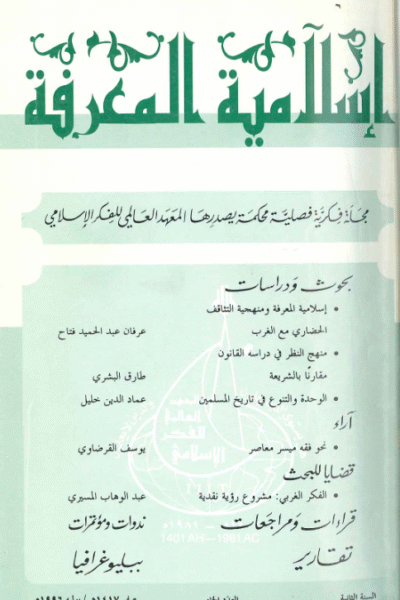
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.