الوصف
كلمة التحرير
===========
سبق أن برّرنا استعمال مصطلح الإسلامية في مشروع “إسلامية المعرفة” في محاولة لتأكيد الهدف التحريضي من جهود الأسلمة والإسلامية في العمل العلمي والمعرفي المعاصر، والهدف النقدي والتقويمي للمعرفة المعاصرة وإحالاتها الفلسفية وأسسها النظرية، والهدف العملي في توظيف المعرفة للأغراض المشروعة في الواقع الإسلامي.
لكن استعمال مصطلح “إسلامية المعرفة” يواجه قضية الهوية، والتساؤل حول إمكانية انتماء المعرفة إلى دائرة حضارية معيّنة أو انتسابها إلى دين أو قومية أو أي صفة أخرى تسحب عليه هويتها، ويصحّ عندها القول بـ”إسلامية المعرفة”؛ أو أن المعرفة، والعلم بمعناه الأعمّ، هي نتاج المنهج العلمي الذي تواصلت جهود البشرية عبر أجيالها المتعاقبة لاكتشافه، فإذا به منهج واحد يتفق عليه العلماء من مختلف المجالات المعرفية الطبيعية والإنسانية والاجتماعية على اختلاف معتقداتهم ومنطلقاتهم الفلسفية وبيئاتهم الاجتماعية والتزاماتهم القيمية، وبالتالي تكون المعرفة موضوعية وليست ذاتية، أي أنها مستقلة عن المعتقد والبيئة والقيم الخاصة بالعالِم أو الباحث، وهي موضوعية أيضاً بوصفها نتاج اتفاق كل العلماء على إنتاجها بالصورة نفسها، ويكون استعمال مصطلح “إسلامية المعرفة” على هذا الأساس مستهجناً ومستنكراً.
إن الموضوعية والذاتية طريقتان متعارضتان لمسألة تفاعل الفرد مع العالم الخارجي، وكلاهما ينطلقان من افتراض أن الموضوع الذي تُكتسَب الخبرة فيه، والذات التي تَكتسِب هذه الخبرة أمران منفصلان، وأن أحدهما أكثر أهمية من الآخر في المعادلة. فالموضوعية تعني أن الخصائص الطبيعية للعالَم تحدد خبرة المشاهد، ويمكن أن تدرك بشكل تام، أما الذاتية فتعني أن النظرة أو الفكرة التي يحملها الإنسان تنقل إلى الخبرة شيئاً أكثر مما هو كامن في العالَم، وبالتالي تكوِّن حُكمه ومعرفته. ومن الناحية الفلسفية فإن التعارض بين الموضوعية والذاتية هي مسألة معرفية؛ أي مسألة كون ملامح …
بحوث ودراسات
==============
يبدأ الباحث بمقدمة حول عنوان المقال، ثم يتناول مفهوم الحداثة ونشأتها فيتعرض للفلسفة الوضعية ومناهج البحث التي ولدت في فضائها الفكري، ثم فلسفة الأنوار الأوروبية، فالنزعات الإنسانية المتطرفة، فالفلسفة المادية/الجدلية الملحدة، فنظرية دارون في التطور العضوي وتداعياتها في حقل الدراسات الإنسانية عامة، ثم ينتقل إلى العلمنة الشاملة، فمناهج النقد التاريخي/الأدبي الحديث للنصوص الكتابية الثابتة بالوحي. وفي الجزء الثاني من بحثه يتناول الاستجابات العامة للفكر الديني لتحديات عصر الحداثة أو عصر ما بعد الدين، فيتعرض لمذاهب المسيحية المتحررة والإصلاح اليهودي ودعاة التنوير في الإسلام، ثم اليهودية المحافظة، مختتماً بالمذهب الأرثذوكسي والأرثذوكسية الجديدة.
قسم الباحث بحثه إلى خمسة أجزاء، بعد المقدمة، تناول في الأول منها الأصول النظرية للظاهرة الاجتماعية في القرآن الكريم، وتعرض بعد المدخل المنهجي إلى خطة الخلق العامة. ثم تناول في الجزء الثاني أصول الظاهرة الاجتماعية، وأصول المقاصد الشرعية. ثم انتقل في الجزء الثالث إلى مفهوم التنمية الاجتماعية، وقضاياها في المنظور الدنيوي، وفي إطار المقاصد الشرعية. وناقش في الجزء الرابع المفهوم المقاصدي للتنمية. وأثار في الجزء الخامس قضايا التنمية الاجتماعية المقاصدية، وذلك من خلال المستوى المفاهيمي، ومستوى العلاقات الداخلية للمتغيرات، ومستوى العلاقات البينية، وموضحاً أفكاره خلال البحث برسوم بيانية شارحة.
الملخص
افتتح الباحث مقاله بمقدمة عن الإشكال العام للموضوع، ثم انتقل إلى بحث عناصر الموضوع السبعة التي تمثلت في:
1- المؤهلات التي ساعدت رشيد رضا على خوض غمار الإصلاح السياسي 2- مجلة المنار التي أطل بها على الواقع ودورها في إيصال كلمة الإصلاح إلى العقول والقلوب 3- موقع رشيد رضا من الظاهرة الإصلاحية العامة 4- السياسة الشرعية التي خاض غمار الإصلاح السياسي من منظورها 5- شمولية الإصلاح عنده وعموميته 6- السياسة التي تكلم فيها هي السياسة العامة، وحكمته في تناولها 7- الموضوعات السياسية التي تكلم فيها مثل الخلافة، والشورى، والثورة، والاشتراكية وغيرها.
رأي وحوار
===================
القضية
كثيراً ما يخطئ العلاج أو يقصِّر لخطأ في التشخيص أو لقصور في التحليل. وهذا لا يصدق على شيء كصدقه على حال قصور تشخيص تخلف الأمة الإسلامية الذي سرى في أوصالها لقرون عديدة، والذي بدا وكأنه قد استعصى على العلاج منذ أن أطلق أبو حامد الغزالي (ت 505ﻫ/1111م) صرخته في “تهافت الفلاسفة” ونداءه في “إحياء علوم الدين”. وكان من أهم أسباب فشل التشخيص وفشل العلاج أنه انصرف إلى الأعراض وهدف إلى الظواهر، فضلاً عما أصاب رؤيته الحضارية من تشوه إذ قصَّـر به منهجه الجزئي عن الغوص إلى جواهر الأسباب.
كانت شكوى الأمة وما تزال من التخلف ومن التمزق ومن الطغيان والتسلط، وهي أيضاً شكوى من الظلم والفقر والجهل والمرض، وكانت الأمة وماتزال تتطلع إلى القوة والوحدة والعدل. وكانت هذه الآمال وماتزال وهماً وسراباً، ولم يتحقق أي شيء من آمال التنمية السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وظل أمر اللحاق بالركب وتوفير المستويات الإنسانية اللائقة في المعاش والتعليم والصحة مطلباً لشعوب الأمة لا يتحقق.
وإذا كنا نتفق مع كل المصلحين في أن كل وجوه هذا الإصلاح مطلوبة، وأنه لا يمكن تحقيق نهضة الأمة وحمل رسالتها دون تحقيق هذه الإصلاحات، ولاسيما مطلب إصلاح التعليم، إلا أننا نرى أن كل هذه الإصلاحات إنما هي أعراض لأسباب أكثر عمقاً وأبعد غوراً فإن لم نتحلى بالنظرة الناقدة الشجاعة، ونزوّد أنفسنا بالوسائل المعرفية الصحيحة اللازمة لمعرفة هذه الأسباب، فإننا سوف نستمر في عجزنا عن معرفتها والتزود بالقدرة الحقيقية على مواجهتها والتغلب عليها وتحقيق الأهداف والمطالب والإصلاحات الحياتية الحضارية المشروعة لأمتنا …
——————–
ليست “العولميات” صناعتي ولا “المستقبليات” هوايتي، وإنما صناعتي وهوايتي الأخلاقيات، وهي حاضرة بقوة فيهما معا، وهذا الحضور هو وحده الذي يعنيني هاهنا، لا سيما وأن الأخلاق هي الشرط الذي لا يستقيم بدونه شيء، لا عولمة ولا مستقبل ولا غيرهما: وحسبي الإشارة إلى أن ما أريق من مداد وسيق من كلام عن “العولمة” في مختلف بقاع العالم، على قصر أمدها، لم يسبق له نظير، حتى كأن كلماتها لا تنفد وحركاتها لا تنتهي؛ ولولا أني خشيت أن أخل بواجبي في تدارك نقص شنيع شاب ما كتب عنها باللسان العربي، لما اشتغلت بهذا الموضوع لفرط نفوري مما يُملَى عليّ ويندفع فيه الناس، وشدة عزوفي عما لا يصدر عني وأتفرد به، كأني أتوجس من ورائه كيدَ عقول ماكرة وتآمر إرادات خفية؛ وليس هذا النقص الشنيع إلا تناسي التقويم الأخلاقي لهذه الظاهرة الهائلة، اللهم إلا ما كان من إشارات هنا وهناك تَرِد في سياق تحليل اجتماعي أو ثقافي لها أو في سياق مقارنة بينها وبين الإسلام؛ وأريد هنا أن أشتغل بجانب من هذا التقويم الأخلاقي، عسى أن ينفتح لي فضاء فكري إسلامي يتسع للإشكالات الأخلاقية للعولمة.
ما هي العولمة في روحها؟
في البدء، أحتاج إلى وضع تعريف للعولمة يُقرّب معناها على أساسه أباشر هذا التقويم الأخلاقي، لكني أريد أن أمهد له باطلاعكم على بعض المبادئ التي آخذ بها في عموم تفكراتي -أو تأملاتي- في موضوع الأخلاق، وأذكرها لكم مطبَّقةً على العولمة، وهي أربعة:
مبدأ عموم الأخلاق: مقتضاه أن كل الأفعال التي يقوم بها الإنسان، كائنة ما كانت، هي في حقيقتها، أفعال خُلُقية، ذلك أن الغرض من كل فعل يصدر عنه هو أن يحقق به إنسانيته، فيرفعها درجة أو يخفِضها درجة؛ وتحقيق الإنسانية، رفعا لها أو خفضا، هو بالذات ما يُسمّى في الاصطلاح “أخلاقية” أو “تخلّقاً”؛ وعلى هذا، فكل فعل يأتي به الإنسان يكون سببا في تخلقه، على هذا التخلق قد يزيد أو ينقص بحسب طبيعة هذا الفعل؛ ومن هذه الأفعال، على سبيل المثال، ما يقوم به أرباب العولمة، فهم، على ما يظنون، يسعون إلى تحقيق مزيد التقدم للإنسانية؛ والتقدم هو عبارة عن الانتقال من حال إلى حال أفضل منه، فيكون تخليقا.
مبدأ الهمة الإنسانية: مقتضاه أن الإنسان بعزيمته أقوى من الأمر الواقع وأصلب من حتمية الحدث، لأن الواقع القائم لا يستنفد أبداً الإمكان الذي في يد الإنسان ولا أن الحتمية المنسوبة إلى التاريخ تفوق طاقته؛ فمثلاً إذا قيل بأن العولمة أمر محتوم لا مفر لسكان العالم من احتماله، قلنا بأن الإنسان، متى استنهض همته، أضحى بمقدوره أن يدفع عنه هذا الأمر أو يغير مجراه بوجه من الوجوه، وإلا فلا أقل من أن يتعامل معه بوصفه خياراً حضاريا غير ملزم له في كليته.
مبدأ التحدي المناسب: مقتضاه أن الإنسان يلقى في كل زمان من التحديات ما يناسب قدره وطاقته، مع العلم بأن لكل زمان نموذجه البشري؛ فإذا اختلفت التحديات باختلاف الأزمنة، فإنها لا تختلف من حيث تناسبها مع أقدار النماذج البشرية المقارنة لهذه …
——————–
قراءات ومراجعات
===================
صدرت عن دار الشروق بالقاهرة حديثاً موسوعة “اليهود واليهودية والصهيونية” التي تعد أول إنجاز علمي في موضوعه وأضخمه وقد كان صاحبها الدكتور عبد الوهاب المسيري، يبشر بها منذ بضعة أعوام، وخاصة أثناء زيارته الأولى للمغرب في 1993، و1995 حيث سلمنا بطاقات تعريفية بها وبمحتوياتها، ومنذ ذلك الحين وكثير من المهتمين وطلاب العلم ينتظرون هذا الإنجاز الأول من نوعه بفارغ الصبر.. حتى إذا برز إلى الوجود بعد مخاض عسير فوجئنا من جهة بثمنه الفاحش الذي بالغت بعض المكتبات في رفعه لدرجة استاء منها الكاتب نفسه. ومن جهة بالصمت الذي حفها من قبل مراكز البحث والدراسة ومنتدياته وجمعياته.. على ربوع الوطن العربي والإسلامي، إذا ما استثنينا بعض الالتفاتات القليلة والمحتشمة، بما في ذلك هيئات ذات توجه قومي “معادٍ” للاستيطان اليهودي ومشروع الصهينة والتطبيع. أما تلك، ذات الولاء الكامل أو الناقص، فقد نزلت عليها الموسوعة منزل الصاعقة، فلا هي قادرة على نقدها النقد العلمي المحكم، ولا هي قادرة على التنويه أو التعريف بها. خاصة وأن الموسوعة، باعتبارها موسوعة تأسيسية، في نقدها للفلسفة العلمانية الامبريالية الشاملة الأم الحاضنة للصهيونية، قد نَحَتَتْ نماذجها التفسيرية نَحتاً، وبنت نماذجها التحليلية بناءً، وولّدت مصطلحاتها ومفاهيمها توليداً، عبر رحلة من العناء في السبر والتقسيم والاستقراء والتقصي طويلة.
ولكل ما تقدم أسباب ومبررات وظروف أحاطت بالموسوعة منذ بدايتها إلى نهايتها. ونظراً لكون متعة القراءة فيها لا تكتمل إلا بمعرفة ذلك كله، أو بالأحرى ملخص وموجز عنه، فضلت أن أبدأ تعريفي هذا بالموسوعة بإطلالة تاريخية للتعرف أكثر وعن قرب على د. المسيري وعمله هذا، خاصة وأنه قدر لي أن أزور الكاتب في بيته بالقاهرة مرتين، وأن يزودني بمادة من مائة صفحة متعلقة بظروف وملابسات كتابة الموسوعة. وهذه المادة هي محور من مؤلف ضخم يُعدّه الكاتب حول سيرته الذاتية، فضل أن يطلق عليه اسم “سيرة غير ذاتية غير موضوعية”. ولما سألته عن دلالة هذا العنوان، قال إنه -كعادته- يريد أن يقدم نموذجاً جديداً في كتابة السِّيَر “تترجم” للمعرفة وللعلم وتتحيز لهما أكثر مما تترجم للذات وتتحيز لها، وطالب العلم محتاج في تكوينه إلى النموذج الأول أكثر من الثاني. الدافع الآخر وراء كتابة هذا “المدخل” التاريخي، كون الكاتب لم يضمّن تقديمة للموسوعة شيئاً عنه، وفضل أن يكون ضمن محاور سيرته إلى جانب الهموم والمشكلات المعرفية الأخرى، وكي لا يكرر نفسه طبعاً …

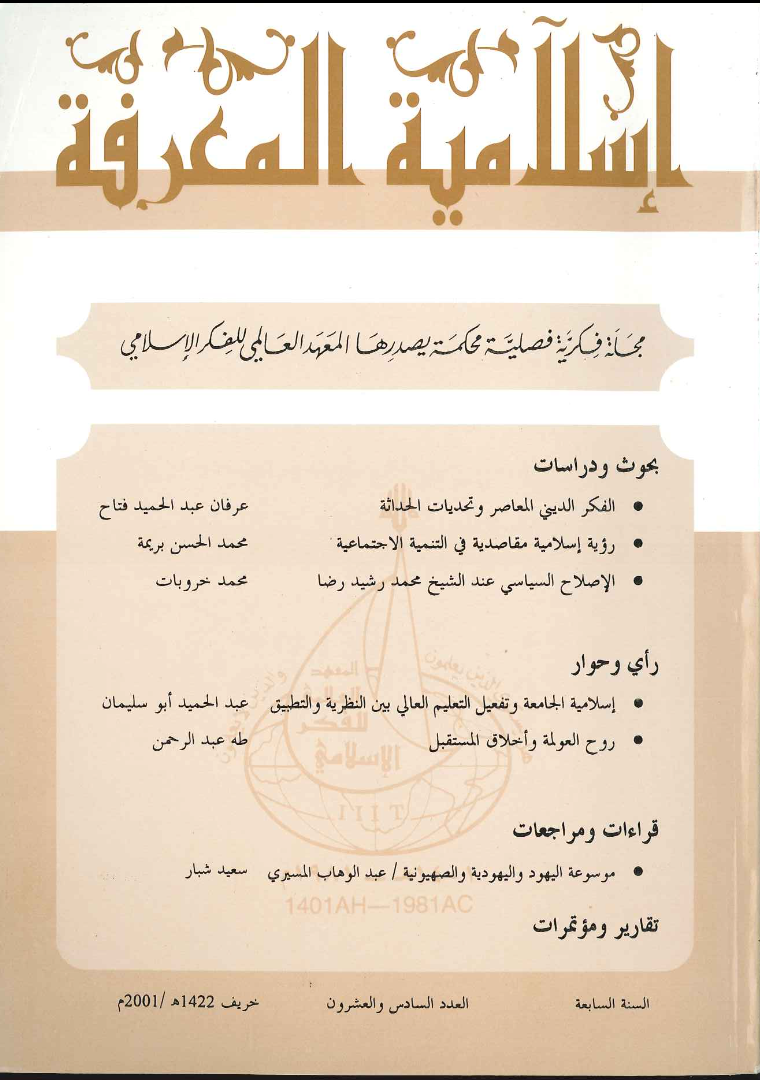
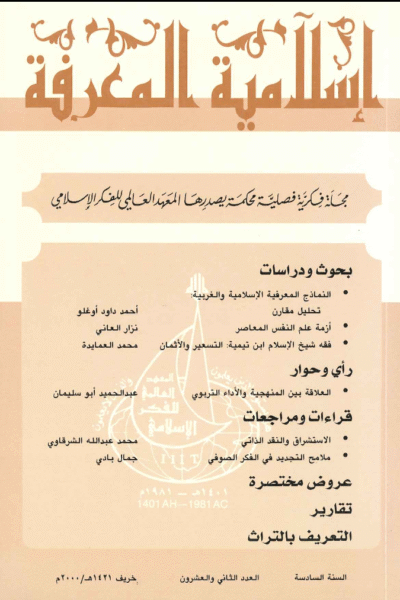
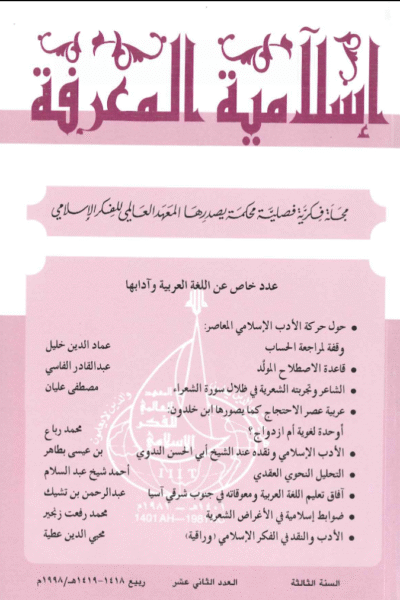
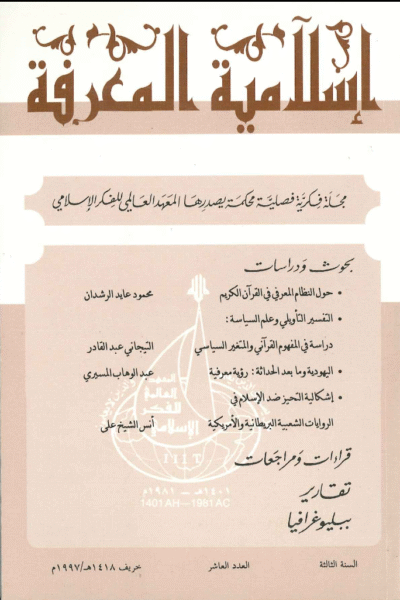
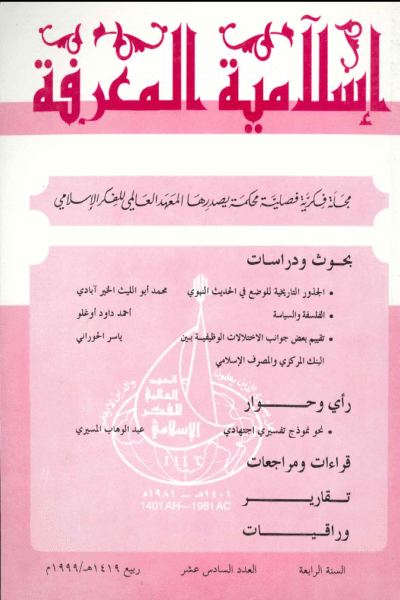
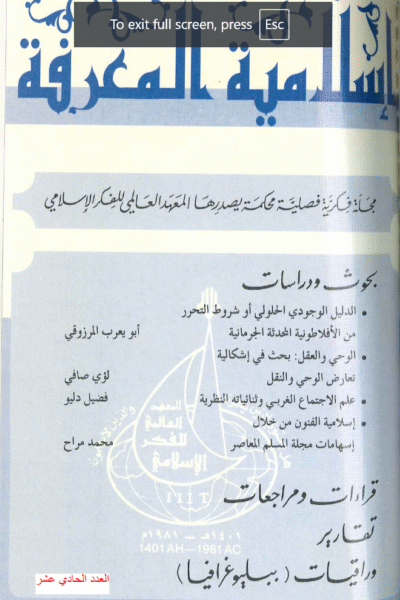
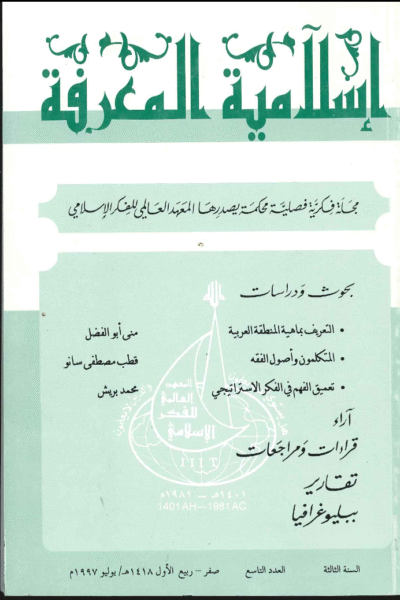
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.