الوصف
كلمة التحرير
============
الملخص
هكذا -وبحساب الأعداد الصادرة حتى الآن- تطفئ إسلامية المعرفة الشمعة الأولى في مسيرتها. وإذا كان أثر الأفكار وفاعليتها في حركة التاريخ وتطور المجتمعات لا لقياسها مجرد النظر إلى عدد المطبوعات التي تتناول تلك الأفكار وتدعو لها وتبشر، فإن إسلامية المعرفة -بوصفها مشروعا للإصلاح الفكري والمنهجي الشامل- ينبغي أن تمتحن فاعليتها وتختبر مشروعيتها بمدى وفائها بمقتضيات الأصالة الإسلامية والاستجابة بفعالية للتحديات التي تواجه مجتمعات المسلمين خاصة والإنسانية عامة، ذلك أن لنجاح الأفكار في إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي شروطا نفسية وتاريخية لابد من أخذها بالحسبان، وإلا تحول الأمر إلى مجرد تمرين ذهني لا طائل من ورائه.
ولعل في التجاوب الكبير الذي نبديه أعداد متزايدة من المثقفين والجامعيين إزاء ما تنشره المجلة من بحوث وما تثيره من قضايا وما تتوخى تحقيقه من أهداف، دليلا على أن إسلامية المعرفة تتوفر على جانب مهم من تلك الشروط النفسية والتاريخية.
وكما سبق أن أكدنا في كلمة العدد الثالث، فإن الأمر يحتاج إلى النقلة النوعية التي تتحول بمقتضاها إسلامية المعرفة إلى حركة إنتاج علمي في مختلف المجالات المعرفية، دراسة عملية للقضايا والمشكلات، وطرحا عمليا للحلول والنظريات، وبلورة منهجية للمفاهيم والمقولات؛ وهي نقلة تتطلب الانخراط العملي لأصحاب التخصصات العلمية المختلفة في إجراء البحوث والدراسات الميدانية باعتماد المنظور الإسلامي وتطوير الأطر التحليلية والطرائق الإجرائية التي تستصحب مقاصد الوحي وتتمثل ما جاء به من قيم وتعاليم.
في هذا العدد يقوم حسن احمد إبراهيم وإبراهيم محمد زين بقراءة تحليلية لما ورد في شأن المهدية والمهدي من الأحاديث والروايات عند كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبي داود في سننه. وقد حاول الباحثان النظر إلى تلك الأحاديث والمرويات في إطار تطور الصناعة في علم الحديث من ناحية، وباستحضار الوقائع التاريخية والأوضاع الاجتماعية من ناحية أخرى. ويهدف المقال إلى الوصول إلى فهم …
بحوث ودراسات
================
يقوم المؤلفان بقراءة تحليلية لأدبيات المهدي والمهدية من خلال الأحاديث والروايات لدى كلّ من: البخاري، ومسلم، وأبي داود. وقد حاولا النظر إليها في سياق تطور الصناعة في علم الحديث من ناحية، وباستحضار الوقائع التاريخية، والأوضاع الاجتماعية من ناحية أخرى. فيبدأ البحث بشرح كيف تناولت المصادر الإسلامية المهدية، ويعرض الاتجاهات الأربعة للمحدثين حول أحاديث المهدي والمهدية بحسب صحتها وضعفها. ويتناول أحاديث المهدية ومغزى التأسي برسول الله عند البخاري، ومسلم، ثم تطور مفهوم المهدية في سنن أبي داود. ويختتم البحث بشرح طرق، ومسالك الرواة والمحدثين في التعامل مع الأحاديث الواردة حول المهدي والمهدية.
يعد البحث محاولة لتحديد مفهوم الاستقراء عند الشاطبي، وأوجه استخدامه له في كتابه “الموافقات” منهجاً لإرساء علم مقاصد الشريعة. فيبدأ بشرح معنى المنهج الاستقرائي، وكيف وظفه الشاطبي في “الموافقات”. ثم يعرض لمفهوم الاستقراء قبل الشاطبي، ثم معالم المنهج الاستقرائي، وكيفية استخدامهما بوصفه دليلاً عقلياً يفيد القطع في علم المقاصد. شارحاً الفرق بين الاستقراء التام والناقص، ومفهومهما، واستخدامهما عند الشاطبي، والمجالات التي استخدم فيها الشاطبي المنهج الاستقرائي، وأهم مشكلات الاستقراء، وكيف تعامل الشاطبي معها. مختتماً بحثه بمحاولة توحيد المناهج الاستدلالية عند الشاطبي مبيناً أثر ذلك على المقاصد الشرعية.
الملخص
يقدم البحث عرضاً ومحاورة داخلية لتطور فكر الحداثة، مبيناً أن المرجعية التي انطلق منها لا تزال هي نفسها لم تتغير. لذا يدعونا الباحث إلى مسألة فكر الحداثة من خارجه، وتجاوز إطاره النظري والوضعي المادي، فيبدأ البحث بتعريف “المجتمع الحديث” و”المجتمع الصناعي”، ثم يتعرض للمراحل التاريخية التي أدت إلى نشأة المجتمع الحداثي والمجتمع الصناعي. ويشرح مفهومي “الإصلاح والنهضة”. ثم يعرج على عصر الأنوار والتنوير، ويتناول ملامح المشروع الثقافي الغربي من خلال (عقلنة الطبيعة، وعقلنة التاريخ، وعقلنة الدين، وعقلنة السياسة). ثم يعـرض للثورة الصناعية الفرنسية، وميلاد المجتمع الصناعي الحديث، ويختتم بحثه بنقد ذاتي للحداثة وما بعد الحداثة من داخل مرجعيتها.
يركز البحث على جوهر الأزمة في المشروع الحضاري الغربي، وغياب المعنى والهدف، وفقدان الوجهة في النموذج الغربي. ويتساءل عن مدى أصالة المشروع الإسلامي البديل معبراً عن خشيته من تحوله إلى مجرد تقليد للمشروع الغربي؛ على الرغم من المقدمات النقدية التي يلحظها المرء في تعامل المثقفين المسلمين مع الغرب. يستهل البحث بشرح للتحولات المنظورية والنموذجية في الفكر الغربي، ثم التحولات المعرفية. مستعرضاً نقداً لمفهوم الحداثة وما بعد الحداثة، وكيف أثر عالم ما بعد الحداثة في الفكر السياسي، والنظرية السياسية. مختتماً بعرض حالة الاغتراب التي يعيشها الإنسان المسلم، وكيف يمكنه اللحاق بالركب الحضاري.
قراءات ومراجعات
===================
يعد كتاب فقه التديُّن فهماً وتنـزيلاً من الدراسات النادرة -شمولاً في النظر وعمقاً في الطرح- التي تقدم دليل عمل متكاملاً لحركات الصحوة الإسلامية في سعيها لتغيير واقع مجتمعات المسلمين بما يجعله جاريا على مراد الشرع.
فهو درس منهجي في فقه التديُّن على مستوى الفهم النظري للقيم والمقاصد والأحكام التي جاء بها الوحي الإلهي، وعلى مستوى تمثلها وتحقيقها عملاً في واقع الحياة.
وإذا كانت الصحوة الإسلامية في العصر الحديث قد اصطدمت بمعوقات حالت دون تحقيق مقاصدها في بسط سلطان الشرع على مجريات الحياة الإنسانية في بلاد الإسلام، فإن طرفا من العوامل التي أدت إلى عدم التغلب على تلك العقبات يعود في نظر المؤلف إلى مناهج حركات الصحوة في السعي لتحقيق أهدافها. ففي إطار العمل على إحياء نوازع الإيمان لدى المسلمين وتزكية ثقتهم بالإسلام منهجاً شاملاً للحياة، غلب على مفكري الصحوة ومنظريها منهجٌ ينحو إلى التعميم والتجريد. وإذ قد استعاد المسلمون الثقة بدينهم وتوفر لهم قدر غير يسير من الوعي به منهجا شاملا للحياة، فالأمر يستدعي –في نظر الأستاذ النجار- تجاوز ذلك المنهج، الدعوي والجدلي التعميمي، إلى منهج يركز على كيفية تحويل حقائق الدين النظرية وقيمه ومقاصده العليا إلى واقع معيش وهو ما سماه بفقه التديُّن.
وبين يدي تناول هذا الفقه تناولاً منهجيّاً علميّاً، عمد المؤلف إلى ضبط مراده بمصطلحي الدين والتدين، وتحديد ما بين المصطلحين من تمايز. فالدين –في رأيه- هو التعاليم الإلهية التي خوطب بها الإنسان على وجه التكليف. وأما التدين فإنه الكسب الإنساني في الاستجابة لتلك التعاليم، وتكييف الحياة بحسبها في التصور والسلوك. والفرق بينهما هو أن الدين –بوصفه هديًا إلهيا- يتصف بالمثالية والكمال، ويتمثل في تعاليمه الحقُّ المطلق بناء على الكمال الإلهي في العلم الشامل بأحوال الوجود؛ وأما التدين -بوصفه كسبا إنسانيا في تكييف الحياة بتعاليم الدين- فيتصف بالمحدودية والنسبية نتيجة عوائق الواقع المادية والثقافية والاجتماعية التي تغالبه وتؤثر فيه أثناء تعامله مع تلك التعاليم، ونتيجة ما تَمّت به صياغةُ الدين –كما هو في نصوص الوحي- من الكلية المتجاوزة لمُشخَّصات الأفعال العينية والظرفية، الأمر الذي يمكن أن يفسر عجز الإنسان في تدينه عن بلوغ درجة الكمال في الالتزام …
قام الأستاذ إبراهيم العقيلي بمجهود ضخم يستحق كل الشكر والتقدير من خلال تأليفه لكتاب: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية، الذي يعد بحق من أحسن ما أُلِّفَ عن شيخ الإسلام فيما يخص منهجه المعرفي، ذلك أن مؤلف الكتاب عرض لفكر ابن تيمية بالشرح والتحليل وبيَّن الطريق الذي التزمه في أبحاثه ومناقشاته وآرائه ودروسه ومدارساته مع مختلف الفرق والملل السابقة لِزمانه والتي عاصرها وخاض في غمار الرد عليها.
وهذا الكتاب على العموم، يعرض بالبيان والتحليل المصادر المعرفية التي اعتمد عليها ابن تيمية، وكذا المعايير والموازين التي بنى عليها آراءه في نقد تراث سابقيه، وتمييز حسنهِ من قبيحه، وهذا المنهج بدوره يسهّل على القارئ الفهم الدقيق لتراث ابن تيمية، كما يسهل على الباحثين والقارئين حسن استيعابه مع تمثّل وهضم أفكاره وقضاياه.
ولنتعرض الآن بنوع من التحليل والنقد لما جاء في هذا الكتاب القيّم: …
هذا الكتاب لي معه قصة ربما ليس من المناسب ذكرها في هذه المراجعة، ولكن يبدو أن طرفاً منها سيعين القارئ على فهم بعض الملاحظات التي سأبديها بشأنه. كان ذلك في عام 1981، وكنا قد تخرجنا لتوّنا بقسم الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الخرطوم، وتم تعيننا في قسم أنشئ حديثا للدراسات الإسلامية بالجامعة بعد نـزاع شديد في مؤسسات اتخاذ القرار بين الإسلاميين والعلمانيين، ثم طلب مني التخصص في مقارنة الأديان، وطلب من الأستاذ التيجاني التخصص في الفكر السياسي الإسلامي. وبسبب قلة المكاتب -وعدم وجود مبان للقسم أصلا- منحنا قسم الفلسفة مكتبا واحدا، فصرنا نجلس فيه متقابلين.
وكان التيجاني حينما يفكر بصوت عال يتحول تفكيره إلى نقاش أجره فيه إلى موضوع رسالتي التي كانت عن “فلسفة العقاب في القرآن مع إشارة خاصة إلى أسفار موسى الخمسة”، ويفلح هو أحيانا فيجري إلى مواضع اهتمامه.
والأهم من كل ذلك أنني- وبسبب المصالحة الوطنية مع نظام الرئيس السابق جعفر نميري في 1977- كنت قد جمدت نشاطي السياسي في تنظيم الإخوان المسلمين، أو قل الحركة الإسلامية. وكانت حجتنا الأساسية- أنا ونفر آخرون معي- تتمثل في عدم مشروعية الدخول في نظام سياسي لا يقر بمبدأ الحاكمية. وربما كنا أكثر مثالية وأقل وعيا بخوض غمار السياسة ومجالدة السلطة، ولكننا كنا- على أي حال- نمتلك وضوحا نظريا وإرادة تكفي لتحقيق ما نسعى إليه.
وكان الأخ التيجاني يشاركنا ذلك الوضوح النظري، لكنه آثر أن يخوض غمار تجربة المصالحة الوطنية محققا ذلك المعنى الذي تكرر في كتابه ألا وهو:
الإمساك بالأرض والتطلع إلى المثال من خلال توحيد لا يفصل بين الأرض والسماء، ولكنه يحقق توترا فعالا هو جماع الكسب الديني التوحيدي. وعلى الرغم من أن هذه واحدة من أطروحات الدكتور حسن الترابي الأساسية في تفسير حركته وكسبه الديني، إلا أن الأخ التيجاني عبد القادر قد حاول أن يحولها إلى مشروع فلسفي ناضج يعبر عن قيم التوحيد في سياق المصالحة الوطنية التي نظر إليها- في أوساط الإسلاميين عموما في السودان وخارجه- على أنها انحراف عن المنهج الحركي السليم، وتسليم مشين للعلمانيين …
——————
بدران بن لحسن
يهدف هذا الكتاب- كما يوضح مؤلفه- إلى تحديد مفهوم الحاكمية الذي شاع في الفكر الإسلامي المعاصر، وآثار الكثير من الجدل، وذلك عن طريق تأصيله في اللغة والأصول المرجعية، ومقارنته بما هو مطروح في الساحة السياسية من مفاهيم، كالشرعية والسيادة والثيوقراطية، وغيرها.
ونحن إذا تأملنا الساحة الإسلامية وخاصة بعد الإفرازات السياسية لحركات الصحوة والتجديد، نجد أن تقدم هذه الحركات قد أثار إشكالات عديدة، لعل من أهمها تلك الإشكالات المرتبطة بمفهوم الحاكمية الذي يمثل أحد المفاهيم الأساسية في الفكر السياسي للصحوة، بل هو أحد المفاهيم المركزية المشكلة لعقل المسلم المعاصر، وهو يسعى لدخول “عالميته الثانية”.
ومثل هذه الإشكالات تحتاج إلى التناول المنهجي المعرفي وفق النسق المعرفي الإسلامي للخروج من هيمنة النسق المعرفي الغربي الذي فرض نموذجه وبسط سلطانه على المفاهيم والتصورات وأنماط الحياة ومناهج الفكر، واكتسح ساحات الوعي بأقدار هائلة.
فتأصيل المفاهيم خطوة لازمة لفك الارتباط بينها وبين الحالات الانحرافية التي صاغها النموذج الغربي، وإعطاء الاصطلاحات والمفاهيم مضمونا وفقا للنسق المعرفي الإسلامي من شأنه أن يحررها من الإسقاطات التاريخية الغربية، ويعيد ربطها بوسطها الذي نشأت فيه ونمت، مما يسهم في التعامل الإيجابي معها.
والحاكمية بوصفها مفهوما له دلالاته المتعددة آثار عدة إشكالات تتعلق بمصدر هذه الحاكمية وأبعادها وعلاقاتها بمفهوم الحاكمية في التاريخ اليهودي المسيحي، وما اختلط به من التراث الوثني الإغريقي الروماني، وكذا علاقتها بمفاهيم السيادة والشرعية والمشروعية التي تبلورت في النهضة الأوربية، وموقفها في النسقين المعرفيين الغربي والإسلامي.
من هذا الباب يأتي هذا الكتاب محاولة في سياق البحث عن تحديد معرفي لهذا المفهوم وأبعاده السياسية، وهو يضم بين دفتيه تصديرا للدكتور طه جابر العلواني رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومقدمة وثلاثة فصول بمباحث فرعية، وخاتمة …

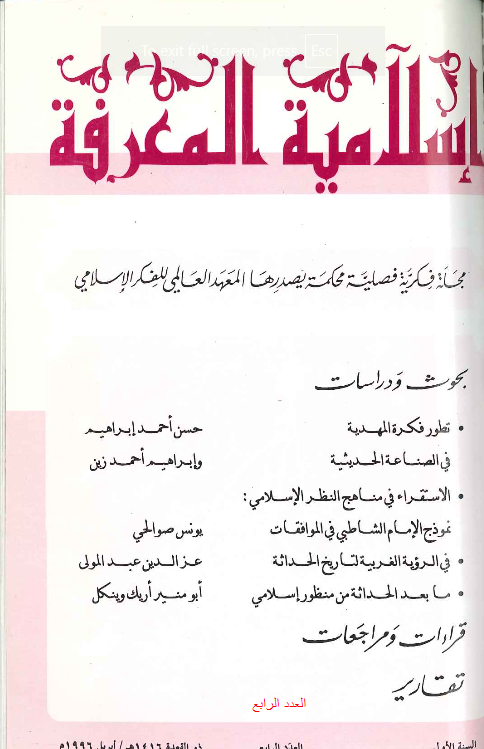
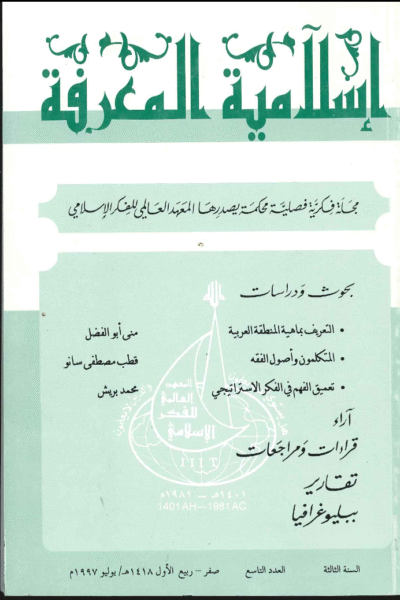
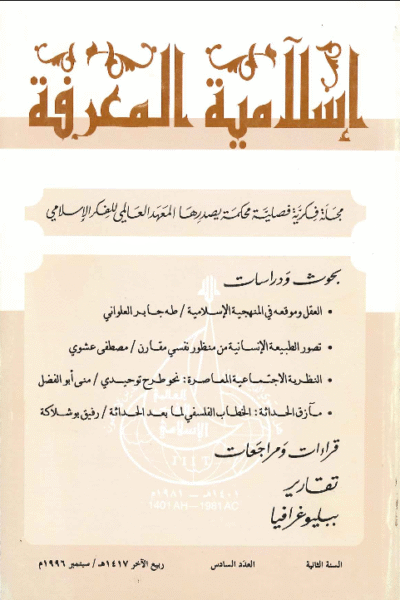
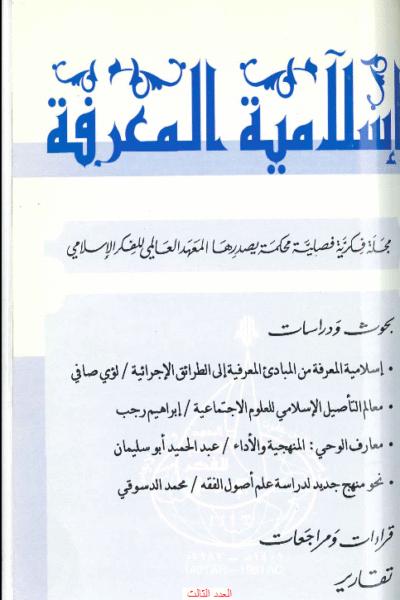
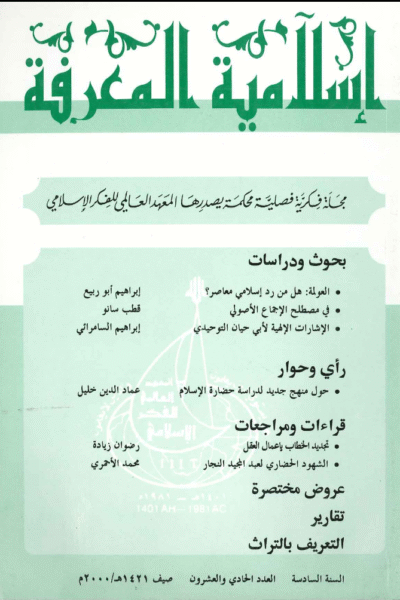
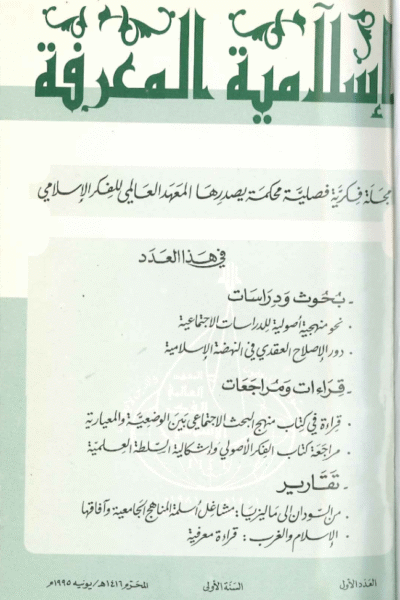
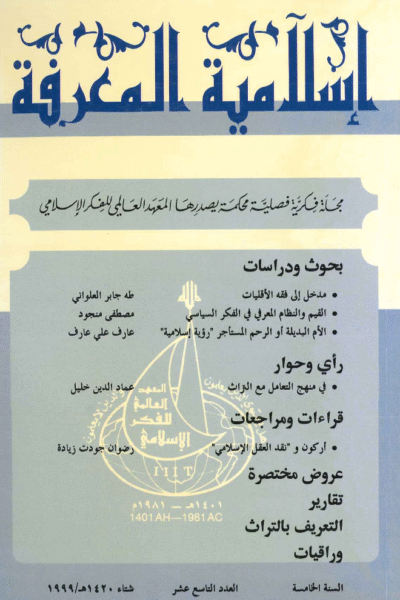
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.