الوصف
كلمة التحرير
===========
هذا هو القسمُ الثاني من بحوث مؤتمر: “عبد الرحمن بن خلدون: قراءة معرفية ومنهجية”، التي تم اختيارها للنشر في مجلة إسلامية المعرفة، من بين البحوث التي عُرِضت في ذلك المؤتمر، الذي نظَّمه المعهدُ العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعة آل البيت في الأردن. وإذا كان القسم الأول قد ركَّز على تَفَحُّص عناصر الرؤية الكلية لابن خلدون، بخصوص قضايا الكون، والإنسان، والحياة، والمعرفة، إلخ، وتبيُّنِ الأسس والمنطلقات المعرفية والمنهجية التي صاغت هذه الرؤية، فإن هذا الجزء يُفصِحُ عن تمثُّلات الأفكار الخلدونية في عدد من المعارف والعلوم، كالاجتماع، والتاريخ، والتربية، وعلم الكلام، والاقتصاد، إلخ. وهل كانت هذه الأفكار الخلدونية بِكراً وتجديداً في عصرها، أو أنها تمثُّلٌ آخر لأفكار سابقة، يمكن تتبُّعُها في التراث الإسلامي السابق لابن خلدون، وملاحظة علاقات التأثير والتأثر في الفكر الخلدوني؟
لقد أسبغ بعض الباحثين على ابن خلدون الكثير من الأوصاف السَّنِيَّة، بوصفه مؤسساً لبعض العلوم، وعدّوه حالةً فريدة قَلَّما جاد الزمان بمثلها، وتتساءل بعض أبحاث هذا العدد عن انقطاع السند الفكري والمعرفي مع ابن خلدون ضمن إطارنا العربي والإسلامي، وعن مدى التراكم في جهود الباحثين المسلمين من بعده لتطوير العلوم الاجتماعية المتخصصة التي أسَّسَ لها.
ولأن ابن خلدون غدا إرثاً عالمياً تجاوز من خلاله جغرافية العالم الإسلامي، لم يكن من اليُسر والإنصاف أن نتحدث عنه في إطارنا العربي والإسلامي فقط، فرحْلةُ أفكارِه …
بحوث ودراسات
==============
تهدف الورقة إلى تتبع المنهجية التاريخية لابن خلدون، وإبراز التمايز بينها وبين المؤرخين الذين سبقوه، ثم محاولة التعرف إلى مصادر ابن خلدون وأسلوبه في الكتابة التاريخية، ثم التدقيق في معايير النقد عند ابن خلدون في تلقي الأخبار وإثباتها، وبيان مدى التزامه في تطبيق تلك المعايير. واستندت الورقة إلى كل من المناهج الآتية في التعامل مع مادتها: التاريخي، والاستقرائي، والوصفي. وقد ناقشت الورقة فلسفة التاريخ والمنهجية التاريخية عند ابن خلدون، ونظريته في فلسفة التاريخ، ومنهجيته في نقد الروايات، وقبول الأخبار، ومدى التزامه بمنهجيته، وخاتمة تعد تلخيصا للبحث ونتائج.
يندرج البحث في إطار الدراسات التي تتناول الجانب العلمي من التراث العربي والإسلامي، ويتمحور حول فرع من فروعه وهو علم الاجتماع. جاء البحث ليبرز جانبا من إسهامات ابن خلدون من خلال تحليل جوانب من مقدمته، واستخلاص بعض الأفكار الاجتماعية التي اشتملت عليها، وتركيبها، والبناء عليها، في إطار المحاور الآتية: علم التاريخ منطلق لعلم الاجتماع الخلدوني، ومنطلقات علم الاجتماع، والسلطة ضرورة اجتماعية، والمجتمع البدوي، والمجتمع الحضري، والعصبية والنبوة، والعصبية والدولة وأجيالها. وخاتمة ملخصة للبحث.
الملخص
جاء البحث دراسة تحليلية لفكر ابن خلدون الكلامي، عبر منهج تاريخي يعرض تتبع الفكر الكلامي قبل ابن خلدون وفي عصره. وقام البحث على دراسة المحاور الآتية: تعريف علم الكلام، وبيان منهجه ووظيفته، وعلاقة علم الكلام بالتصوف، ودور العقل في مسألة المعرفة. ثم البحث في مسألة الإلهيات، وعلاقة الذات بالصفات. ثم مسألة النبوات، والإمامة لتعلقها بهذا العلم. ثم خاتمة فيها النتائج التي توصل إليها البحث.
تحاول الورقة تقديم قراءة في الدراسات الخلدونية؛ بهدف الإجابة عن مدى اقتراب هذه الدراسات من إسهام ابن خلدون في مجال العلاقات الدولية: تنظيرا، وحركة. وتنطلق الدراسة من إشكالية معرفية تنطلق باختلاف النماذج المعرفية، وأخرى بمجال النظرية السياسية المقارنة، وفي مجال منها ما يتعلق بنظرية العلاقات الدولية من منظور مقارن بصفة خاصة ضمن: خريطة الاتجاهات والإشكاليات، ومدى الاقتراب من مجال العلاقات الدولية، ومراجعة حالة العلاقات الدولية، والتراث الخلدوني بين الحضور والغياب، وقراءة في هذا التراث، وإسهامات منهاجية ابن خلدون في دراسة التغير الدولي، وخاتمة تطرح سؤالا لماذا فشلنا خلال ستة قرون في تشخيص أسباب الانحدار؟!
——————–
جاءت الدراسة، كي تظهر رؤية ابن خلدون لوظائف الدين الحق في العمران الاجتماعي، ومدى انسجام هذه الفكرة مع العلاقة بين الدولة والجماعة، وأن تبرز دور ابن خلدون في الكشف عن السنن الإلهية في العمران البشري، لا سيما تلك السنن المتعلقة بعوامل القوة والضعف في أي مجتمع إنساني. فقد تناولت الدراسة: العمران البشري عند ابن خلدون بين الرؤية القرآنية والفلسفة اليونانية، وموقع الدولة من العمران، ووظيفة النظام الديني في الدولة في فكر ابن خلدون، ومنهج ابن خلدون في فهم النص الشرعي المتعلق بالموضوع الاجتماعي، ثم خاتمة مختصرة عن المنهج العلمي الذي سار عليه ابن خلدون.
——————–
Elian al-Jaloudi’s article begins from the premise that the ijtihad of Sunni jurists and their theorization on Khilāfah (the caliphate system) reflects in many aspects the historical reality. It contends that in the context of the jurists’ concern for legitimacy and out of fear of strife, they resorted to finding ways to reconcile between the model of the Rashidun Caliphs and the political practicality of this model. The article argues that opinions tended to accommodate the new reality from the time of al-Mawardī, then al-Juwaynī and al-Ghazālī, and later Ibn Khaldūn. The article addresses this issue from two angles: from the vantage of the practical historical development of the Khilāfah; and from the vantage of theoretical discourses on the Khilāfah by Muslim scholars and jurists, with particular attention given to the views of Ibn Khaldūn. The article discusses the following themes: the concept of Sultanate in practice, the relationship between a Sultanate and Khilāfah in theory, and the Imamate in the thought of Ibn Khaldūn.
——————–

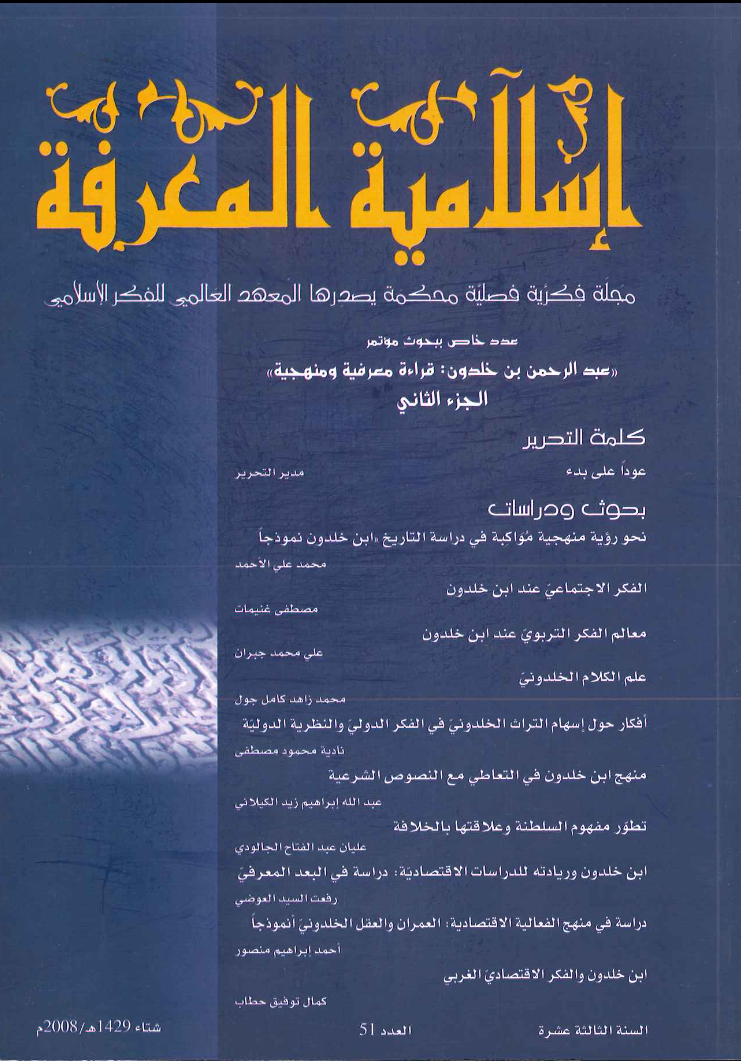
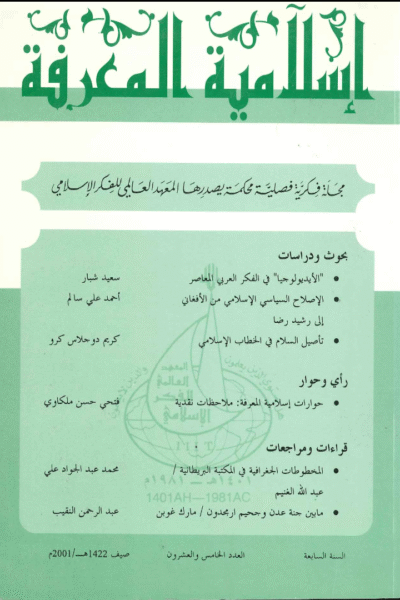
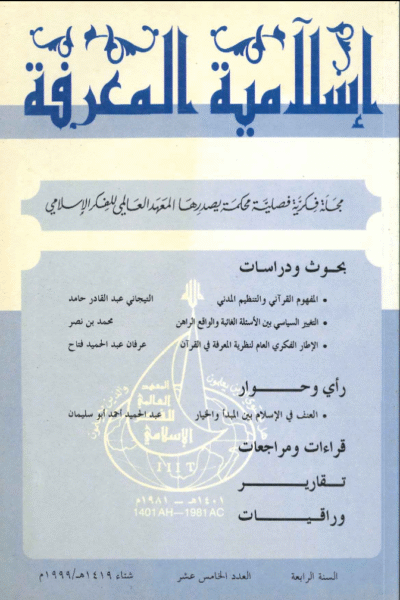
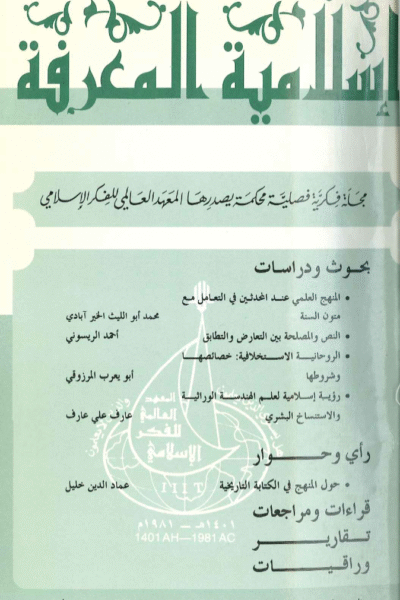
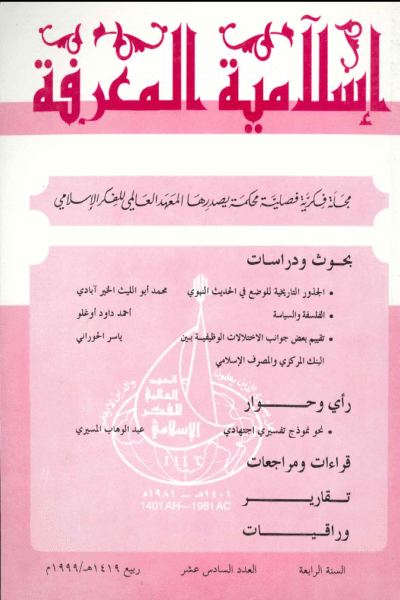
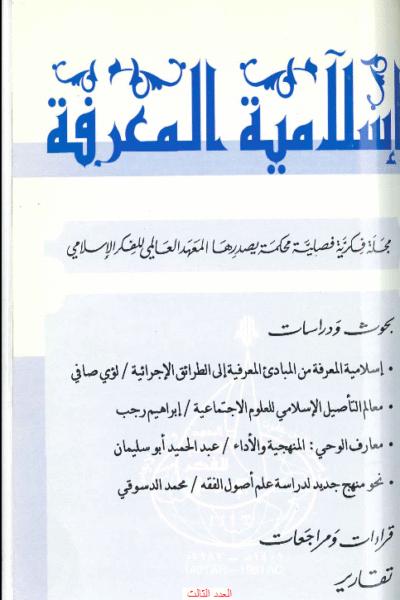
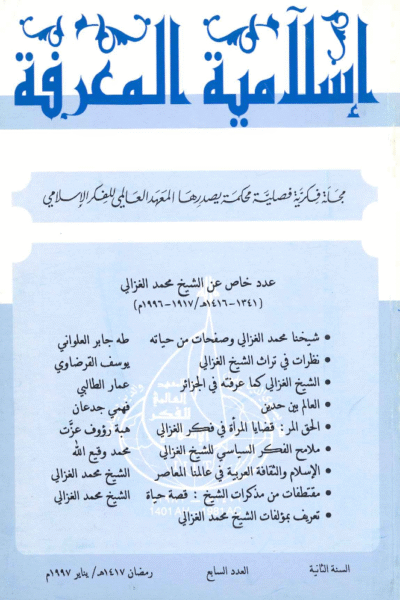
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.