الوصف
كلمة التحرير
الملخص
نستفتح بصدور العدد الخامس من “إسلامية المعرفة” دورة جديدة من عمر المجلة، ونستشرف عبره طورا جديدا في مسيرة الإصلاح الفكري والمنهجي. ولقد وطّن المعهد العالمي للفكر الإسلامي نفسه على المرابطة في هذا الثغر، حفزا لعقول المفكرين والعلماء وتنسيقا لجهود الباحثين، من أجل توطيد قواعد صلبة وإرسال تقاليد راسخة لنهضة علمية ومعرفية شاملة، تتكامل وتتساند مع الجهود المتصلة التي ما انفكت فصائل الأمة وقواها الحية تبذلها، سعيا للشهود الحضاري، وتطلعا للاستخلاف، استواء في ذلك كله على قاعدة التسخير وقياما بالحق والعدل.
وليس خطاب إسلامية المعرفة -ولا ينبغي له أن يكون- خطابا خاصا يتوجه إلى المسلمين دون سواهم، وإن كان المسلمون هم المقصودين به ابتداء، بل إنه خطاب منشغل بالإشكاليات الرئيسة التي ما فتئت تؤرق عقول الفلاسفة والمفكرين المهتمين بقضايا المعرفة الإنسانية فلسفة ومصادر وغايات. ولقد تزايدت أصوات التحذير والإنذار إزاء تطرف الفلسفات المادية ذات التوجهات الحصرية والأحادية التي يوشك أن يتحول معنى المعرفة عندها إلى مجرد معادلات من الرموز التي تحيل على معطيات مادية باهتة. فمفهوم الواقع موضوع المعرفة ـ ما انفك في انحسار يوشك أن يبلغ حد التلاشي ولاندثار، فلا يبقي لدينا إلا مقولات لغوية وعمليات ذهنية يتلهى بها الإنسان ويدير بواسطتها لعبة الحياة الفاقدة للمعني. فإذا بالذكاء ـ الذات العارفةـ بعدما جرد من أبعاده الروحية، وقطيع عن أسباب وجوده الغيبية المتجاوزة لعالم المادة والمتعالية عليه، وحصرت قدراته المعرفية وقواه الإدراكية في الحس ومعطياته والعقل وقوانينه، ما انفك مفهومه هو الآخر في تراجع وانحسار. فإذا بالذكاء الطبيعي يتوارى أمام الأجهزة ذات “الذكاء” الاصطناعي المتعاظم (Artificial Intelligence)!
وليس غريبا عندها أن نقرأ عن نهاية العقل لفاير باند Paul Fayerband وليس عجيبا كذلك أن يبشر فلاسفة آخرون. بموت الإنسان كما كان سلفت لهم من قبل قد أعلنوا موت الإله؛ كناية عن نهاية الدير قوة …
بحوث ودراسات
================
يطرح الباحث الأفكار الرئيسة المتعلقة بما قبل المنهج، سعياً لتأسيس فلسفة التسخير والتآلف مع الطبيعة مقابل فلسفة الصراع معها، وتجاوز المتقابلات الثنائية التي تحكم الفكر والعقل في الحضارة الوضعية المادية، فيستهل البحث بتعريف مفصلي لمعنى الأسلمة، ويخلـص إلى أن المصطلح يعبّر عن منهج فكري طموح في التثاقف الحضاري. ويشرع في شرح المقصود بمصطلح (إسلامية المعرفة) وكيف يتم إخضاعه لرقابة عقائدية، وللنقد والتحليل، ولإعادة التأويل والتفسير، والبناء والتركيب، لينسجم مع مسلمات العقيدة ومنهج القرآن الكريم في صياغة الأمة. ثم يشرح المقصود بمفهومي الوسطية والأخلاق من خلال فهم أئمة الفكر الإسلامي لهما.
يناقش البحث جملة من القضايا المنهجية الأساسية الخاصة بالدراسة المقارنة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مستعرضاً لما ترتبط به تلك القضايا من أطر فكرية مرجعية هي التي يكتسب فيها الحكم الفقهي، والقاعدة القانونية مكانتهما، ويؤديان وظائفهما، رابطاً معالجته بالسياق التاريخي والاجتماعي خاصة في مصر، فيبدأ بإجابة السؤال الأساس حول جدوى المقارنة بين القانون والشريعة، وكيف غزت القوانين الوضعية المجتمعات الإسلامية، والمطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية بوصفها شريعةً حاكمةً، وإلى القضاء الشرعي بدلاً من القوانين الغربية الوضعية. ثم يعرض للاتجاه العلماني وموقفه من تطبيق أحكام الشريعة. ويتناول البحث بالشرح مفهوم التنظير الفقهي، وتقعيد الأحكام الشرعية.
الملخص
يرصد البحث جدل الوحدة والتنوع في التجربة التاريخية الإسلامية على المستويات الفكرية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، وربط ذلك بالإطار المرجعي والقيمي للإسلام. فيطرح بدايةً مفهوم التعددية، والعلاقة بين التصور الإسلامي والتاريخ، وكيف عكست الخبرة مفردات التصور الإسلامي للكون والحياة، شارحاً مفهومي الوحدة والتنوع من خلال مسيرة التاريخ الإسلامي، وعوامل نشوء الدويلات والكيانات الإقليمية. ويعرض لموقف المسلم من الآخر (أهل الذمة) وأسس وأصول العلاقة بينهما، وبين العربي وغير العربي. ويختم البحث بتناول انحسار دور السلطة أو المؤسسة في تحديد مسار النشاط المعرفي للمفكرين والعلماء المسلمين.
يطرح الباحث مشروعاً على العلماء والمفكرين حول علاقة المسلمين مع الآخر (الغرب) بحضارته وثقافته، ويعرض البحث لنظرة الغرب إلى المسلمين تاريخاً وحضارة من خلال (علم الاستشراق). ودعوة الباحث إلى إنشاء علم جديد هو (علم الاستغراب). ويفصل البحث أسباب تفكك العقل العربي الإسلامي، ويؤكد على مفهوم نسبية الغرب، وتراجع المركزية الغربية. ويتناول البحث مراحل تحقيق مشروع نقد الفكر الغربي:
* نقد الفكر الغربي الاحتجاجي أو المضاد، وذلك من خلال نقده لمفاهيم (الحداثة، وما بعد الحداثة، ونظريات التنمية، وفكر أحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة).
* الدراسات النقدية في خصوصية الحضارة الغربية، ومنها (نظرية ماكس فيبر، وخصوصية تطور التكنولوجيا الغربية، الأزمة المعرفية في العلوم الطبيعية، ودراسة الأسس الدينية والثقافية للمفاهيم الغربية، ثم المصادر اليهودية في الفكر الغربي).
قراءات ومراجعات
===================
يقول عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة: “البلاغة تعطيك الكثير من المعاني بالقليل من اللفظ”، ويقول أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية: “أفصح الكلام أوجزه، وأكثره رموزاً، وأجمعه للمعاني الكثيرة والأحرف اليسيرة”.
يكشف هذان النصان حقيقةٌ مفادها أن أسلوب الكتابة ليس حضوراً محايداً في تحديد الدلالة، بل هو عنصر مولّد لها، تنبجس من خلاله الرؤى التأويلية التي لا تزيدها العبارة إلا إغناءاً وإثراءاً.
كذلك يعتقد النقاد المحدثون أن أهمية النص -أيِّ نص- لا تكمن فيما يكشف عنه من الحقائق فقط، بل فيما يثيره من جدل وحوار، وما يولده من التأويلات، وما يستدعيه من تعدد القراءات، بمعنى أنه ذلك الذي يتيح لنا أن نتحدث عن تناقضاته واختلافاته، وتوتراته حيناً، وسكونه أحياناً، وضعف استدلالاته طوراً وتماسكها أطوراً أخرى، إنه ذلك النص الذي لا يزيده النقد إلا حياة وانبعاثاً وانكشافاً، ولا تقتله إلا الغفلة والنسيان.
ويؤكد المفكرُ الناقد علي حرب هذا المعنى فيقول: “إن قوة النص في حجبه ومخاتلته، لا في إفصاحه وبيانه، وفي اختلافه لا في وحدته وتجانسه، وعندئذ يكون عمل الناقد تأويل الاشتباه، وكشف المحتجب، وفضح المخاتلة، وقراءة المستندات السرية، وإبراز لأصالة المأصول ولا ذاتية المنقول”.
وما معنى “القراءة” إذا لم تكن إنتاجاً لنص جديد لا يقل قوة ولا أهمية عن المتن المقروء؟ فأن نقرا نصاً ليس بالضرورة أن ننضبط لسلطة منطقه، بل أن نخلق من إرادتنا للمعرفة سلطة مضادة، وأن يتحول ذلك المتن إلى موضوع للدرس ورأسمال للصرف، وحقلاً للحفر ومساحة للتساؤل …
أحكام الشريعة معللة برعاية المصالح
إن المتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي يلحظ اهتماماً بالغاً في الفكر الإسلامي المعاصر بمقاصد الشريعة، ويكاد يحسم الخلاف القائم بين الأشاعرة من جهة، والماتريدية والحنابلة والمعتزلة من جهة أخرى، لصالح المجموعة الأخيرة في عصر العلماء القائلين إن أفعاله تعالى وأحكامه معلّلة بغايات وحكم قد تخفى في عصر وقد تبرز في عصر آخر.
وحسم الخلاف أعانت عليه مقتضيات العصر والميل إلى التعليل المنطقي في كل الأشياء وإضفاء الطابع العقلاني على مختلف الأحكام.
إضافة إلى أن المتأمل في حجج الماتريدية والحنابلة والمعتزلة يجدها أقوى على الإقناع من حجج الأشعرية في هذا الشأن.
قال الشاطبي: “زعم الرازي (فخر الدين) أن أحكام الله ليست معلّلة بعلة ألبتّة، كما أن أفعاله كذلك، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين…، والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءاً لا ينازع فيه الرازي، ولا غيره” …
هذا الكتاب لي معه قصة ربما ليس من المناسب ذكرها في هذه المراجعة، ولكن يبدو أن طرفاً منها سيعين القارئ على فهم بعض الملاحظات التي سأبديها بشأنه. كان ذلك في عام 1981، وكنا قد تخرجنا لتوّنا بقسم الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الخرطوم، وتم تعيننا في قسم أنشئ حديثا للدراسات الإسلامية بالجامعة بعد نـزاع شديد في مؤسسات اتخاذ القرار بين الإسلاميين والعلمانيين، ثم طلب مني التخصص في مقارنة الأديان، وطلب من الأستاذ التيجاني التخصص في الفكر السياسي الإسلامي. وبسبب قلة المكاتب -وعدم وجود مبان للقسم أصلا- منحنا قسم الفلسفة مكتبا واحدا، فصرنا نجلس فيه متقابلين.
وكان التيجاني حينما يفكر بصوت عال يتحول تفكيره إلى نقاش أجره فيه إلى موضوع رسالتي التي كانت عن “فلسفة العقاب في القرآن مع إشارة خاصة إلى أسفار موسى الخمسة”، ويفلح هو أحيانا فيجري إلى مواضع اهتمامه.
والأهم من كل ذلك أنني- وبسبب المصالحة الوطنية مع نظام الرئيس السابق جعفر نميري في 1977- كنت قد جمدت نشاطي السياسي في تنظيم الإخوان المسلمين، أو قل الحركة الإسلامية. وكانت حجتنا الأساسية- أنا ونفر آخرون معي- تتمثل في عدم مشروعية الدخول في نظام سياسي لا يقر بمبدأ الحاكمية. وربما كنا أكثر مثالية وأقل وعيا بخوض غمار السياسة ومجالدة السلطة، ولكننا كنا- على أي حال- نمتلك وضوحا نظريا وإرادة تكفي لتحقيق ما نسعى إليه.
وكان الأخ التيجاني يشاركنا ذلك الوضوح النظري، لكنه آثر أن يخوض غمار تجربة المصالحة الوطنية محققا ذلك المعنى الذي تكرر في كتابه ألا وهو:
الإمساك بالأرض والتطلع إلى المثال من خلال توحيد لا يفصل بين الأرض والسماء، ولكنه يحقق توترا فعالا هو جماع الكسب الديني التوحيدي. وعلى الرغم من أن هذه واحدة من أطروحات الدكتور حسن الترابي الأساسية في تفسير حركته وكسبه الديني، إلا أن الأخ التيجاني عبد القادر قد حاول أن يحولها إلى مشروع فلسفي ناضج يعبر عن قيم التوحيد في سياق المصالحة الوطنية التي نظر إليها- في أوساط الإسلاميين عموما في السودان وخارجه- على أنها انحراف عن المنهج الحركي السليم، وتسليم مشين للعلمانيين …
——————–
محبوبة بن نصر
الكتاب هو دراسة قدمتها الباحثة المصرية الأستاذة هبة رؤوف عزت للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1413ﻫ/1992م، وهي تتناول فيها مسألة مهمة جداً من المسائل المطروحة اليوم على الساحة الفكرية الإسلامية، ألا وهي قضية المرأة والعمل السياسي في الفكر الإسلامي.
يتكون الكتاب من 311 صفحة من الحجم المتوسط. وقد بنت الباحثة دراستها على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وقد احتوى كل فصل على عدد من المباحث، وتفرع كل مبحث إلى عدد من المطالب. وتضمن الكتاب كذلك ثبتاً بقائمة مهمة للمراجع العربية والإنكليزية احتلت تسعاً وثلاثين صفحة، فضلاً عن فهرس للأعلام وكشاف للموضوعات الواردة في الكتاب… وقد صدَّر للكتاب الدكتور طه جابر العلواني وقدم له المستشار طارق البشري.
إن أهمية الكتاب تكمن أولاً في موضوعه، إذ أنه موضوع اشتد حوله الجدل ودارت حوله نقاشات طويلة بين الإسلاميين والعلمانيين، وبين الإسلاميين أنفسهم، لا في أوساط الباحثين المختصين والعلماء والمثقفين فحسب، بل في كل الأوساط الاجتماعية، فهو موضوع ترتبط به وتتفرع عنه العديد من الإشكاليات الفكرية الأساسية في حياتنا الاجتماعية والسياسية.
وعلى الرغم من الجدل القائم حول هذا الموضوع منذ نهاية القرن التاسع عشر مع مفكري عصر النهضة، فإن المرأة -صاحبة الشأن- ظلت غائبة غياباً فعلياً عنه.
وتتمثل الخاصية الثانية للكتاب في كونه من إنتاج قلم امرأة. أما الخاصية الثالثة فتتمثل في تجاوز المسائل التقليدية مثل التعليم والاختلاط… إلى طرح مسألة حيوية، هي الدور السياسي للمرأة في الرؤية الإسلامية، وهو من القضايا الشائكة داخل الفكر الإسلامي القديم والحديث، وتعد الدراسات التي خصصت لهذا الموضوع قليلة جداً. ونذكر على سبيل المثال كتاب …

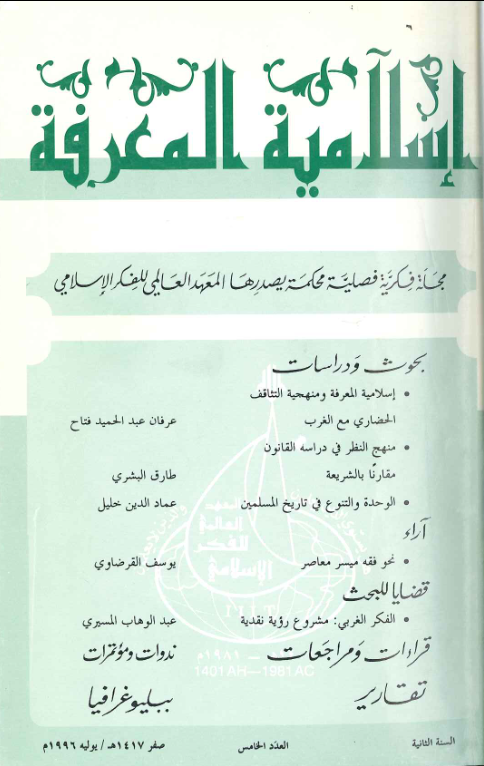
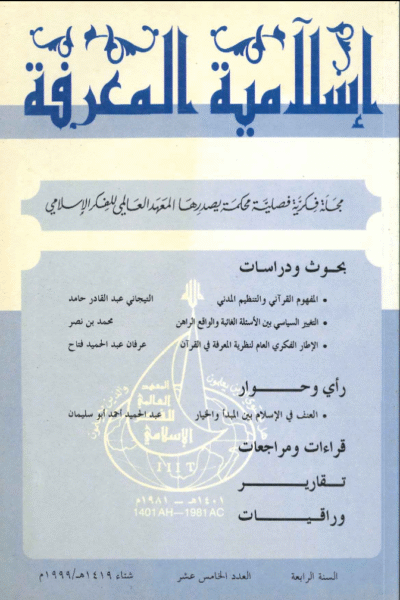
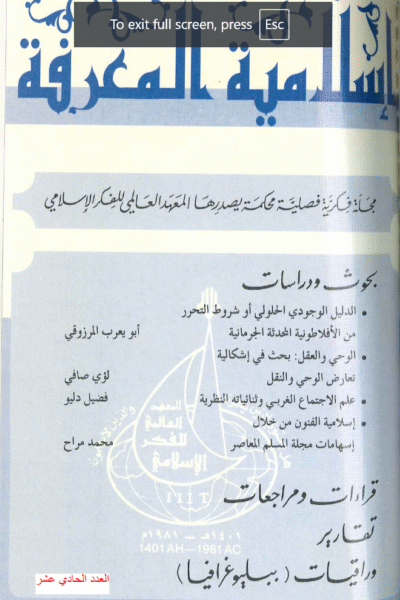
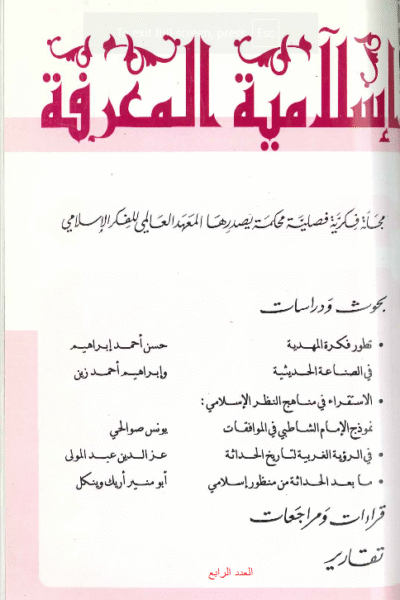
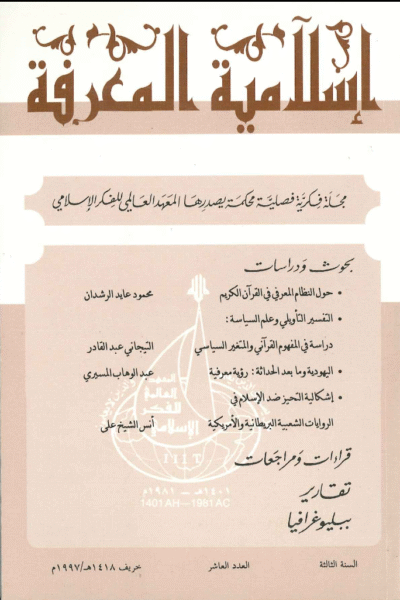
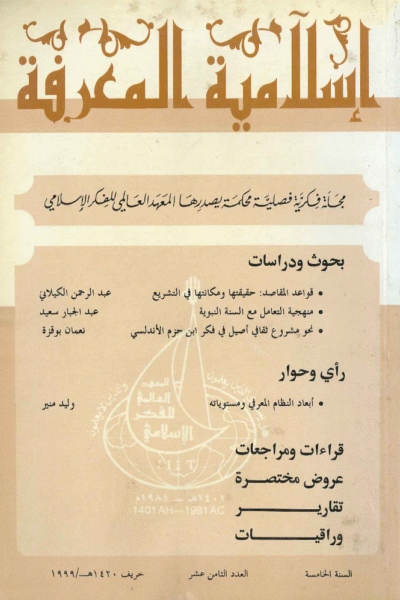
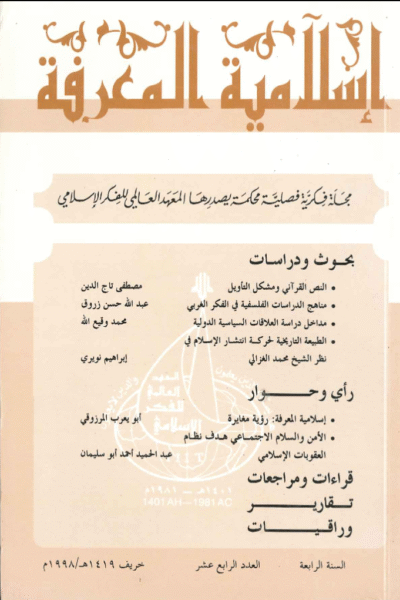
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.