الوصف
كلمة التحرير
الملخص
مثلت العلاقة بين الوحي والعقل في التاريخ الفكري والثقافي للمسلمين الإشكالية الرئيسة التي منها تنبع سائر الإشكاليات الأخرى وإليها تعود. فإذا كان الوحي هو خطاب الله تعالى المتضمن هدايته للبشر، وإذا كان العقل هو مناط تلقي ذلك الخطاب وإدراك الرسالة التي يحملها، فإن كيفية النظر إلى العلاقة بينهما وفهم مستوياتها وأبعادها تحكم في النهاية أوجه تفاعل العقل الإنساني مع الوحي الإلهي كما تحدد التجليات التاريخية لذلك التفاعل على المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
ولقد شهدت السنوات العشرون الأخيرة بصورة خاصة اهتماماً متزايداً بقضية العقل وطرحاً مكثفاً للإشكالية المتصلة به في تاريخ العرب والمسلمين وحاضرهم، بعناوين مختلفة ومن منطلقات متنوعة ولغايات ومقاصد متباينة. فمن نقد العقل العربي (محمد عابد الجابري) إلى حول تشكيل العقل المسلم (عماد الدين خليل)، ومن خلافة الإنسان بين الوحي والعقل (عبد المجيد النجار) إلى أزمة العقل المسلم (عبد الحميد أبو سليمان)، ومن إصلاح العقل في الفلسفة العربية (أبو يعرب المرزوقي) إلى مفهوم العقل (عبد الله العروي)، ومن اغتيال العقل (برهان غليون) إلى نظرية العقل (جورج طرابيشي) … إلخ، والإشكالية هي الإشكالية، مهما تنوعت أساليب الطرح وتباينت آليات الخطاب.
إلا أن ما يمكن أن نلاحظه في هذا السياق هو أن أغلبية البحوث والدراسات التي تناولت هذه الإشكالية تتجاوز الوحي بوصفه، من الناحية التاريخية على الأقل، المرجع الأساس الذي قامت عليه الفعاليات الحضارية في تاريخ المسلمين والنص الذي استلهموا منه أنماط خطابهم الفكري وبنوا بوحي منه نظمهم الثقافية. وهذا أمر لا مسوغ ولا تفسير مقنع له، والحال أن الوحي يقع في الصميم من الإشكالية ذاتها، سواء كان ذلك من الناحية التاريخية أم من الناحية المعرفية والنظرية. ونحسب أن الاقتصار في طرح هذه الإشكالية على النظر في تجلياتها التاريخية من خلال التراث الفكري والثقافي للمسلمين دون العود بها إلى …
بحوث ودراسات
================
يبدأ البحث بشرح أهمية العقل، وتعدد الكتابات حول العقل المسلم والعقل العربي. ويتناول البحث وظيفة العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية، فيبدأ بكيفية تعامل سلفنا الأوائل مع الوحي والعقل، وكيف أحسنوا الجمع بين القراءتين، وتمسكوا بالوحي وأعملوا العقل. ويتناول حقيقة العقل ومعرفة ماهيته، ثم يفرق البحث بين العقل العلمي والعقل النظري، ويعرض لمراتب الإدراك العقلي الخمس، وعلاقة الوحي بالعقل عند سلف الأمة، ثم البدايات الأولى للفصام بينهما مع شرح للفروق الجوهرية بين التفسير والتأويل، ثم العقل والنقل ودورهما في المجال الفقهي، مع عرض لبعض نماذج الإبداع للوحي الإلهي وللعقل المسلم عند الأئمة الأربعة.
كثرت الأدبيات حول الطبيعة البشرية من منطلق فلسفي أو خلقي أو ديني، لذا يبدأ البحث بسرد لأهم أسباب عدم اهتمام النفسيين بطرح موضوع الطبيعة البشرية. ويشرح البحث مفهوم الشخصية من المنظور الغربي، ثم خصائص الطبيعة البشرية من المنظور الإسلامي، مستعرضاً البعد الروحي والبعد السلوكي والبعد الغيبي لها. ويجيب البحث عن التساؤلات الآتية:
هل الإنسان ذو بعد (مادي) أم ذو بعدين (مادي وروحي)؟
هل الإنسان ذو طبيعة خيرة مطلقة أم شريرة مطلقة؟
هل ماضي الإنسان أكثر تأثيراً في سلوكه أم حاضره؟
هل التعلم أقوى تأثيراً في سلوكه أم الوراثة؟
هل التفاؤل أساس الطبيعة البشرية أم التشاؤم؟
هل كل إنسان متفرد بخصائصه أم هناك عالمية وشمولية في الطبيعة البشرية؟
الملخص
يقدم البحث دراسة نقدية للنظرية الاجتماعية المعاصرة في الغرب، ويكشف عن عناصر المنظور المعرفي الذي حدد سمات تلك النظرية وشكل مقولاتها، ومناهجها، وتطورها في ظل ما أسمته نموذج (الثقافة المتذبذبة). وتأتي الدراسة في إطار الدعوة إلى مراجعة النظرية الاجتماعية وإعادة بنائها وفق نظام معرفي توحيدي. فيستهل البحث بتمهيد لشرح مفهوم النظرية الاجتماعية في إطار المنظومة المعرفية المهيمنة، ثم مقدمات في نموذج الأنساق المعيارية المتقابلة، ثم المقدمات الفلسفية لعلم الاجتماع المعاصر، واستفحال مبدأ التكالب والصراع والتناقض في شرح النظريات الاجتماعية. ثم شرح مفهوم النظرية الاجتماعية من خلال منظور (الثقافة الوسطى) القائمة على النظام السياسي الاجتماعي الإسلامي.
البحث محاولة لرصد مآلات الفكر الفلسفي الذي تبلور في عصر التنوير الأوربي، ومهد الطريق أمام الحداثة الغربية، مركزاً على قراءة بعض التيارات الفلسفية والثقافية التي تفرعت عن ذلك الخطاب الفلسفي. فيعرض لمآزق الحداثة من بداية القرن التاسع عشر وحتى مرحلة التأزم والتفكيك، مستعرضاً آراء فرويد، ولاكان، وماركس، وألتوسير. ثم التيار التفكيكي الهدمي من خلال آراء فوكو، ونيتشه، وهايدجر. ثم الرؤية المغايرة من خلال هابرماز، وديكارت، وفاوست، وفوكوياما. ويخلص إلى أن الحداثة مشروع غير مكتمل؛ لذا يصح القول بتعدد وجوه الحداثة ومساراتها بحسب الخبرة التاريخية، والثقافية للشعوب.
قراءات ومراجعات
===================
لا شك أن مجرد الكتابة عن نص مثل كتاب إصلاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر تقتضي خبرة واسعة فيما أسماه د. طه جابر العلواني “فكر الحركة وحركة الفكر”. وليس ذلك فحسب، لأن نص الكتاب يعد نصاً مفتوحاً دخل في جملته الأولى في تناص حيوي مع سيرة التجديد الفكري والشهود الحضاري، وبنى نسقه الأساس على مقولات التجديد والاستيعاب والتجاوز للتراث الإسلامي والانفتاح الواعي على تراث الإنسانية لأداء مهمة الشهود الحضاري والإنقاذ. إذا كان ذلك هو موقع الكتاب من حركة الفكر الإسلامي المعاصر فالكتابة عنه تمثل قولاً ثقيلاً لا طائل لأي قلم كائناً ما كان أن يحمل هم التعريف به. وإذا كانت مراجعات الكتب قد قصد منها تقديم قراءة للكتاب قيد المراجعة وإدراجه في خريطة التأليف ونسق صناعة الكتابة في موضوع ما، فإن هذا السفر الذي نراجعه لا يحتويه هذا الباب ونرى انه من بلادة الطبع واستحكام العادة أن نكتب مجرد مراجعة له، فالمراجعة أمر يقصر عن همّ الكتاب ويُدخل المراجع ف يوهم يتناسل لينتج جملة من الحواشي التي تتطفل على متن النص ولا تقد جملة مفيدة في فهمه وإدراك كنهه. إن صحّ ما قلناه آنفاً في شأن الكتاب قيد المراجعة فيكون صدق هذه المراجعة مساعدة القارئ الكريم في فهم وقع هذا السفر على واحد ممن شملهم كتاب إصلاح الفكر الإسلامي بخطابه الأساس وقضى عليهم بفهم موقعهم من قضية إسلامية المعرفة. وعلى هذا الأساس تكون المراجعة محاولة لاكتشاف الذات وموقع القارئ من شبكة نظم الخطاب، فالقراءة تتحول إلى توطين للنفس على إدراك مهمتها وموقعها من نص المنظومة الفكرية التي يطرحها النص …
ليس الغرض من هذا العرض تقويم دراسة اجتهد فيها الباحث الكريم وبذل فيها وسعه في موضوع مهم في الفكر الإسلامي المعاصر، ولكن أقصى ما تنشده هذه القراءة هو أن تعرض أفكار الكتاب بشكل عام، وتسهم في مناقشة إشكالية خطيرة تواجه العقل المسلم وهو يخوض حركة النهضة ويبحث في فلسفة المشروع الحضاري.
تقع الأطروحة الموسومة بفلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي، في جزأين ويبلغ عدد صفحاتها 1031 صفحة من الحجم المتوسط، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وفهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفهرس الأعلام.
قسم الباحث أطروحته إلى مقدمة وثلاثة أبواب أساسية وخاتمة في المقدمة تحدث عن حقيقة الفلسفة الإسلامية وحدد المجال الزماني والمكاني لدراسته، وتعرض لدراسة الفلسفة الإسلامية الحديثة والمنهج المعتمد فيها.
خصص الباب الأول لبحث أبرز العوامل التي ساعدت على نهضة الفكر الفلسفي في مصر في القرن العشرين، ولهذا الغرض قسم الباحث هذا الباب إلى ثلاثة فصول، ركز أولها على أثر عامل التعليم في نهضة الفكر الفلسفي، والثاني أكّد أهمية عامل الاستشراق والبعثات، وأما الفصل الثالث فقد أبرز فيه أهمية عامل الصحافة والترجمة في حركة نهضة الفكر الفلسفي في مصر …
يعد هذا الكتاب الذي بين أيدينا حلقة مهمة في بناء منهجية التعامل مع الآخر الغربي، ذلك أنه يبحث في جذور الغرب الثقافية والمعرفية التي شكلت -ولا تزال- تعامُلَه مع غيره،كما يبرز الكتاب الاستعدادات الثقافية التي مكنت الغرب من أن يبلور، بوساطتها صورة عن ذاته، ويشكل صورة مشوهة للآخر لتأكيد ذاته، والتمركز المستعلي على غيره. ويتناول مصادر خطاب السيطرة على البشر بعد السيطرة على الطبيعة، ثم الاستشراق، وأيديولوجية الهيمنة.
يقع الكتاب في 160 صفحة من القطع المتوسط، متضمناً تصديراً للدكتور طه جابر العلواني، ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة.
في التصدير أشار الدكتور العلواني إلى أن عنوان الكتاب “الاستتباع” يستدعي إلى الذاكرة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات سادت في أوساط مثقفي الأمة منذ منتصف القرن الماضي، مثل: الاستعمار، والاستشراق، والاستغراب، والاستكبار، … النظام العالمي الجديد والإرهاب، والأصولية، والظلامية ونحوها.
والكتاب يستدعي هذه المفاهيم لأنه يعالج “حقلاً معرفياً” واسعاً يتصل بكل هذه المفاهيم. وهذا الكتاب يتناول الغرب بتحليل بنائه وأطره المنهجية، ومسلماته المعرفية (الإبستمولوجية) وفلسفته ونظرياته وقواعده المعرفية، وينقب عن كيفية تحول الغرب إلى المركزية في رؤيته لذاته وتهميشه للآخرين، بل واستتباعهم.
ويشير إلى الطريقة التي تناول بها العقل المسلم ظاهرة الاستشراق، وأنها كانت دون مستوى الإحاطة بالظاهرة، وانعدام الاهتمام بتحليل البنى المعرفية والأطر المنهجية للاستشراق بوصفه حقلاً معرفياً نشأ في إطار العلم الغربي وفلسفته ونظرياته وأسسه المعرفية، وكان موضوعه الآخر غير الغربي، مستمراً في الشرق المسلم، وأن هذا الحقل المعرفي قد أسس لنفسه علوماً …

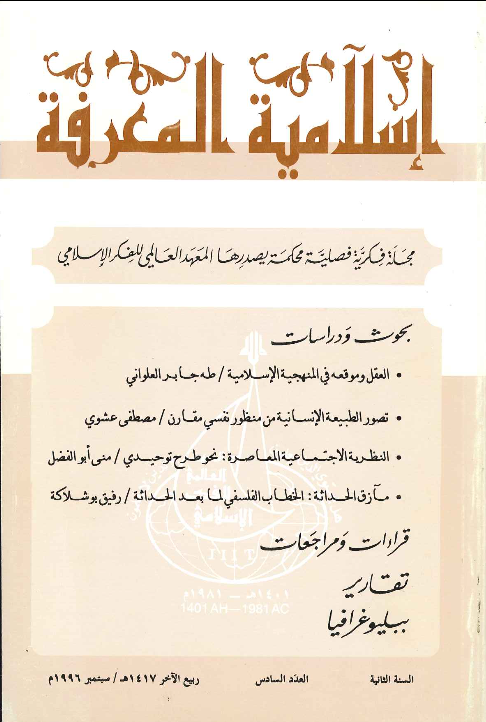
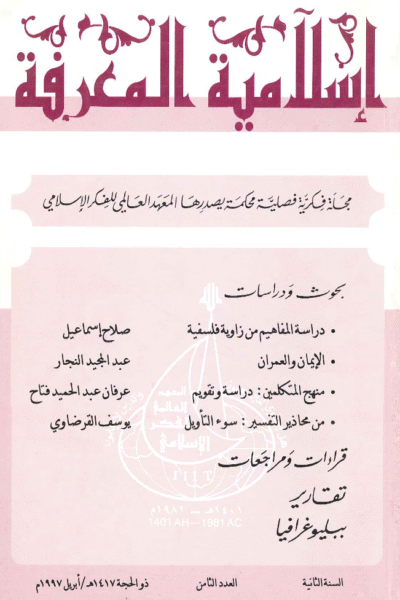
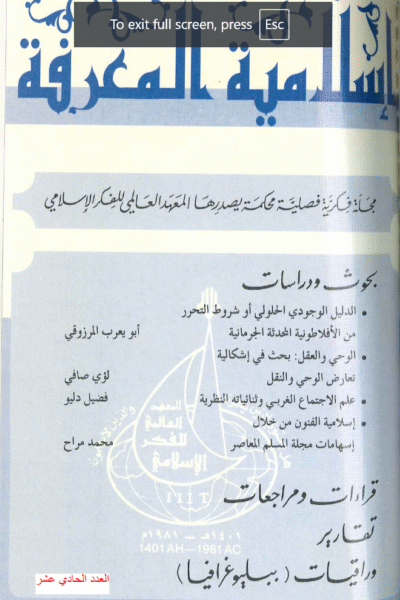
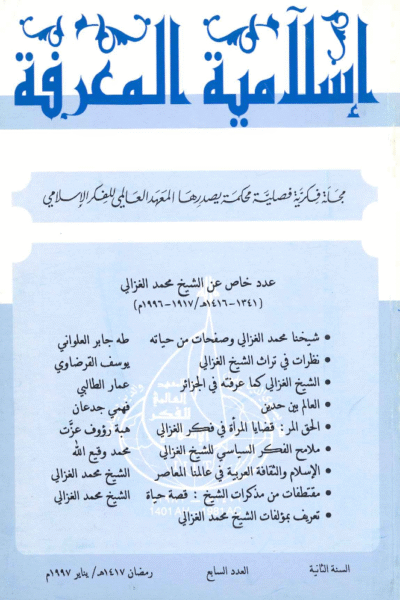
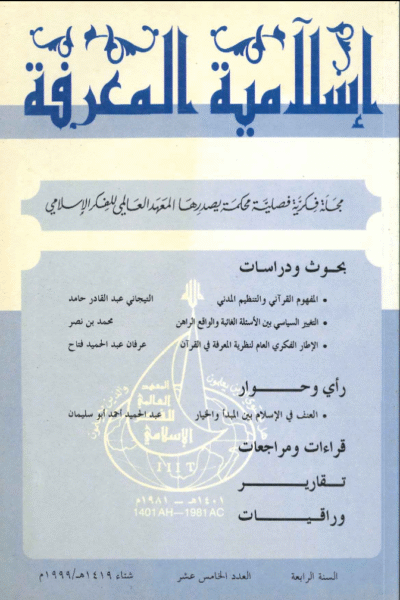
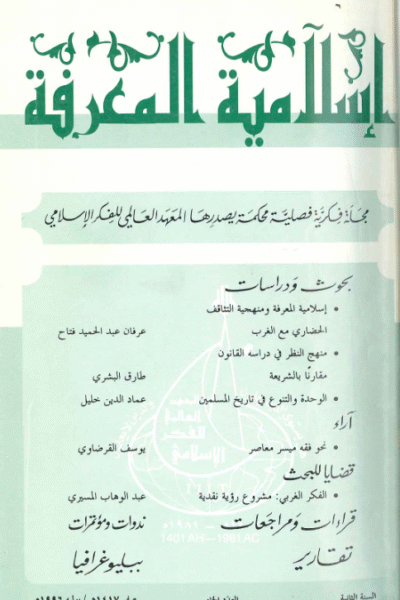
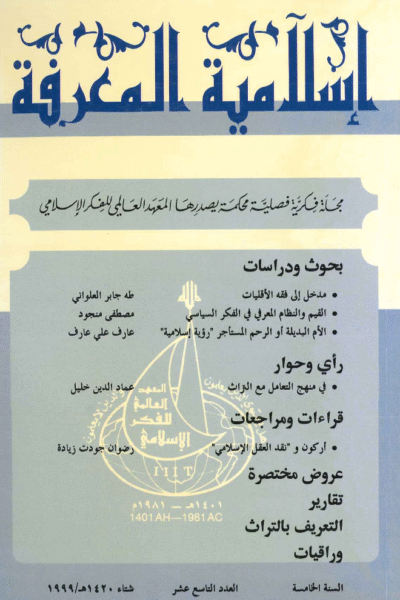
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.