الوصف
كلمة التحرير
===========
مثَّل الوحي الإلهي المرجعية العليا والقاعدة التأسيسية التي انبثق منها وانبنى عليها وتفاعل معها الجهد المعرفي في الحضارة الإسلامية. فعِلم الكلام والعقائد، وعلوم الفلسفة والحكمة، وعِلم الفقه والأصول، وعلوم التفسير والحديث، وعِلم الأخلاق والتصوف، بل علوم اللغة ذاتها، كل تلك العلوم والمعارف كان القرآن الكريم هو المحور الذي تحرك حوله وبوحي منه المشتغلون بها على اختلال مشاربهم، تحرياً لمداركه، وتفهماً لمعانيه، واستنباطاً لأحكامه، وتقصياً لمقاصده، سعياً في ذلك كله إلى التعبير عن حقائقه فكراً ونظراً وتجسيد قيمه ومثله واقعاً وسلوكاً.
وما من مفكر أو عالم أو مذهب أو جماعة انتمت إلى الإسلام بنسب إلاّ كان من أوكد همومها أن تؤسس مشروعية وجودها انطلاقاً من معطيات الوحي وبناء على فهم معين لنصوصه، مهما خالط ذلك الفهم من غرابة في التفسير والتأويل، ومهما داخله من أثر لمرجعياتٍ أخر قد تنبو منطلقاتها عن منطلقاتِه، وتجافي مقاصدُها وغاياتُها مقاصدَه وغاياتِه.
وإذا كان القرآن الكريم هو كلمة الله تعالى الباقية إلى عباده، به اكتمل الدين وختمت النبوة، فإنه والحال هذه لا يخاطب الإنسان كائناً مطلقاً مجرداً عن ظروف الزمان والمكان، ولا يتوجه إليه بوصفه فرداً منعزلاً عن أحوال الاجتماع البشري بعلاقاته ومؤسساته مهما كان حالها من البساطة والتعقيد، وإنما يخاطب القرآنُ الكريم الإنسانَ بوصفه كائناً محدوداً تجري عليه أحكام المكان ولازمان، وتتوجه إليه تعاليمُه وتكليفاتُه بما هو كائن ثقافي وتاريخي وعضوٌ في جماعة تسري عليه سنن الاجتماع البشري وقوانينه. وهنا يكون مناط الابتلاء وموطن الامتحان في حركة التدين كما يطرحها الإسلام، إذ المطلوب من الإنسان أن يكيف أوضاعه التاريخية المتغيرة: إقامة لعلاقاته الإنسانية، وتأسيساً لنظمه الاجتماعية، وتحديداً للقيم الحاكمة لحياته الفردية والجماعية، من خلال فهم خطاب الشرع الذي يتجاوز، فيما يطرحه من تكاليف وما يدعو إيه ن قيم وأحكام وما يحتوي عليه من تعاليم وتوجيهات، الأوضاعَ التاريخية المخصوصة التي تكتنف حياة الإنسان. وإذ أن الإسلام قائم على التوحيد بحيث تتشاكس أو تتقابل في نظامه عقائد الإيمان مع شرائع الحياة، ولا تتناظر …
——————–
بحوث ودراسات
==============
تتصدى الدراسة لمسألة المفاهيم وأهميتها في الحياة الفكرية. وتتناول كيفية دراسة المفاهيم من زوايا متنوعة ومناهج متعددة؛ منها المنظور اللغوي والنفسي والفلسفي، ويركز البحث على الزوايا الفلسفية والمعرفية للمفاهيم، ويوضح البحث أهمية المفاهيم بوصفها ضرورة معرفية، ثم يحلل بنية المفاهيم مستعيناً بفهم ديكارت لها، ثم يعرض للمفاهيم ومشكلة المعنى مستعيناً بفهم ابن جني، والجرجاني للمعاني، ويعرض لمفاهيم الدين، والأخلاق، والعلوم الإنسانية بصفة عامة، ويضع الباحث مجموعة قواعد تحكم التعامل الصحيح مع المفاهيم، ومنها الاعتراف بالخصوصية الحضارية للمفهوم، ومعرفة المعنى الاصطلاحي له، ومعرفة السيرورة الدلالية، ومعرفة الدلالات الأصلية والتاريخية للمفهوم.
——————–
يؤسس البحث لفلسفة علم الإنسان والمجتمع في الإسلام، فيبدأ بشرح مفهوم الإيمان بوجود الله وصفاته، والعلاقة بين الإيمان وصلاح الحياة، والمنافع العملية التي يحدثها الإيمان، فيتناول أثر الإيمان بالله في تزكية الفرد، وما يحدثه من تزكية للنفس، والطمأنينة والأمن، والعزة والقوة، وتزكية الفكر وتحرره، وسعة النظر، وتزكية العمل. ثم يعرض أثر الإيمان بالله في تزكية الجماعة، وما يتبعه من وحدة الجماعة، ووحدة الشعور، ووحدة الولاء، ووحدة الغاية، وتحرر الجماعة من القيود الداخلية والخارجية التي تعطل الإرادة الجمعية والطاقات، وما يحدثه الإيمان من تكافل اجتماعي في المجتمع.
الملخص
يقف البحث وقفة تأمل وتقويم لما طوره علماء العقيدة والكلام من مناهج ومقاربات، لبيان ما علق بها من حيثيات التاريخ ومعطيات الثقافة والمجتمع، ومبرزاً ما يصلح منها لتطوير مناهج الفكر عند المسلمين في مواجهة التحديات والمشكلات المستحدثة. شارحاً الأسس التي وضعها المتكلمون لإثبات صحة العقيدة الإسلامية والدفاع عنها، ومنها الدراسة المنهجية للمعرفة الإنسانية، والقراءة النقدية لأسس الأديان، وموقفهم من إنكار النسخ في الشرائع، ودفع شبهة التشبيه والمماثلة، وتنزيه الأنبياء عن الذنوب. عارضاً مواضع الخلاف بين التصور الإسلامي، والفلسفة اليونانية في الجوانب الإلهية، مختتماً بملحوظات نقدية ومنهجية للتيار السلفي.
يقرر البحث أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها دلالة على معانيها الأصلية. ويرى أن تأويل النصوص يصرفها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. لذا يقرر البحث أنه لا تأويل إلا بدليل، شارحاً اهتمام العلماء بوضع ضوابط وقواعد للتأويل، ويعرض مجالات التأويل عند كل من الشوكاني، والزركشي، وقواعد وأسس التأويل عند كلٍّ من ابن حزم، وابن حنبل، ونماذج لتأويلات الباطنية، والزنادقة، وبعض فرق الشيعة، وغلاة الصوفية. وكيف أسرفت المدارس العقلية في استخدام التأويل، ومنها المدرسة الفلسفية، والفرق الكلامية، والجبرية، والقاديانية، والبهائية. وسوء التأويل لآيات الحدود لدى بعض المفسرين المعاصرين.
قراءات ومراجعات
===================
يمثل كتاب لؤي صافي العقيدة والسياسة: معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية عملاً اجتهادياً وتأصيلياً جريئاً يعيد تأسيس فقه الدولة في الإسلام، وفق نظرية متينة تستجيب لمقتضيات الواقع الحديث.
وإنما أطلقت صفة (الجرأة) على الكتاب لأن مؤلفه تخلى نهائياً عن التحفظات والتحوطات التي اتبعها أكثر من كتب في الموضوع، فأدت إلى توريطهم في النظر الجزئي، والنـزعة الاتباعية، والتزام ما لا يلزم من تقديس التراث، والمعلومات العامة التاريخية، التي لم تستنبط من نصوص الوحي ولا كانت من معارفه.
فماذا كان سبيل المؤلف في تحرير الكتاب؟ أو ما المنهج الذي وظفه لتكوين معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية؟
لا يعتقد الدكتور لؤي صافي أن نموذج الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة يتعلق بذوات الصحابة أو أشخاصهم، وإنما بالقواعد الكلية التي وجَّهت أفعالهم، ومن ثم فهو يتجه إلى تحديد تلك القواعد بغية مقارنتها بمبادئ “الوحي” في محاولة لتعيين وجوه الاتفاق والاختلاف ما بين كليات الوحي ومقاصده، والقواعد التي استخلصها الصحابة منها. ثم يتبع ذلك بتحليل التجربة السياسية الراشدية، لتحديد ما هو خاص مما هو عام فيها. “البنية السياسية المتولدة عن مبدأ عام تفقد من عمومها تبعاً لمقدار الخصوص في البنية الاجتماعية للجماعة السياسية” (ص 33-34)، وهكذا فلا مجال لاستدعاء تلك التجربة على علاتها، وإنما لا بد من مراعاة الفروق التي يمكن أن تعكسها إعادة تطبيق المبادئ ذاتها على واقع مختلف، هو واقع عهد المؤسسات المتعددة والمعقدة الذي نعيشه الآن …
——————–
ما فتئ جورج طرابيشي منذ بضع سنوات يتتبع أصحاب المشاريع الفكرية العربية المعاصرة بالتحليل والنقد وإرجاع دعاويهم إلى أصولها والتنبيه إلى غثّها وسمينها (دراسته الضافية لمشروع حسن حنفي من العقيدة للثورة، وكذلك لمشروع الجابري في إعادة بناء العقل العربي…). وها هو ذا يتوقف من جديد عند مواقف بعض المثقفين العرب المعاصرين من إشكالية لا تزال تثير حولها سيولاً من الحبر: المعاصرّة والإرث التراثي، في كتاب جاء أكثر “استفزازاً” وسجالية، بعنوان مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة، صدر عن دار الساقي بلندن سنة 1993، ويحتوي 135 صفحة من الحجم المتوسط.
وقد قسمه ثلاثة أقسام -أو “مذابح نظرية”- تغرّض في أولها للتيار الماركسي، وفي الثاني للتيار القومي، وفي الثالث لما أسماه بالتيار التعلمي، مصدِّراً عرضه بمقدمة قصيرة علل فيها حديثه عن المذبحة التي يقوم بها عينة من المثقفين موضوع الدراسة للتراث. وهي مذبحة لأنها تكشف منذ هزيمة 1967 “عن مأزق الأيديولوجيات الثورية وفشلها” (ص6)، مما يدفع بهؤلاء إلى الارتكاس إلى التراث للصراع حوله وتبني طرف فيه ضد آخر، أو لتحويله إلى فكرانيّة (أيديولوجيا) تراثية خالصة.
وهذه العودة إلى التراث عند العرب محكومة، كما يرى المؤلف، “بجرح نرجسي ذي طبيعة أنثروبولوجية”؛ وهذه العقدة قاسم مشترك يجمعهم ببقية الشعوب غير الغربية. ولكن هذا الجرح يزداد اتساعاً ونزيفاً بحكم الهزيمة العربية أمام المشروع الصهيوني (ص6). ويرى المؤلف أن التراث “المؤدلج” هو في جميع الحالات فاقد للحقيقة التاريخية مهما اختلف الموقع الذي نتعامل منه معه، ومهما اختلفت الأساليب والمناهج المعتمدة في ذلك التعامل. وعلى ذلك يحدد طرابيشي طبيعة اللحظة التي نعيشها بوصفها “لحظة أيديولوجية” بامتياز (ص7).
وتكمن قوة هذا التحديد وقيمته في إطلاقيته وجعله المدار المحرك لكل التحليلات التالية، فهو عند المؤلف حقيقة ثابتة لا تحتمل المساءلة أو المراجعة، وهو البداهة ذاتها، ويتوقف على التسليم بها قبول منتجاتها اللاحقة. وانطلاقاً من هذه القاعدة المؤسسة، يمضي جورج طرابيشي في عرضه وتحليله لمظاهر هذه “المذبحة” عندن ممثلين اختارهم عن التيار الماركسي (توفيق سلوم) …
——————–
يحتل كتاب أسرار العقل الصهيوني موقفاً متميزاً في نسق مؤلفات الدكتور عبد الوهاب المسيري عن اليهودية والصهيونية. فهو كتاب يُعنى أولاً بمسألة الإدراك بوصفه مشكلاً فلسفياً عميقاً، يحتاج من إلى بيان، كما يحتاج إلى دراسة وتحليل معمقين من خلال حالات واقعية سبراً لأغواره واستقصاءً لتحليلاته، وذلك للوصول إلى الغاية الأساسية من المعرفة وهي إدراك أنفسنا إزاء الآخر، كما تستوجب دراسة هذا المشكل تجريد كل أدوات النقد تجنباً للوقوع في مزالق تحويل الآخر لما نريد أن يكون عليه لا كما هو في الواقع. ولقد أتاحت الصهيونية بوصفها شبكة من العلاقات الإدراكية حالة مثالية لفهم الصلة بين الذات والآخر، ولفهم مآلات الصلة بين الإدراك والسلوك كما تجلت في الحركة الصهيونية. وبهذا فالكتاب محاولة عميقة للتنظير؛ لإخراج نماذج قويمة متسلحة بكل أدوات النقد الذاتي لفهم إشكالية الإدراك الإنساني وصلته بالسلوك البشري. وقد سعى المؤلف لتطبيق ذلك الإطار التحليلي على حالة الحركة الصهيونية.
وإذا كانت المؤلفات السابقة للدكتور المسيري قد سعت -على مدى ربع قرن من الزمان- إلى رصد الظاهرة الصهيونية وتحليلها، فإن هذا الكتاب يمثل محاولة للتدبّر في المنهجية التي اتخذت لذلك الرصد والتحليل، وتجريد ذلك الكم الهائل من المعارف حول اليهودية والصهيونية، ومحاولة رؤية النسق الذي صاغ نسيج تلك المعارف. فالكتاب إذن خلاصة فريدة للمنهج الذي اختطه الدكتور المسيري خلال رحلته السابقة في فهم الحركة الصهيونية وربيبتها الدولة العبرية.
وهنا تأتي أهمية هذا الكتاب، إذ إنه محاولة واعية لفهم الآخر، ونقد الذات في فهمها للآخر، ثم الارتقاء إلى مرحلة الوعي للنماذج الإدراكية وموقعها في شبكة الإدراك، وصلته بالسلوك الإنساني. فهو يؤرخ لتلك الرحلة المضنية والشائكة لفهم العقل الصهيوني بعقل يتخذ الإسلام هادياً وموجهاً، ولا يفتعل عداءاً عرقياً غايته إثارة النعرات التي تسلب الآخر إمكانية وجوده على وجهه الحقيقي، ومن ثم تقع في براثن الذاتي التي تتناسل من رحمها المعرفي جملة من الأوهام التي لا صلة لها بالموضوع الذي يجري درسه. ولقد أتاح المدى الزمني الذي طوّر فيه الدكتور المسيري معرفته بحقل الدراسات اليهودية والصهيونية نضجاً ووعياً لمخاطر الانزلاق في الذاتية وتحويل الآخر إلى جملة من الأوهام التي لا صلة لها بمعرفة الآخر معرفة أكمل وأصوب. فهذا السفر يؤرخ لتعقيدات الوعي للآخر، وهمّ التعبير عن ذلك الوعي كما تجلى عبر عشرات الأمثلة والنماذج التي احتواها؛ ويعبر -من جهة أخرى- عن مدى النضج الذي بلغه العقل العربي الإسلامي في التعبير بصدق ووعي عن الآخر المخالف والمساير لنا في العقيدة والوجود …

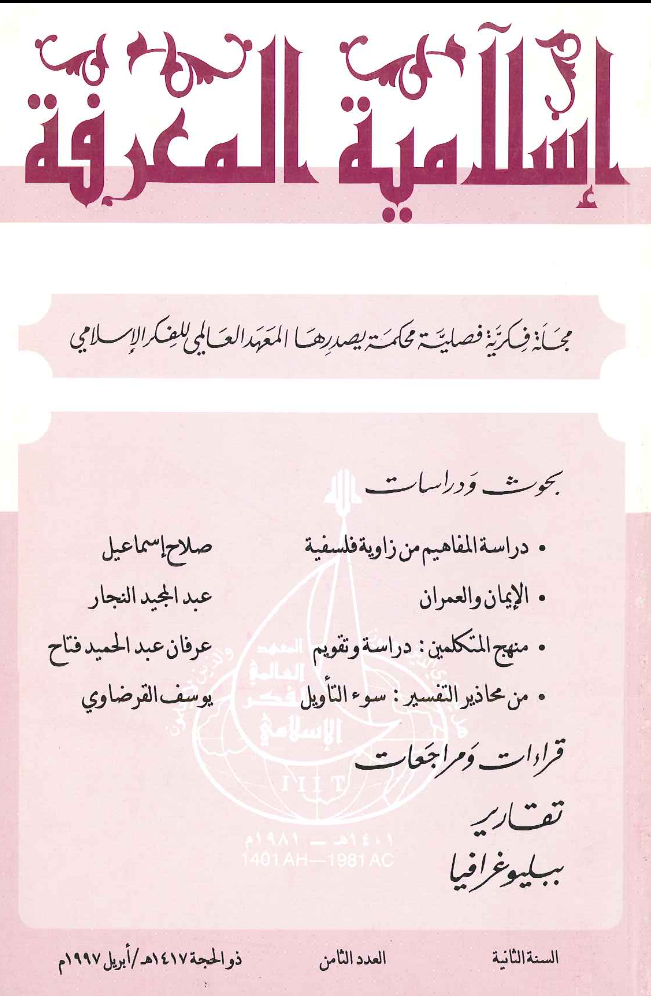
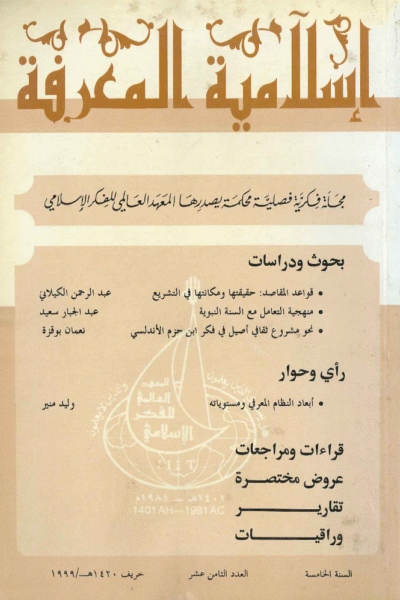
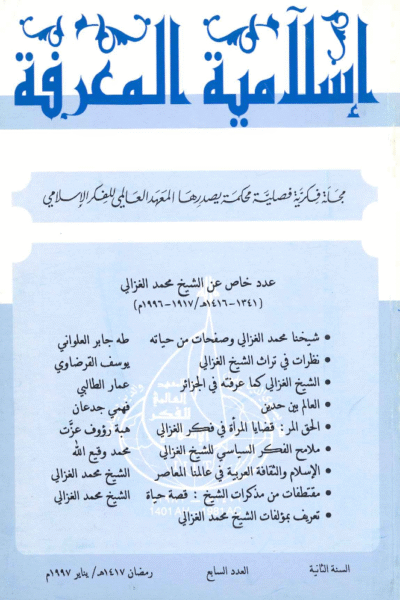
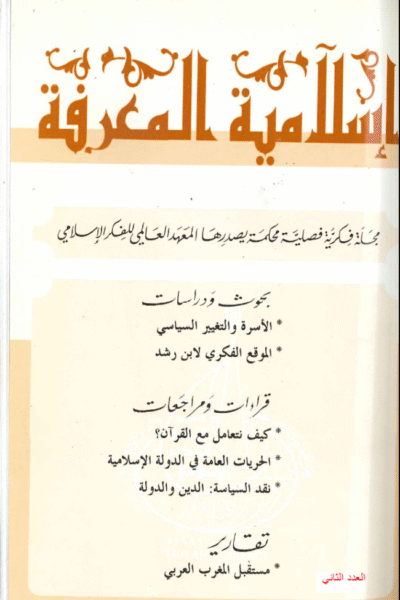
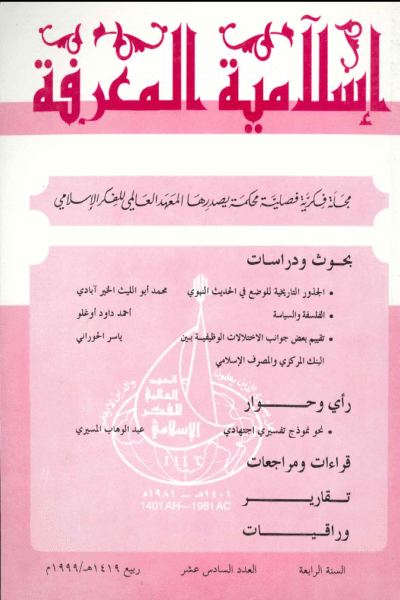
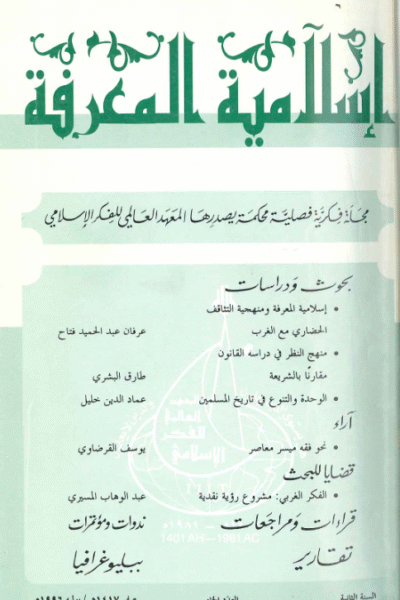
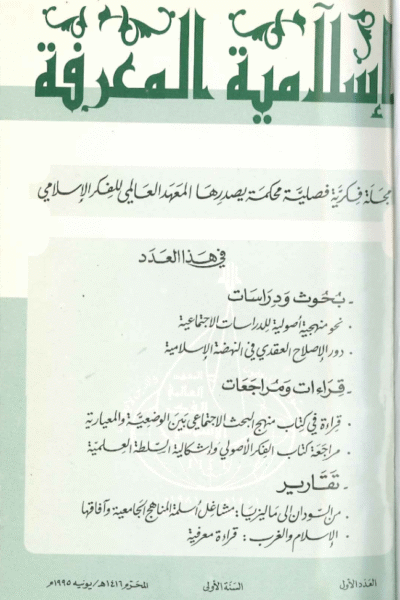
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.