الوصف
الأفكار الأساسية:
-
حقيقة الكليات التشريعية: يوضح الكتاب مفهوم الكليات التشريعية لغة واصطلاحًا، ويبين أنها عبارة عن المبادئ والأصول العامة التي يقوم عليها التشريع الإسلامي.
-
أنواع ومراتب الكليات التشريعية: يقسم الكتاب الكليات التشريعية إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة، مثل أنواعها باعتبار التعريف، وباعتبار استيعاب الأقسام والأبواب والفروع، وباعتبار ما منه استفيدت، وباعتبار قوة الثبوت. كما يوضح أن هذه الكليات ليست على مرتبة واحدة من حيث القوة والأهمية.
-
خصائص الكليات التشريعية: يذكر الكتاب جملة من الخصائص التي تميز الكليات التشريعية، مثل الشرعية، والحاكمية، والقطع، وانتفاء التشابه عنها والنسخ والتخصيص، والتداخل.
-
مكانة الكليات التشريعية في مصادر التشريع: يبين الكتاب مكانة الكليات التشريعية في الكتاب والسنة وفقه الصحابة والمدارس الفقهية المختلفة، وكيف أن هذه المصادر تزخر بالأصول والمبادئ الكلية التي توجه الفهم والاستنباط.
-
وظائف الكليات التشريعية وضوابطها: يشرح الكتاب الوظائف التي تؤديها الكليات التشريعية في الاجتهاد والفتوى، وكيف أنها تساعد المجتهد على فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع المستجدة، ويضع ضوابط منهجية لتوظيف هذه الكليات في العملية الاجتهادية.
-
أثر الكليات التشريعية في الاجتهاد والفتوى: يقدم الكتاب أمثلة تطبيقية عديدة تبين كيف تؤثر الكليات التشريعية في الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نص، وفي المسائل التي لم يرد فيها نص، وكذلك في الفتوى ومراعاة أحوال المستفتين.
تحليل معمق للكتاب:
1. منهجية الكتاب:
-
الكتاب يتبع منهجية علمية واضحة في تناول موضوع الكليات التشريعية، حيث يبدأ بتحديد المفاهيم اللغوية والاصطلاحية، ثم ينتقل إلى تقسيم الكليات وأنواعها وخصائصها، ثم يوضح مكانة الكليات في مصادر التشريع ووظائفها في الاجتهاد والفتوى، وينتهي بتقديم نماذج تطبيقية.
-
المنهجية تجمع بين التنظير والتطبيق، حيث لا يكتفي المؤلف بتقديم الجانب النظري للكليات التشريعية، بل يحرص على بيان أثرها في الاجتهاد والفتوى من خلال أمثلة ونماذج تطبيقية متنوعة.
-
المنهجية تعتمد على الاستقراء والتتبع لأقوال الفقهاء والأصوليين في المذاهب الفقهية المختلفة، مع الحرص على التحليل والمقارنة والترجيح.
2. أهم الأفكار التي يطرحها الكتاب:
-
تأصيل مفهوم الكليات التشريعية: يوضح الكتاب مفهوم الكليات التشريعية بشكل مفصل، ويؤكد على أنها ليست مجرد قواعد فقهية جزئية، بل هي أصول ومبادئ عامة توجه الفهم والاستنباط في الشريعة الإسلامية.
-
بيان أهمية الكليات في الاجتهاد: يبرز الكتاب دور الكليات التشريعية في عملية الاجتهاد، وكيف أنها تساعد المجتهد على فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على النوازل والمستجدات. ويؤكد على أن الاجتهاد الصحيح لا يمكن أن يتم بمعزل عن استيعاب الكليات التشريعية.
-
التأكيد على مرونة الشريعة: يظهر الكتاب كيف أن الكليات التشريعية تساهم في إبراز مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وذلك من خلال قدرتها على استيعاب المتغيرات والمستجدات في حياة الناس.
-
نقد الجمود الفقهي: ينتقد الكتاب النزعة التجزيئية في الفقه والجمود على الفروع الجزئية، ويدعو إلى إحياء المنهج الكلي في الفهم والاستنباط، الذي يربط الجزئيات بالكليات والمقاصد العامة للشريعة.
3. نقاط القوة في الكتاب:
-
الشمولية: الكتاب يغطي جوانب متعددة لموضوع الكليات التشريعية، بدءًا من المفهوم والأنواع والخصائص، وصولًا إلى الوظائف والأثر في الاجتهاد والفتوى.
-
العمق: يتعمق الكتاب في تحليل المسائل الأصولية والفقهية المتعلقة بالكليات التشريعية، ويقدم رؤى قيمة ومفيدة للباحثين والمختصين.
-
التوثيق: يعتمد الكتاب على توثيق دقيق للأقوال والنقول من مصادرها الأصلية، مما يعزز مصداقيته وقيمته العلمية.
-
التطبيق: يحرص الكتاب على تقديم نماذج تطبيقية عديدة توضح أثر الكليات التشريعية في الاجتهاد والفتوى، مما يسهل على القارئ فهم الأفكار النظرية وتطبيقها على الواقع.
4. بعض الملاحظات النقدية المحتملة:
-
الصعوبة النسبية: قد يجد بعض القراء غير المتخصصين صعوبة في فهم بعض المصطلحات والمسائل الأصولية الدقيقة التي يتناولها الكتاب.
-
الإيجاز في بعض المواضع: قد يرى البعض أن الكتاب كان يمكن أن يتوسع في بعض المسائل أو النماذج التطبيقية بشكل أكبر.
5. تقييم عام:
بشكل عام، يعتبر كتاب “الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى” إضافة قيمة للمكتبة الإسلامية، ومساهمة هامة في إحياء المنهج الكلي في الفقه الإسلامي. ويتميز الكتاب بالعمق والشمولية والمنهجية العلمية، ويقدم رؤى قيمة للباحثين والمختصين في الفقه وأصوله.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
-
“يمثل أهمية في ضرورة استيعاب الأساس الفلسفي الذي يصدر عنه التشريع الإسلامي في أحكامه، لغرض فهم جزئياته في ضوء ذلك تحقيقا لمراد الشارع ومقصوده من التكليف” (ص. 13).
-
“ولا يتأتى ذلك في ظل محدودية النصوص الجزئية إلا من خلال العمومات والقياس على القواعد والاستصلاح المرسل وأساس ذلك كله هو الكليات التشريعية، وهو الأمر الذي يحفظ للشريعة صلوحها لكل زمان ومكان” (ص. 14).
-
“فإنّ َ ه طف َّ ف المكيال، ولم يضع الصْن َّ جة وسط كفِة َّ الميزان، وما صدقناه فيه إنّما ُ هو نقطة َ صَد ُ أ من خالص الحديد، ونكتة ٍ سواد في بياض الثوب الجديد” (ص. 21).
-
“التراث الثقافي الكبير الذي خل َّفته الحضارة اإلسالمية للحضارة الحديثة ّ يظل شاهداً على ما كان يت َّصف به الفكر اإلسالمي في عصوره الذهبية” (ص. 22).
-
“وهكذا نجد التشريع اإلسالمي يحمل للمرة األولى في تاريخ التشريع طابع نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية، بينما ال يعدو القانون الروماني أن يكون َّ مجموعة من الملف ٌ قات القانونية العفوية، ليس بينها رباط عقلي” (ص. 22).
-
“إن ّ انتظام الش ٍ ريعة في نسق ٌ تهيمن عليه نظرة ُ شمولية، ومبادئ ُ ج ُ ملية، ومقاصد ّية، أمر ٌ ال يستريب فيه ذو نَ َص َ فة شَدا في دراسة علومها” (ص. 22).
-
“السبب الثالث: إهمال الن َّ ظر إلى مقاصد الشريعة من أحكامها، وهذا موجب ّ تشع ً ب الخالف، سواء كان خالفا ً عاليا ً -أي بين المذاهب،- أم نازال ً -أي في المذهب الواحد…- كان إهمال المقاصد سببا ً كبيرا ً في جمود الفقهاء، ومعوال ً لنقض أحكام نافعة…” (ص. 19).
-
“ومثل ذلك قولك: هذا العالم، وهذا العالم كل العالم، إنّما أراد أنّه ِ ُّ م حق العالم،” (ص. 30).
-
“وأن المقصود بـ”الكل ّية” حتى اآلن ما يشمل اإلطالقات العشر السابق ذكرها، فلم ُ ننتخب منها بعد ّ ما ينطبق عليه وصف: “التشريعية”” (ص. 40).
-
“ومن المهم ّ أن أستعجل ههنا التنبيه على أن الكل ّية ال ينبغي أن تكون معياراً ّ إلنتاج التشريع حتى تكون نصية قطعية، أو معنوية استقرائية قطعية، أو قريبة ّ بحيث تغلب على الظن غلبة قوية” (ص. 41).
-
“وال يقال: هؤالء صحابة رسول اهلل ّ ، وهم أعلم الناس بالشرع، وقد أجروا ّ عمومات النصوص على الحقيقة اللغوية، ألن التفاوت بينهم في العلم باالستعمال ِ من العرب في فهمه كالقديم العهد” (ص. 163).
-
“إن ّ لهذا التقصير مقد ّ مات، أهم ّ ها فيما يهمنا إغفال النظر في الكل ّيات التشريعية، وإهمال ُ إيقاعها في موقع الهيمنة والحاكمية المثبت َة في بحثنا عن الخصائص، والولوع بأخذ األدل ّة أخذاً ّ أوليا ً ظاهريا ً مستسه ًال بإطالق” (ص. 175).
-
“فالعالم من يتوصل ّ بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اهلل ورسوله…” (ص. 211).
-
“لنا أن نتصو ّ ر الش َّ لل التام الذي يصيب قطاعات ّ الحياة كلها لو قيل بسلب ثمنيتها مر َّة واحدة من غير تدر ُّ ج وال مقدمات، وال ُمستعاض به عنها” (ص. 228, 229).
-
“ّ يعد ّ تراثنا األصولي من أبدع ما أنتج العقل البشري عبر التاريخ، وهو بحق ّ مفخرة من مفاخر هذه األم ّ ة؛ إذ ال نظير له عند أمة من األمم، لكن مع ذلك فالعمل البشري يعتريه النقصان، وتشوبه األخالل، ويأبى اهلل العصمة لكتاب غير كتابه، ولرجال غير أنبيائه ورسله” (ص. 231, 232).
-
“يحمل ُ هذا العل َم من كل ِّ خلف ٍ عدول ُ َ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبط ّلين، وتأويل الجاهلين” (ص. 332).
-
“والضمان، فاألولى ال ُ ستوفى منها الحق، والثانية: ممنوعة، ألنّه ال يلزم حبس َّ هن إلى أن يؤد ّ ي، وهو غير معلوم، فيؤدي إلى حبسه أبدا،ً فلم يبق غير الر ُّ عرف، وفيه ضرر ٌ عظيم ٌ رافع ُ ألصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها” (ص. 375, 376).
-
“إن ّ اهلل سبحانه لم يجعل طرق األحكام نصا ً ّ يختص به العلماء، ليرفع اهلل تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا جعله مظنونا ّ العلم درجات، ويتصر ّف المجتهدون في مسالك الن َّ ظر، فيدرك بعضهم الصواب، ِّ فيؤجر عشرة أجور، ويقصر آخر فيدرك أجراً واحدا،ً وتنفذ األحكام الدنيوية على ما أراد اهلل سبحانه، وهذا بي ٌّن للعلماء” (ص. 401).
-
“وسياقه يدل على أنها تسافر وحدها؛ إذ المقصود بيان مبلغ الأمن الوافر والشائع على الطريق من قطع السبيل الذي شكاه السائل، وليس بيان الأمن العادي؛ إذ الأمن العادي يت َّ فق حصوله في أي وقت، وال يدل ُّ على وفور الأمن الشائع سفر ُ ها مع محرم، فذلك أمن عادي، بل سفر ُ ها وحدها، وال…” (ص. 493, 494).
-
“إن َّ مستقبل االجتهاد الفقهي مرتهن ّ بالتفقه في الكل ّيات التشريعية، فإن ّ الطوارئ والنوازل والمستجدات التي ال نظير لها في الجزئيات تتكاثر يوما ً بعد يوم، وال سبيل للوفاء بأحكامها إال من خالل المنطوق بحكمها ِّ ّ يات الشريعة” (ص. 517).
الخاتمة:
للقراءة والتحميل

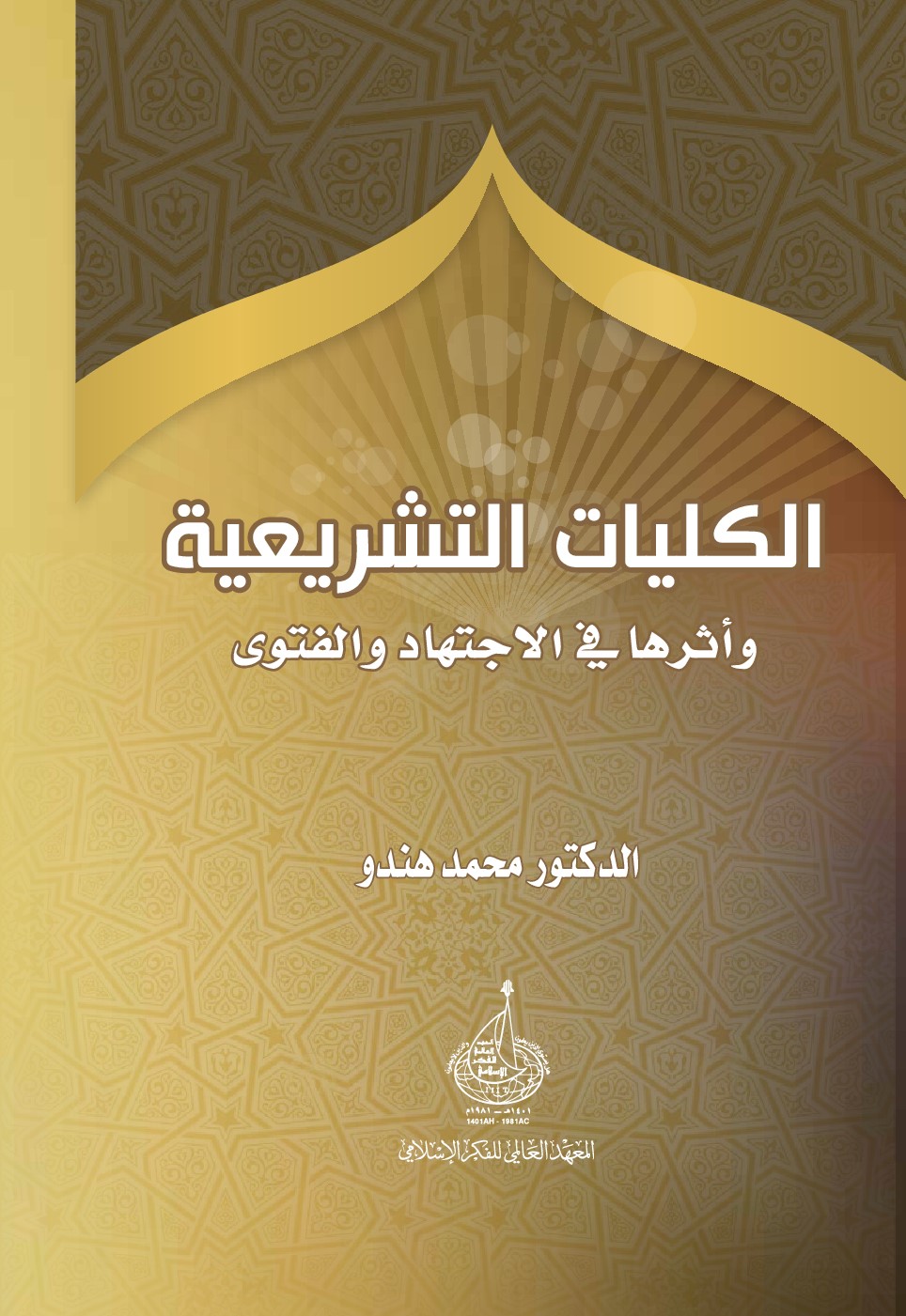

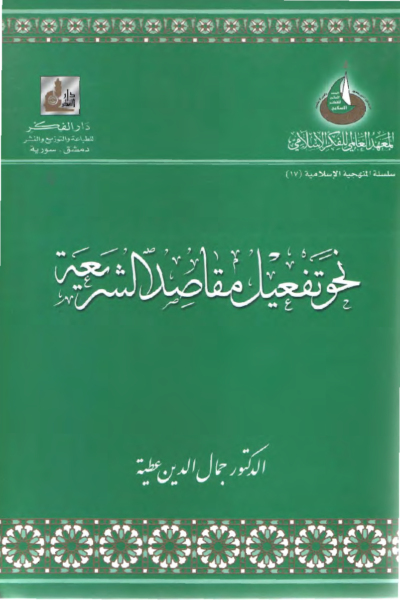
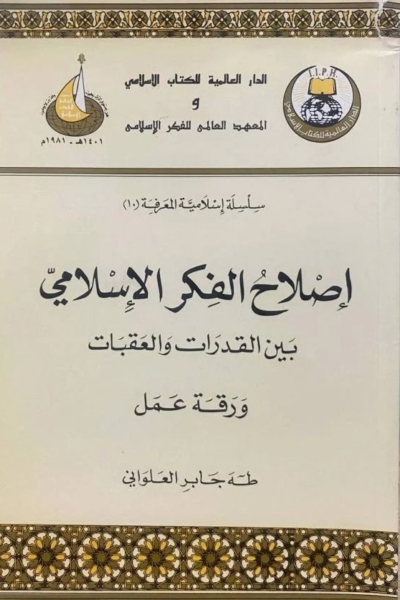
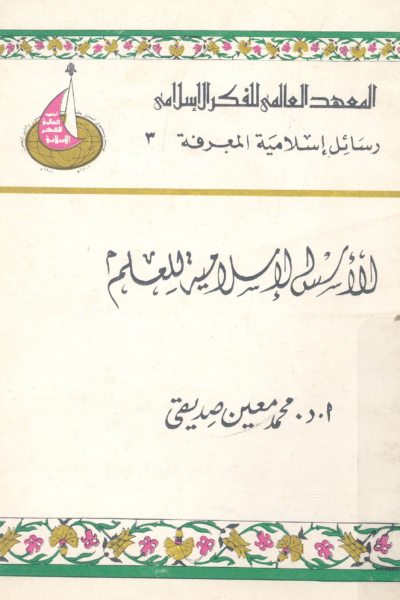
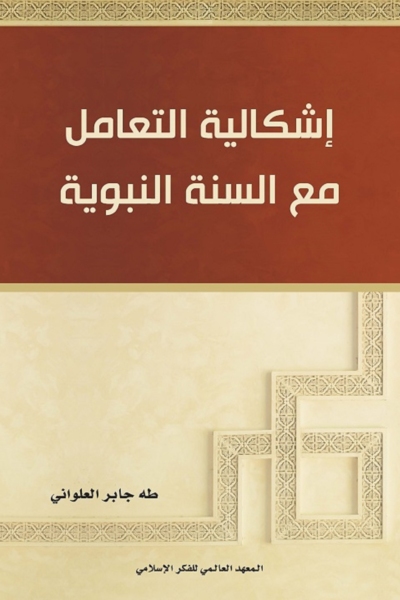

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.