الوصف
الأفكار الأساسية للكتاب:
- المنهجية بين الوسائل والمقاصد:
- المنهجية وسيلة وليست غاية، ولا توصف بـ”الإسلامية” لأنها أدوات عامة، لكنها تُصاغ وفق النموذج المعرفي الإسلامي.
- مثال: ص 9: “المنهجية لا توصف بالإسلامية لأنها بحث في الوسائل… وصف الإسلامية ينبغي أن يوسم به النموذج المعرفي”.
- الفرق بين المنهج والمنهجية:
- المنهجية (Methodology) هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المناهج، بينما المنهج (Method) هو الأداة التطبيقية.
- ص 10: “المنهجية هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المناهج… أما المنهج فهو الوسائل والطرائق”.
- المنهجية في التراث الإسلامي:
- قدم العلماء المسلمون (مثل ابن الهيثم والبيروني) مناهج استقرائية وتجريبية متقدمة.
- ص 22: “ابن الهيثم استخدم المنهج التجريبي الاستقرائي… مما أدى إلى كشوف ثورية”.
- أزمة المنهج في العلوم الإنسانية:
- العلوم الاجتماعية تعاني من انفصال بين التنظير العلمي والتنظير الإبستمولوجي.
- ص 12: “العلوم الاجتماعية بين التنظير العلمي والتنظير الإبستمولوجي”.
- ضرورة المنهجية الإسلامية:
- يجب تأسيس مناهج بحثية تعكس الرؤية الإسلامية للوجود، مثل الربط بين الوحي والعقل.
- ص 13: “بناء منهجية نابعة من النموذج المعرفي الإسلامي يتطلب دراسة مناهج التراث الإسلامي”.
- التكامل بين الفلسفة والإجراءات:
- المنهجية تتكون من فلسفة (رؤية معرفية) وإجراءات (أدوات تطبيقية).
- ص 12: “المنهجية فلسفة وإجراءات… الفلسفة تكمن في النموذج المعرفي”.
- نقد المناهج الغربية:
- المناهج الوضعية تهمل البعد الغيبي وتفصل بين العلم والقيم.
- ص 15: “العلوم الاجتماعية الغربية تحمل فلسفة مادية تخالف التصور الإسلامي”.
- دور القرآن في صياغة المنهج:
- القرآن يحث على الملاحظة والتجربة والاستدلال العقلي.
- ص 33: “القرآن وجه العقل إلى التدبر والملاحظة… كما في قصة إبراهيم عليه السلام”..
تحليل معمق للكتاب:
1. الإطار النظري والمنهجي للكتاب
يقدم الكتاب رؤية نقدية وتأسيسية للمنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية، مع التركيز على:
- النقد الإبستمولوجي: تفكيك المناهج الغربية الوضعية (كالوضعية المنطقية والتجريبية) وكشف اختزاليّتها، خاصة في فصلها بين “الموضوعية” و”القيم”.
- التأسيس الإسلامي: بناء نموذج منهجي مستمد من القرآن والسنة والتراث العلمي الإسلامي (مثل استقراء ابن الهيثم واستدلال الأصوليين).
- التكامل المعرفي: رفض الثنائيات الزائفة (كالعقل/النقل، العلم/الدين)، وطرح رؤية شمولية تجمع بين الوحي والعقل والتجربة.
2. المحاور الرئيسية للكتاب
أ. إشكالية المنهجية بين الخصوصية والعالمية
- الخلاف حول “إسلامية” المنهج:
- فريق يرى أن المنهجية أدوات محايدة (كالتجربة والاستقراء) ولا دخل للدين بها.
- الفريق الآخر (الذي يؤيده الكتاب) يرى أن المنهجية تُصاغ ضمن “النموذج المعرفي الإسلامي”، الذي يحدد مسلّماته (كالتوحيد، الربط بين الشهادة والغيب).
- الاقتباس الداعم:
“المنهجية لا توصف بالإسلامية لأنها بحث في الوسائل… لكن النموذج المعرفي الإسلامي هو الذي يوجهها” (ص 9).
ب. التراث العلمي الإسلامي كنموذج
- إنجازات علماء المسلمين:
- ابن الهيثم: أسس المنهج التجريبي في البصريات، وربط بين الرياضيات والملاحظة.
- البيروني: طوّر قياس محيط الأرض باستخدام الهندسة وحساب المثلثات.
- جابر بن حيان: أدخل القياس الكمي في الكيمياء عبر “نظرية الميزان”.
- الاقتباس الداعم:
“العلماء المسلمون لم ينقلوا التراث اليوناني فحسب، بل صححوه وأضافوا إليه منهجية نقدية” (ص 22).
ج. أزمة العلوم الاجتماعية المعاصرة
- النقد الموجه للمناهج الغربية:
- اختزال الإنسان: تحويله إلى كائن مادي (كالسلوكية) أو اقتصادي (كالماركسية).
- إقصاء الغيب: تجاهل البعد الروحي والمعنوي في التحليل الاجتماعي.
- الحياد الزائف: ادعاء الموضوعية بينما المناهج تحمل فلسفات مادية (كالداروينية).
- الاقتباس الداعم:
“العلوم الاجتماعية الغربية تعاني من انفصام بين التنظير العلمي والتنظير الإبستمولوجي” (ص 12).
د. نحو منهجية إسلامية
- مقومات المنهج الإسلامي:
- الربط بين الوحي والعقل: الاستدلال بالقرآن والسنة ثم الملاحظة والتجربة.
- التكامل بين العلوم: رفض التخصصات المنعزلة (كفصل الأخلاق عن الاقتصاد).
- الغائية: البحث عن الحكمة من الظواهر، لا فقط تفسيرها آليًا.
- الاقتباس الداعم:
“المنهجية الإسلامية تجمع بين الفلسفة (الرؤية الكونية) والإجراءات (الأدوات)” (ص 12).
3. منهجية الكتاب وأسلوبه
- التحليل التاريخي: تتبع تطور المنهجية من التراث الإسلامي إلى الحداثة.
- المقارنة النقدية: موازنة بين المناهج الإسلامية والغربية (مثل مقارنة استقراء ابن الهيثم باستقراء بيكون).
- الربط بين التنظير والتطبيق: تقديم نماذج عملية (كمنهج البيروني في الفلك).
4. نقاط القوة
- الأصالة: تأصيل المفاهيم (كـ”المنهجية”) من التراث الإسلامي، لا مجرد نقلها عن الغرب.
- الشمولية: تغطية مجالات متعددة (العلوم الطبيعية، الاجتماعية، الفلسفة).
- النقد البنّاء: تجاوز نقد الغرب إلى طرح بدائل منهجية.
5. نقاط الضعف
- العمومية: بعض الأفكار تحتاج إلى تفصيل أكبر (ككيفية تطبيق المنهجية الإسلامية اليوم).
- قلة الأمثلة المعاصرة: التركيز على التراث دون توظيف كافٍ لتجارب حديثة.
6. الخلاصة والتقييم
الكتاب يُعدّ مرجعًا أساسيًا في:
- نقد الحداثة الغربية وكشف اختزالاتها المنهجية.
- التأسيس لنموذج إسلامي في البحث العلمي، قائم على التوحيد والتكامل.
- تحفيز البحوث المعاصرة لاستلهام التراث وتجديده.
التقييم النهائي: 4.5/5
(يحتاج إلى مزيد من التطبيقات العملية ليكون دليلًا منهجيًا شاملاً).
ملاحظة: هذا التحليل يعكس الرؤية المركزية للكتاب، مع إبراز إسهاماته الفريدة في حقل “أسلمة المعرفة”.
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع التوثيق:
- ص 9: “المنهجية لا توصف بالإسلامية لأنها بحث في الوسائل… أما وصف الإسلامية فينبغي أن يوسم به النموذج المعرفي”.
- ص 10: “المنهجية هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المناهج واختبارها”.
- ص 11: “العلم يُحدد بمنهجه لا بموضوعه”.
- ص 12: “المنهجية فلسفة وإجراءات… الفلسفة تكمن في النموذج المعرفي”.
- ص 13: “بناء منهجية إسلامية يتطلب دراسة مناهج التراث الإسلامي”.
- ص 17: “ابن الهيثم قدم نظرية الضوء باستخدام المنهج التجريبي”.
- ص 22: “العلم الإسلامي استند إلى الملاحظة والتجربة والغرض العلمي”.
- ص 23: “التراجع الزمني المعرفي يعني فهم الماضي في ضوء الحاضر”.
- ص 25: “التصنيف المؤقت للعلوم ضروري لفهم تطورها”.
- ص 30: “ابن خلدون رأى أن التاريخ جزء من فلسفة العلم”.
- ص 33: “القرآن وجه العقل إلى التدبر والاستدلال”.
- ص 34: “جابر بن حيان طبق الميزان الكمي في الكيمياء”.
- ص 37: “المسلمون اخترعوا الصفر ونظام الترقيم العشري”.
- ص 40: “الكاشي ابتكر الكسور العشرية قبل أوروبا بقرون”.
- ص 42: “الخوارزمي وضع أسس الجبر والهندسة التحليلية”.
- ص 50: “الخازن حسب الضغط الجوي قبل تورشيلي”.
- ص 55: “ابن الهيثم استخدم الرياضيات في تفسير انعكاس الضوء”.
- ص 60: “البيروني أثبت كروية الأرض وحسب محيطها”.
- ص 67: “المنهج العلمي الإسلامي يجمع بين الإيمان والعلم”.
- ص 72: “إسلامية المنهج ضرورة حضارية لمواجهة المادية الغربية”.

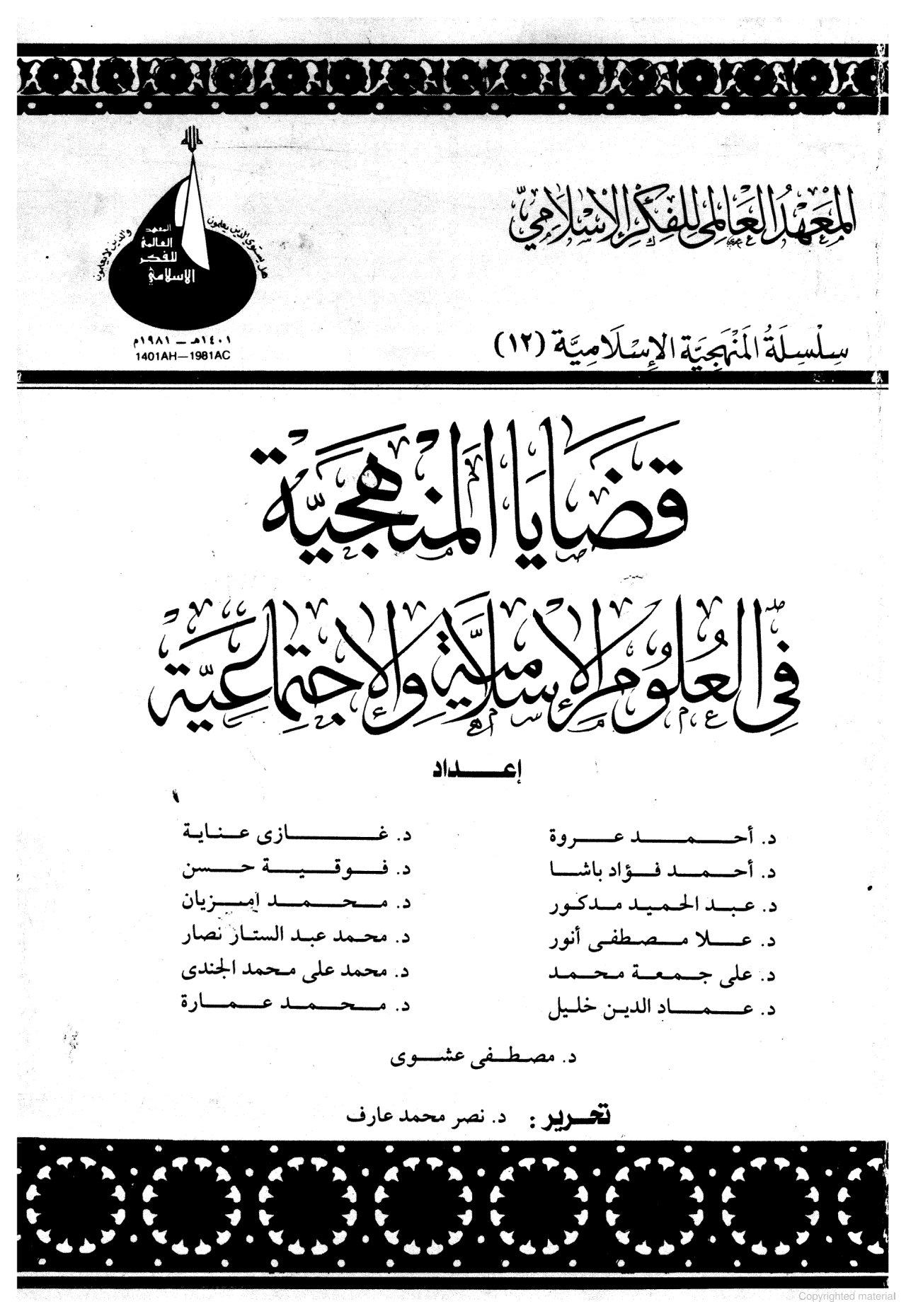

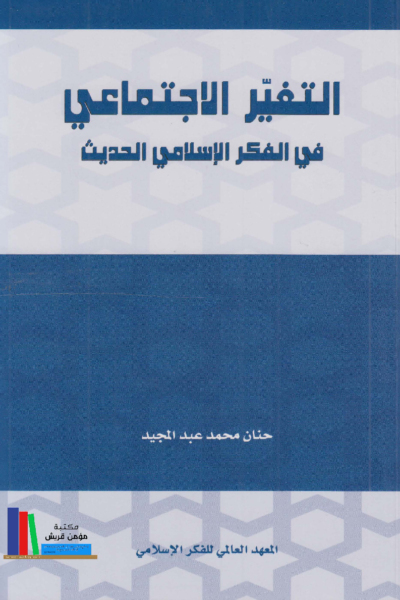
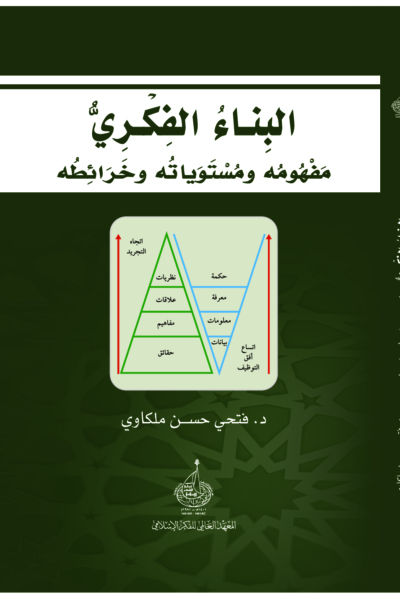
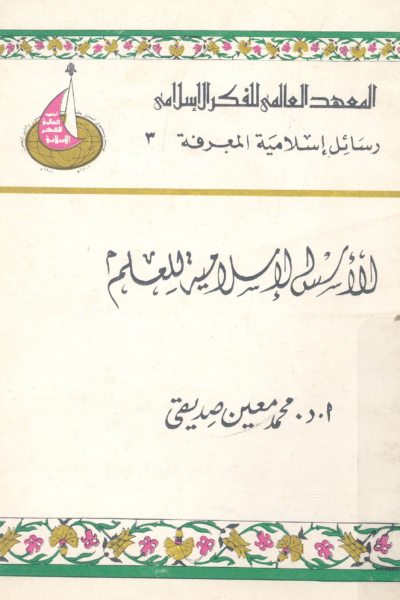
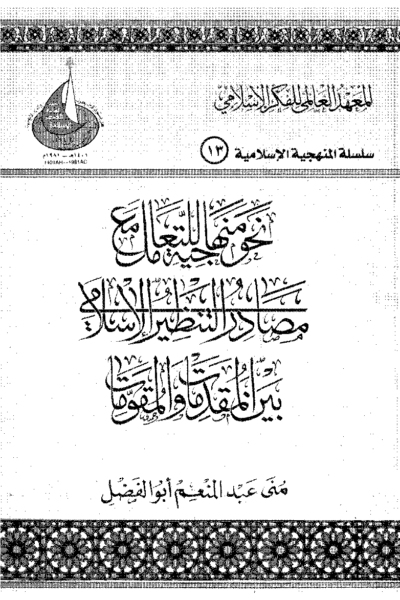
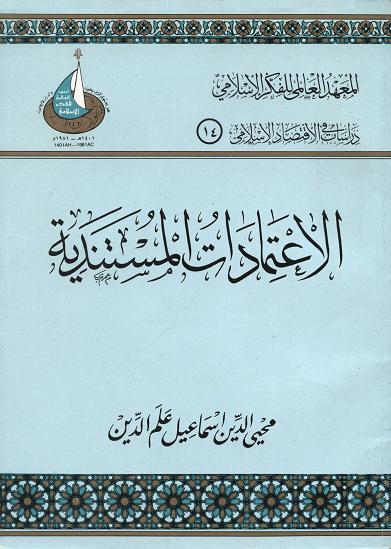
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.