الوصف
الأفكار الأساسية:
-
توظيف التاريخ لأغراض تحليلية: الهدف ليس سرد الأحداث، بل استخدام التاريخ لفهم الأنماط الكلية والتحولات الكبرى في النظام الدولي الإسلامي وتفاعله مع الأنظمة الأخرى.
-
نقد المنظور الغربي: يؤكد الكتاب على قصور المنظور الغربي السائد في علم العلاقات الدولية، الذي يتجاهل التجربة الإسلامية أو يقدمها من خلال عدسة المركزية الأوروبية.
-
مقاربة النظم الدولية: يقترح الإطار النظري الأمثل لدراسة الظاهرة هو “تحليل النظم الدولية”، لكونه إطارًا كليًا يتوافق مع الرؤية الإسلامية الشمولية للظواهر الاجتماعية.
-
إشكاليات المصادر: يناقش الكتاب بإسهاب المشكلات المنهجية والمضمونية في مصادر التاريخ الإسلامي (الأصلية والثانوية) وكيفية التعامل معها لخدمة أهداف البحث السياسي.
-
الجمع بين التحليل الأصولي والتحليل التاريخي: يسعى إلى ربط النظرية الإسلامية (الأصول) بالممارسة التاريخية، والبحث في أسباب الفجوة بينهما وتفسيرها تفسيرًا إسلاميًا.
-
ضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ: يخلص إلى ضرورة الالتزام بضوابط التفسير الإسلامي للتاريخ كمنظار عام لفهم مسار الأحداث ونقاط التحول، بعيدًا عن التفسيرات المادية أو العلمانية.
تحليل معمق للكتاب:
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
-
“هدف هذا الجزء من المشروع من وراء التعامل مع والاهتمام بالتاريخ الإسلامي إنما هو هدف مركب، فهناك هدف محوري ثابت تكمن في خلفيته أهداف أخرى مكملة غير مباشرة.” (الصفحة 9)
-
“الهدف المحوري هو: تحديد وضع الدولة الإسلامية في خريطة وهيكل توزيع القوى العالمية في فترات متتالية من التطور التاريخي للنظام الدولي.” (الصفحة 9)
-
“نقترب مما قدمه لنا التاريخ بإطار نظري مختلف عن أطره التقليدية حتى نخرج بأسلوب كتابة في تاريخ سلوك الفاعلين كل على انفراد ونصل إلى إطار كلي واضح.” (الصفحة 9)
-
“التاريخ هو المعمل الكبير الذي دارت في نطاقه الحركة الدولية.” (الصفحة 20)
-
“اقتصار الأدبيات الغربية على خبرة وتاريخ النظام الأوروبي وخاصة منذ ويستفاليا… والقرون العشرة الأولى من التاريخ الإسلامي لم يتم تناولها بواسطة هذه الأدبيات.” (الصفحة 28)
-
“منطقة الفراغ التي تمثل مجالاً لاجتهاد دارسي العلوم السياسية الإسلامي هي دراسة التاريخ السياسي الإسلامي الدولي… باستخدام أدوات التحليل النظامية.” (الصفحة 29)
-
“الفجوة بين ما أطلقته ‘النظرية الإسلامية’ أو ‘المنظور القياسي الإسلامي’… وبين ممارسات المسلمين عبر التاريخ الإسلامي.” (الصفحة 31)
-
“المنظور الإسلامي الصحيح لا يمكن أن يصل إلى تجاوز وجود الإسلام ذاته تحت تأثير الممارسة الإسلامية العملية.” (الصفحة 34)
-
“طبيعة جوهر تحليل النظم (أو مقاربة النظم بصفة عامة) تعد تعبيراً عن نزعة في الفكر تعرف بالكليات وعدم انفصال الأبعاد المختلفة للظواهر الاجتماعية.” (الصفحة 43)
-
“هذا المنظور يعكس طبيعة الإسلام باعتباره كلاً لا تقطع قواعده وشبكاته وأسسه مختلف أبعاد الكون في ارتباطاتها.” (الصفحة 43)
-
“يواجه الباحث السياسي الذي يهتم بالتاريخ… مشكلات منهجية متنوعة وخاصة عند التعامل مع المصادر الأصلية.” (الصفحة 49)
-
“مضمون هذه المصادر إنما يمثل ذخائر علمية نفسية يتوقف تعامل معها لتقديم نتائج تحليلية تحقق أهدافها.” (الصفحة 50)
-
“غياب العصر التركي في الساحة العلمية العربية وغياب العصر العربي في الساحة العلمية التركية مما أدى إلى حالة من اللاستقلالية.” (الصفحة 51، يشير إلى إشكالية دراسة العصر العثماني)
-
“كانت كتب التاريخ العامة… هي التي ستحوز اهتمامنا بالأساس.” (الصفحة 63)
-
“أنواع الكتابة التاريخية إنما تتطور تحت تأثير التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية.” (الصفحة 64)
-
“الدعوة إلى تقديم عروض تاريخية متوازنة زمنياً بين ما كان يجري في مرحلة ما من مراحل التاريخ الإسلامي وما كان العالم الخارجي يشهده من أحداث.” (الصفحة 71)
-
“منظور هذا الجزء من المشروع يريد أن يعالج مشاكل منظور الطرف الآخر والذي ظهر في مجالات متعددة.” (الصفحة 90)
-
“التفسير الإسلامي للتاريخ يعد الخيار الأهم والأولى ما يتطلبه هذا التحليل النظامي من ضوابط منهجية إسلامية.” (الصفحة 95)
-
“البحث في الأنماط السلوكية… يثير بدوره كل أبعاد ما يسمى ‘العلاقة بين النظرية والتطبيق في الإسلام’.” (الصفحة 93)
-
“التطور الذي حدث في درجة اندماج العالم الإسلامي في النظام الدولي ومدى اعتراف وحدات هذا العالم وقبول الأسس ومبادئ هذا النظام.” (الصفحة 92)
الخاتمة:
للقراءة والتحميل

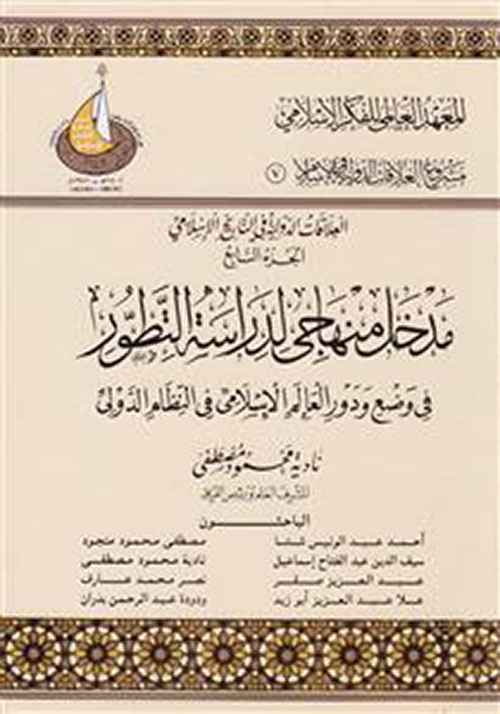


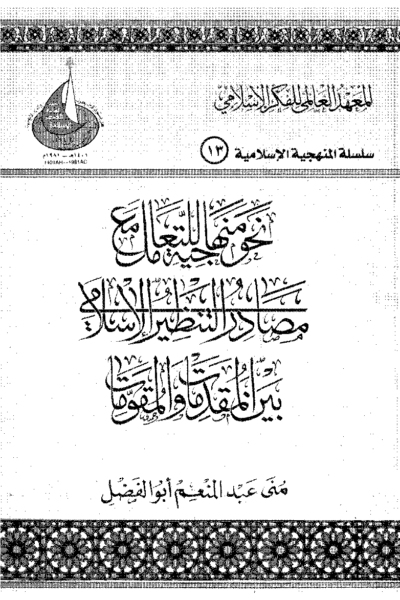
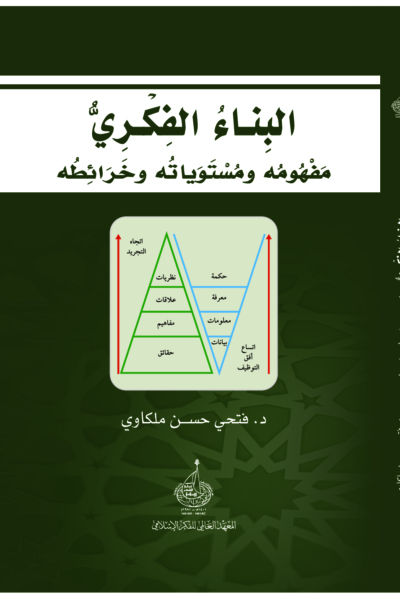


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.