الوصف
الأفكار الأساسية:
- الخلافات الداخلية مصدر ضعف متكرر: الخلافات الداخلية كانت عاملاً مهدداً لوجود ومكانة الدولة في التاريخ الإسلامي، وأدت إلى انشغال المسلمين عن تثبيت فتوحاتهم.
- استراتيجية الهجوم كدفاع: اعتمدت الدولة الأموية سياسة خارجية مبنية على أن خير وسيلة لمواجهة الخطر القادم من الدول غير الإسلامية هي الهجوم وليس الدفاع.
- الهدف الأسمى لتغيير النظام الدولي: كان الهدف النهائي هو تغيير شكل النظام الدولي الثنائي (فارسي/بيزنطي) إلى نظام تكون فيه الدولة الأموية هي القطب الإسلامي الوحيد والمسيطر.
- البيئة البحرية ودورها في السياسة: كانت القوة البحرية البيزنطية وتهديداتها عاملاً محورياً في تبني معاوية سياسة هجوم بحري مستمر على جزر المتوسط وشواطئ الروم.
- الانحسار والانهيار: بدأ انحسار حركة الفتوحات الكبرى وانهيار الدولة الأموية بسبب الانقسامات القبلية والصراع على السلطة وتغليب المصالح الشخصية على المصالح العليا للأمة.
تحليل معمق للكتاب:
أهم 20 اقتباسًا من الكتاب مع توثيق الموضع:
(1) “وهذه السلبية سوف تصبح نمطاً يتكرر مرات عديدة في التاريخ الإسلامي، فأضحت الخلافات الداخلية عاملاً مهدداً لوجود ومكانة الدولة خاصة في لحظات الضعف.” ١٠
(2) “فعام ٤١هـ من الهجرة يعتبر نقطة تحول خطيرة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة وفي تاريخ العلاقات الدولية بصفة خاصة.” ١٠
(3) “لقد أثبت خلفاء بني أمية أنهم على قدر عال من الاقتناع بسياسة رسول الله الخارجية…” ١٠
(4) “فالدولة الأموية استوعبت حجم وطبيعة الخطر القادم من الدول غير الإسلامية على الإسلام وآمنت أن خير وسيلة لمواجهة هذا الخطر هى الهجوم وليس الدفاع.” ١٠
(5) “أما غايتها النهائية من تعاملها الخارجي فكان حمل راية الإسلام إلى أرجاء العالم القديم كله…” ١٠
(6) “النظام الدولى السابق على ظهور الدولة الإسلامية كان نظاماً ثنائى الأقطاب تتنازعه الدولتان الفارسية والبيزنطية…” ١٠
(7) “فالمحور الأساسي الذي ميز العصر الأموي هو: وجود فاعل إسلامي واحد هو الدولة الأموية وانعدام وجود أنساق إسلامية فرعية…” ١١
(8) “هكذا بدا الخطر البيزنطي أقاليم الشام براً وبحراً، ووقع عبء بمواجهة هذا الخطر في معظم الوقت على معاوية بن أبى سفيان والى الشام…” ١٥
(9) “خير وسيلة لمواجهة الأخطار الخارجية هو الهجوم وليس الدفاع.” ١٦
(10) “دمشق القريبة من الحدود البيزنطية جعلت وجهة الدولة الإسلامية شاخصاً إلى الغرب حيث بدأت سياسة توسع إسلامي كبرى في هذا الاتجاه…” ١٧
(11) “ولعل قوة البيزنطيين البحرية كانت السبب المحورى فى تبنى سياسة معاوية سياسة الهجوم نحو وسيلة للدفاع واقتناعه بضرورة الغزو نحو الشام الساحلية المستمر لغزوات الروم البحرية.” ١٩
(12) “أن الدولة الأموية اهتمت من أجل صراعها مع الروم في آسيا الصغرى بالثغور الشامية واعتبرتها وظيفة الثغور جزءاً أساسياً في حماية الدولة الإسلامية…” ٢٣
(13) “ومن العوامل الهامة التي شجعت معاوية على الإسراع بمحاولة إسقاط القسطنطينية هو شعوره بأن الظروف الداخلية في الإمبراطورية مرتدية بصورة قد تجعل إسقاط العاصمة يسير ببطء…” ٢٥
(14) “إن حملة القسطنطينية الأولى التي قام بها معاوية أدت إلى فشل في فتح القسطنطينية ولكنها حققت نجاحات أخرى…” ٢٦
(15) “فالدولة الأموية كانت قد بلغت ذروة مجدها الحربي وقوتها العسكرية، ذلك في الوقت الذي كانت تعانى فيه الإمبراطورية البيزنطية من فوضى مدمرة بسبب الصراع على العرش…” ٣٢
(16) “كان هدف الحملة العسكرية الكبرى التي وجهها مسلمة بن عبد الملك للقسطنطينية (٩٨-٩٩ هـ / ٧١٦-٧١٧ م) هو إحداث نقلة تحول خطيرة في تاريخ علاقات المسلمين بغير المسلمين.” ٣٢
(17) “كانت مسألة تمكين المسلمين من السيادة على البحر المتوسط الشرقي هو شغل معاوية الشاغل منذ أن كان والياً على الشام في خلافة عمر بن الخطاب…” ٣٦
(18) “كما أدت أحداث الانقسامات والفتن الداخلية من ٦٠ – ٧٢ هـ على الغزو والفتح على الجبهة الغربية بمحاورها الثلاثة فأنها أثرت على الجبهة الشرقية أيضاً حيث أصبح المسلمون هناك في موقف دفاعي مهين…” ٤٩
(19) “وهكذا نجد أن الخلافات الداخلية كانت سبباً في تعطيل حركة الفتوحات على كل الجبهات.” ٥٠
(20) “وكانت بداية النهاية للدولة الأموية حيث سيسمح ضرب القبائل ببعضها بعضاً وخسارة السيطرة على بعض الأقاليم… وبصيراً حائداً فيها من أجل الصالح العام لأمة الإسلام.” ٥٤
ملخص الكتاب
يرصد الكتاب المشهد الدولي في فترة ظهور الإسلام، حيث كان النظام ثنائي القطبية (البيزنطي والفارسي)، وكيف نجح المسلمون في وثبتهم الأولى (الراشدين) في إزاحة الفرس وتقويض أجزاء من نفوذ البيزنطيين. بعد مرحلة “الفتنة” والصراعات الداخلية، نجح معاوية بن أبي سفيان في تأسيس الدولة الأموية عام ٤١ هـ كقوة استأنفت حركة الفتوحات باكتساح أرجاء العالم القديم.
وينقسم تحليل العلاقات الدولية الأموية إلى فصلين رئيسيين:
- الفصل الأول: مرحلة المد والازدهار (٤١ – ١٠٠ هـ):
- يُركز على بناء هيكل سياسة التعامل الدولي الأموي القائم على مبدأ الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، وأن الغاية القصوى هي حمل راية الإسلام إلى العالم أجمع.
- يُفصّل المد الإسلامي في الجبهة الغربية (بلاد الروم، جزر المتوسط، شمال أفريقيا، وتمهيد لفتح الأندلس)، والجبهة الشرقية (بلاد ما وراء النهر والسند).
- الفصل الثاني: مرحلة الانحسار والتحولات (ما بعد ١٠٠ هـ):
- يُحلل التحولات في البيئتين الداخلية والخارجية التي أدت إلى انحسار حركة المد والجزر.
- يُبرز كيف أثرت الخلافات الداخلية (مثل فتنة عثمان وحروب علي ومعاوية، وفتنة ابن الزبير) سلبياً على قدرة الدولة على تثبيت الفتوحات ونشر الدعوة.
- يُرصد الانحسار على الجبهة الغربية (البيزنطية والأوروبية) والشرقية، ويخلص إلى أن الانحسار كان مرتبطاً بتغليب المصالح الشخصية والصراعات القبلية على المصلحة العامة للإسلام، مما أدى في النهاية إلى انهيار الدولة.
للقراءة والتحميل

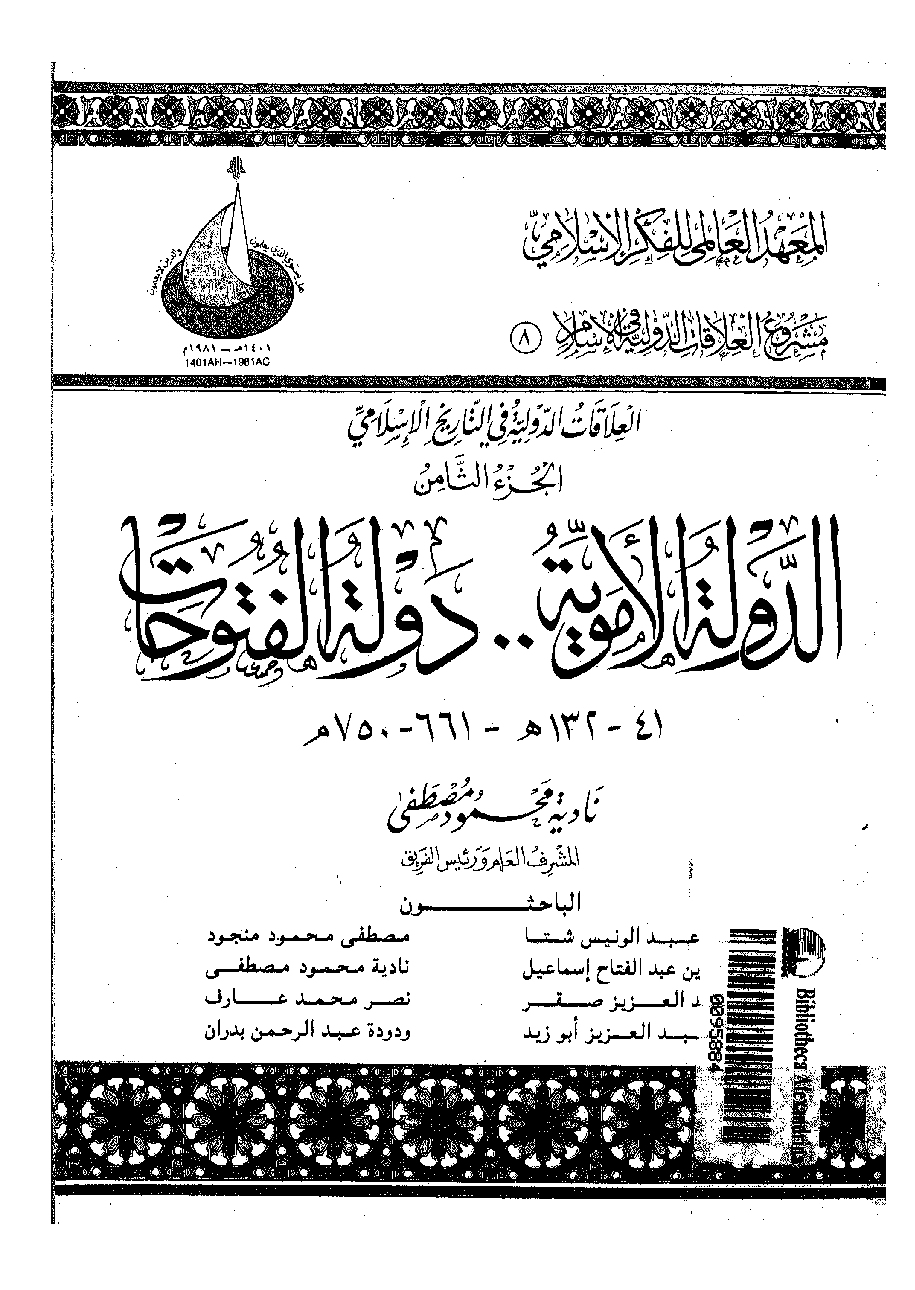
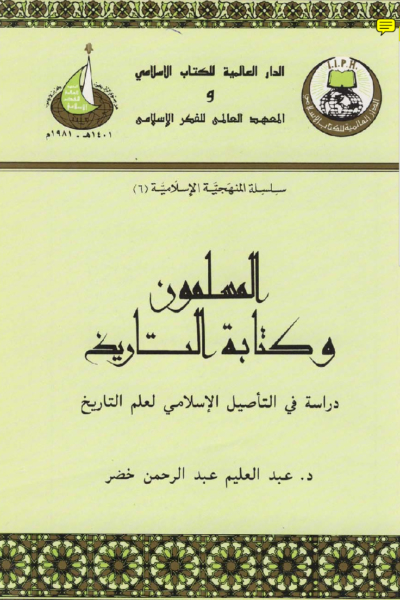
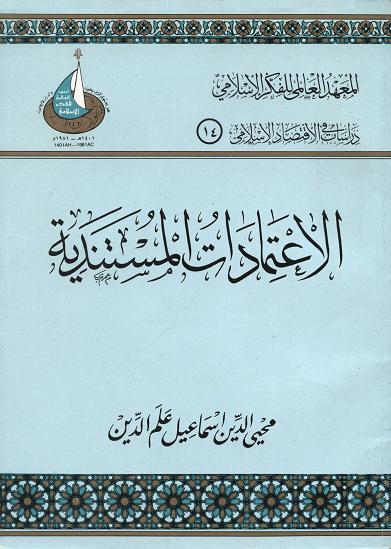

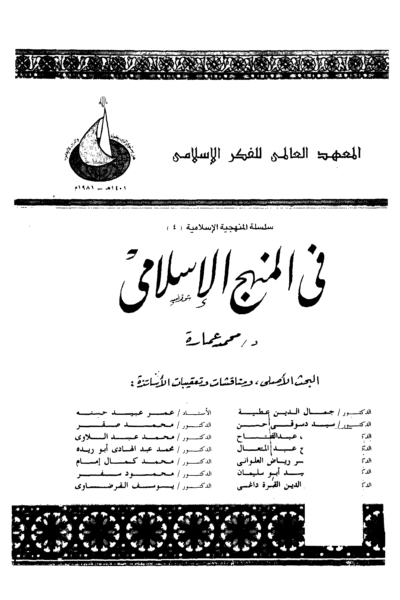
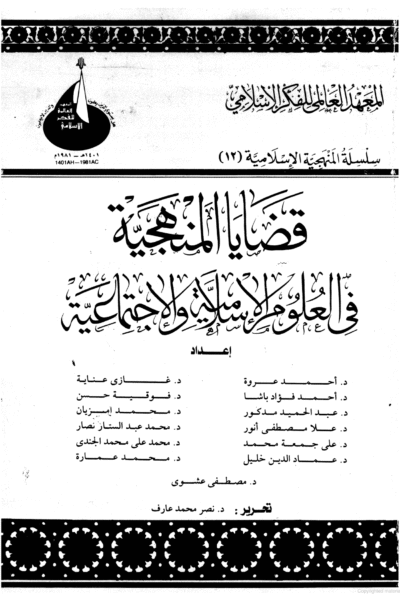

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.